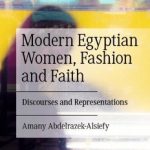لا ماء يرويها

عطش الأرض، عطش الأرواح
موسى الزعيم
في رواية “لا ماء يرويها” للكاتبة نجاة عبد الصمد الفائزة بجائزة كتارا للرواية العربية لعام 2018 والتي صدرت في لبنان عام 2017 ، يتمزج عطش الأرض وجفافها في بيئة مكانية تمتد على بساط البازلت في الجنوب السوري في محافظة السويداء “هذه الأرض التي يحبها سكانها ” وترضعهم من قسوتها خليطاً من فولاذ وقطن مندوف” الأرض وعطشها وتوقها للماء، يمتزج و يتماهى مع عطش الأنثى، الأنثى كجنس لا كفرد، كما تصرّ الكاتبة في الرواية على توصيفه، ورصد ملامح معاناته في مجتمع للوهلة الأولى ترى له حدوداً، وأبعادَ، لكنك بعد عدّة صفحات تلحظ هذا الفضاء المتخيّل الواسع لعالم شخصيّات الرواية وإن كانت الروائية أنبتتها في بيئة لها خصوصيتها وخصوبتها الاجتماعية، لكن القوانين والظروف التي وضعت فيها هذه الشخصيات قابلة للتعميم، وإن اختلفت الوسائل والظروف،تبقى لحظة الفَرادة في اصطياد ورصد هذه الشخصيات بأوجاعها يُكسبها سحر الواقعية الروائية وميتافيزيقية العمل الإبداعيّ.
“خرابيش حياة في دفترها محبوسةُ عند خليل، رّبما مزّق خليل الدفتر، ورّبما ضاع .. وأنا الراوية، أتاني أحد مراسيل حياة السبعين بقصاصة ورقٍ طارت من شباك غرفة الكرش.. فيها..”
ليس بيتُ البناتِ خرابٌ، بيتٌ لا بناتَ فيه، لن تروى حكاياتهُ…
البنتُ تروي حكاية البيت،هذه المقولة في الصفحات الأخيرة من الرواية، تفسّر سبب ضجيج روح حياة وبوحها “حياة” التي كانت حبيسة غرفة الكرش، وغرفة الكرش هي باختصار غرفة تحت البيت توضع فيها الأشياء المستعملة أو الأشياء منتهية الصلاحيّة، لكن الكاتبة استطاعت ضخّ الحياة فيها من خلال وجود حياة منفيّة أو سجينةً ، فانشغلت بالبوح على مدى الصفحات ال 260 التي تشغلها الرواية، والتي بدأتها الكاتبة من نهايتها بتقنية الخطف خلفاً، مع كسر هذا النمط السائد فنيّاً، فالشخصيات تبوح وتتحدث بتتابع وتداعٍ لاينظمه خيطٌ زمانيّ أو مكانيّ محدّد، لكن خيط الحدث يبقى بين أصابع المتلقي، يستطيع يقبض عليه بسهولة يشغله جمال البوح و تنوعه المحبب والذي شغل ما يقارب 36 فصلاً أو مقطعاً.
“حياة” التي كانت رهينة بِشارة أمّها “ذهبيّة أبو شال والتي لم تَصدق نبوءتها ” كنّا أطفالاً نلعب الغمّيضة في عمرة الجيران، دفعني أخي ممدوح إلى عمودها، فجّ العمود رأسي وركضتْ أمّي على صراخي ” هصصص بدل ما تبكي هاتي البشارة، كلّ أرضٍ يسيل عليها دمك، يكتب لك فيها موطئ قدم ” أربعون عامًا ولم تصدق بشارتها، ولم تكذب كذلك، خطأٌ صغيرٌ في القياس أزاح مصيري بضعة أمتار من صدر بيت الجيران إلى غرفة الكرش”.
تربط الرواية مصائر الشخصيّات الأنثويّة بعضها ببعض، بخطٍّ ناظمٍ على في بيئةٍ زمانيّة ومكانيّةٍ واحدةٍ مجموعة من الشابّات الصّغيرات في الثانويّة العامّة،من منبتٍ واحدٍ، اختلفت دروبُ حياتهنّ لتعود وتتقاطعَ في النهايات أحياناً.
فـ”حياة” التي أنهت الثانوية العامة، ارتبطت بخليل الذي دفع “لمرهج أبو شال” والدها مهراً هو تكلفة بناء الطّابق الثاني لأخيها ممدوح، المهندس المُفترض، خليل الذي يتجشّأ أكثر مما يُحبّ، الشاذ جنسياً الرجلُ البخيل الذي اجتمعت فيه صفات الاستغلال والجشع والوصوليّة معاً، عانت منه ما عانت، لكن قبلها بقي معلقاً بنبوءةٍ لم تتحقق في بيت جارتهم أم كمال، وتحديداً عند ناصر، ناصر الذي أحبّ حياة التي رأت فيه مكمّلاً لأحلامها وكيانها الإنساني، بما أحاطها به من حبّ وعطفٍ وخوفٍ على مستقبلها ” حياتي انتبهي لمدرستك” ناصر الذي راهن على بقائه مع أسرته بارتباطه بحياة الجارة الحبيبة، رغم قصر الفترة الزمنية التي التقيا فيها، لكنها كانت كافية لترسم طريقاً مليئاً بالوعود الرخيّة، لكنّ الأم رفضت ” لأن العِرق دسّاس ” عندها آثر ناصر أن يعود للالتحاق بمنظمة فتح الفلسطينية إلى أن يحطّ به الرّحال بعد انكسارات في رومانيا.. ناصر الذي بقي فكرةً في وجدان حياة، لم تنسه يوماً واحداً، تبوح باسمه في شتيمةٍ يوم ولادتها وتحفظ “زين المَحضر” المرأة الحكيمة تلك الشتيمة الشّيفرة لتعمل على جمعِ الشّمل في الوقت الضّائع من شوط الحياة، فيكشفُ أمرها ويوصلها حظّها العاثر إلى السّجن الأسريّ في غرفة الكرش .
تتشابه مصائر الشخصيات الأنثوية في الرواية مع اختلاف الطريق، فأمّ حياة تَزوجها مرهج أبو شال لعلمهِ بوجود ليراتِ من الذّهب معها، فاختلقَ قصّة علاقتها الغراميّة المفترضة مع حسن الغريب.
و”أرجوان” التي تزوّجت إلى البرازيل من صقرٍ الأعرج الذي يضربها ويرغمها على ملاطفةِ خلاّنه من أجلِ كسبِ صفقاتهم الرجلُ المعلولُ والذي لا يمتلكُ الحدّ الأدنى من الغيرة على أنثاه.
أمّا “سَحر” والتي تعاني من عَرجٍ وتخضع لجلسات العلاج في الشّام، كانت قد تخرّجت من قسم الدراسات الاجتماعيّة، ولم تسلم من سطوة المجتمع، سبق وأن حاولتِ الانتحار، وأسعفت ونجت لكنها تعود في اليوم الثاني إلى المشفى قتيلةً، لأنّ أمر زواجها من رجلٍ من خارج الطائفة قد كُشف.
في مجتمعِ العطشِ” خيرُ الأرض مرتهن بجود سمائها،فإن حبست عنهم غيمها عطشوا، وللسماء مزاجها السادي” يغدو الناس في حالة ترقب للمجهول، البيئة القابعة على جمرِ الجفاف لا نهرَ فيها ولا بحيرة سوى سيل وادي “راجل ” الذي ينشغلُ السكان بتنظيف مجراه طمعاً بقليل من الماء، كيف لا وتروي المرويات أنّ الفارس قايضَ فرسهُ أو بندقيتهُ بشربةِ ماء، ظلّ العطش يطالُ الأرواح، في كثير من الأحيان يدفعها للكشف عن مكنون جوعها الوجودي، فيغدو البحث عن الأفضل شاغل الناس، “فنصّار الغريب” الذي ارتحل فجأةً خلف الرّجل المغربيّ دون علم أحد، يقوده إلى خرائب سيناء، لينكشف طالع ملكةِ الجنّ عنه وبالتالي تمنحه ثروةً وبراءة من لعنةٍ تلاحق ابناء أسرته، لكنّه يموت غريباً في الأردن بعد إخفاقه وفقدان وثائقهِ، ولعل مصيره في خيبته يشبه حال خليل الذي أغري بالذهب في نيجيريا هناك ” تعطي العامل قطعة بسكويت غراوي يبادلك إّياها بقطعة الذّهب “ لكنه لم يعد من هناك سوى بجشعٍ لا شفاء منه ” أمّا ممدوح الذي عقدت عليه الأسرة وخاصّة الأب آمالها في أن يصير مهندساً، يتخفي فجأة لتَعلمَ الأسرة فيما بعد أنّه صار في فرنسا، يطارد نزواته، الذكر في الرواية لا تعلّق عليه الآمال، لا يشكّل مصدرَ أمانٍ للمرأة حتّى لو كان من صلبِها، كحال سلطان ابن حياة الذي وقف موقف الخصم منها، حتّى شخصيّة سلامة التي تُغرق في صوفيتها، لكنّها في لحظة ما صادرت كلّ الخيارات باختصارٍ وبكلمة واحدةٍ نطقها لزين المحضر زوجته ” اقفي من قبالي يا امرأة ” طلّقها لأنّها قبلت هديّة، ومثله من لا يُراجع في قراره، سلامة يمثّل صوت العقل والفكرة الدينيّة ذات البُعد الواحد رغم اتسامهِ بالطيبة والليونة.
في لا ماء يرويها يتبدل دور الأشخاص، وأمكنتهم وأسماؤهم، لكنهم يبقون في حالة تجسيدٍ واحدةٍ، فحياة و أرجوان وسحر وذهبية و مرهج وخليل وجاد الله بيك أدوارهم متداخلة متشابكة تماماً مع دور الضحيّة، يكمّل كلّ منهما الآخر، في لحظة استلاب لسلطة المجتمع .
” ليس ديكنا وحده، كلّ الديوكِ لا تحمي الدّجاجات الضحايا من أنياب الحُصيني إذا هجم “
الرواية تشتغل على قاعدة الهرم الاجتماعي بمكونها الأساسيّ( الزوج، الأب، والأم) أو لنقل على طرفين أساسيين فيها الذكر والأنثى، تركّز على أنّ محنة الأسرة في بناتها، حسب سياقات عرف المجتمع ومنظومة تقاليده والتي في كثير من الأحيان تتجاوز ما هو دينيّ صرف، وفي كثير من الأحيان يغدو التأويل أضيقُ من النصّ، الأسرة والقهر الاجتماعي والصراع الداخلي للشخصيات فيما بينها و داخلها، وصراعها ضدّ التهميش،هذا التهميش الذي غدا الهالة أو الشرنقةَ التي تغلّف الأنثى.. كثيراً ما كان يخترقها الرجل في حال حاجته إليها في القضايا السريّة أو ما يُدبّره بليلٍ، تقول أم سعيد ” لا يابو سعيد خيّ المتهومة ولا خيّ المقتولة، الآن يتّهمون سعيدة، فإذا قتلتها تثبتُ عليها تهمةَ العيب.. اترك الأمر عليّ”
كذلك يفعل خليل حين يريد أن يستدين المال من جاره ” فهو لا يريد أن يكسر المليون التي في الخزنة ” يرسلُ زوجته لتستدين المال من جاره الذي يعيش وحيداً.. ” طرقتُ باب مضافةِ جارنا سريعاً فتح الباب كأنّه كان ينتظرني، أسرّ لي بأنّ قلبه يرحب بي وبما أطلبه”
وحتى ولو كانت لأسرةِ المرأة حظوتها الاجتماعية، وحتّى وإن ألحقَ لقب ” بيك” بأبيها أو زوجها ” تبقى حبيسة رهانات ذكوريّة وهذا ما تذكره مرويات المكان، “قبل ثمانين سنة” فالرّجل حتّى لا يفقد مكانته الاجتماعيّة يمكن أنّ يفاوض على امرأته أو ابنته والصمت يبتلع الحكاية إلى حين “هاتوا سلوم المرابع لنعقد له على ابنتي روزة .. للعاهر الحجر وللولد الفراش “.. لن يُرجم حمدان بيك بحجر.. وسيبقى جاد الله بيك زعيما..
لم تكن الرواية مشغولة بالقضايا السياسية الكبرى سوى قضيّة فلسطين، التي كانت الشاغل الأساسيّ لأبناء جيل تلك الفترة، بالإضافة إلى المدّ الماركسي الذي أثار اهتمام فئةٍ الشباب في تلك المنطقة، إذ نلحظ أنّ جفاف الحالة السياسية وركودها “في أربعين سنة ” وبُعد اهتمام الدولة عن تلك المنطقة، دفع قسماً من أبنائها إلى البحث في مضارب الأرض عن لقمةِ العيش، الرواية مشغولةٌ بالإنسان، الانسان الفرد بالمرأة التي طالها العسف في ظلّ سطوة العرف والتقليد.
في لغة السرد: الرواية تبهرك هذه المزاوجة بين المحكيّة البسيطة والفصحى، لا تشعر معها بالغرابة، بل تشعر وأنت تقرأ بالانتماء لمكّون السرد والفكرة، للأرضية الفنيّة والفضاء المكانيّ الذي تتحرك فيه شخصيات الرواية، تُشعرك اللغة بالصدق والدفء الحقيقي لحديث الشخصيات، وقربك منها، مما يجعلك لا تشكّ لحظة ًواحدةً في أنها شخصيّات مبنيّة على الورق” طيب ما بدك تضّيفني شاي ” تكرم عينك على راسي “ أو ” مش معروفة قرعة بيو من وين ..”
في الرواية تجد كلمات لها خصوصيتها في بناء المعمار الفنيّ اللغوي، ألفاظ محفورة في عمق الشخصيّات،على سبيل المثال أصرّت الروائيّة على استخدام لفظ ” “يفترسني” أكثر من مرّة للدلالة على أحاديّة العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة “غصبتني عليه، أنت وأبي وممدوح، وتركتم خليل يفترسني في مرج العكوب، لن يُكمل افتراسي في بيته” ومثلها لفظ “يستعملها” في السياق نفسه ويكون ردّ خليل مخاطباً زوجته حياة في جملة لها إيحاؤها الخاص أيضاً في فقه الاستعمال ” لهذا نحن نقتنيكِ “ويردد الابن سلطان الجملة ذاتها “لماذا نحن نقتنيكِ “
لكن لنخرج قليلاً حلقة التنميط الذي تشعر به للحظة ما إنّ كل امرأة في الرواية مشروع قهر، تصف الرواية النساء في بيئة السويداء “نساؤها عاليات، لهنّ مقام كاملات العقل والدين” أخوات رجال”
تتكئ الروائية على ما تمتلكه من مخزون تراثي و حكائي، ديني غنائي، مأثور سردي وحكم وغيرها وهو كثيرٌ وغنّي بالفعل، هذا التراث السرديّ عرفت به المنطقة وذلك خلال شخصيّات ارتبط اسمها بالحزن، والفأل الحسَن وسوء الطّالع والنّحس وانقطاع الرّزق،وقصر الآجال وكرامة الأولياء ” بعيني اللتين سيأكلهما الدود رأيت الحيّة تنام على صدر سلامة، تلحس خدّه تلحس شاربه يده مطويّة تحت رأسه كوسادة” أسماء أمكنة وأولياء ” أبو الحرّ ” والكنيسة والراهب وطفا وسالم الأخوث والحسين ويوحنا المعمدان..”
كما استلهمت التراث الغنائي، بما يحمله من نفحة الحزن وتوظيف ذلك دائما في موقفه المناسب ” قولوا لأبوي الله يخيلو ولادو استعجل عليّ وأطلعني من بلادو ..” كلّ ذلك يعطي وثيقة انتماء الشخصيات لفضاء الواقع الحقيقي وينزلها من برج المُتخيل إلى أرض الحقيقة نتحسس وجودها فيما بيننا أيّاً كانت صفة المجتمع وصبغته وجغرافيته.
وأحسب أنّ اللغة في لا ماء يرويها، من أهمّ أبطال الرواية، وأكثرهم قرباً من المتلقي.*نجاة عبد الصمد طبيبة وروائية سورية تقيم في برلين.
.