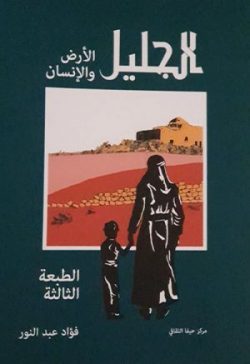في رواية شارع “بودين”

إياس بياسي
(لو ثمة غرامة على كل كلمة يتفوّه بها الناس لما وُجد بينهم أغنياء. ولو أن الكذب يعيب اللسان لصار أغلب الناس خُرساً).
ربما التساؤل الذي سيرافقك كظلّك، في يوم مشمسٍ، قبل أن تغادر الغلاف، هو لماذا صنّف الكاتب هذه الرّواية بالنقدية، علماً أنك لن تجد ضمن أنواعها في الأدب، ما يسمى “رواية نقدية”، حتى يخيل إليك أنك ستقرأ نقداً روائياً ربما، إلا أنك لن تعجز – بعد الإفلات من الغلاف- عن التقاط شخوصها، والسباحة في موضوعها، ممسكاً في الحبكة بيد النجاة، وغارقاً بـ “الزمكان” الذي يبحرك فيه، بيدك الأخرى.
“شارع بودين”، ذاك الشارع البرليني، المليء بالمهاجرين ومنهم العرب والمسلمون، اختاره الكاتب عبد الحكيم شباط، ليكون اسماً لأول عملٍ روائيّ ساخرٍ له، ربما ليكون بعد ذلك كناية عن شوارع وأزقة كثيرة، تسكنها تلك الفئة من النّاس؛ التي لو اجتمعت وحدها على كوكب آخر، لنسخت جاهليتها، وطوّعتها بما يناسب الجغرافية الجديدة، وتأكيداً لهذا الفهم، يكتب في “القصر المهجور”: (لازلنا نلهث خلف المظاهر الخداعة، فهمنا الزائف يجعلنا نعتقد أنه يمكننا تلميع صورنا الخارجية، أن نطمس الخراب الذي يسكن أعماقنا). فعند كل تقاطع طرق يقودنا نحو المستقبل، ترى التقليد يزرع آلاف الحراس الذين يحرسون واقعنا وماضينا.
كلّنا نعرف أين هي الكارثة، لكنّ لا أحدَ يجرؤ على البوحِ، أو بأقل تقدير، ثمّة من لا يمتلك زمام المفردات؛ ليقول الحقيقة على الملأ، فأبطال هذا الزمن، هم مجموعة من مخنّثي دور السينما وصالات الأزياء ومرتزقة الإعلام والسياسة والدّين، إنه زمن التزييف الرهيب، كما يقول جورج أورويل، (لذلك فإننا – كما ترى- نحاول أن نفرك جدران بيت الخلاء بقوة، صحيح لن نتمكن من محو بعض الأسماء المخادعة المدونة عليها، ولكن على الأقل نحن نجعل الحبر الذي كُتبت به باهت اللون، فقط تلك الأسماء التي كُتبت بحبر أصلي غير مغشوش هي التي ستقاوم فركنا المستمرّ وستبقى محتفظة برونقها البديع في سجل الخلود. أهمية ما نقوم به تتمثل في أننا نقف على مسافة واحدة من “مع” و “ضد”، وحيادنا هذا انحياز كامل للإنسان بمعناه الواسع، إنه تمرد على جماعات قوالب الضغط المفروضة، ولابدّ لنا أن نعي بأننا سندفع الثمن غالياً، فعلينا أن نتوقع التهميش والإهمال وعدم الاعتراف بأصالة ما نقوم به من جهد في بيت الأدب).
والطّامة الكبرى، أن تكون جاهلاً تماماً بما يجري، أو أنك اعتدتّ هذا، حتى الإيمان بالعبوديّة. (المرأة العربية أميرة النساء، تصرّ على الجلوس في المقعد الخلفي للعربة، لا لأنها في الرتبة الثانية، بل ليأخذ الرجل دور الحوذيّ).
أكثر ما يثيرك في تلك الرواية، هو اختراق “التابو Taboo”، والقفز فوق “الأعراف والتقاليد”، فتمنحك سيفاً دونكيخوتيّاً، وتسند إليك مهمّة فروسية في ممارسة القضاء والحُكم؛ في أن تنتقم ممن –لازالوا- يشوّهون ماضيكَ وحاضرك ثم مستقبلك، هذا السيف هو “السخرية” والسخرية في حالنا هذا، هي أعلى مراحل التعبير عن الألم الداخلي، فيقول عن لسان سركيس عامل النظافة: (ليست الأنانية من طبع الله، لقد سمح لغيره أن يشاركه المعرفة، وإلا كيف يستقيم زعم من تحدثوا باسمه عبر التاريخ؟ لابدّ أنهم شاركوه بعض ما يعرف).
رجال الدّين، هم من يحتكمون على قلوب البشر، ولا وعيِهِم بالترهيب، وهم من يوهمون الناس أنهم هاهنا بأمره ولأمره، وأنهم من شاركهم الله بعلمه، وأن من يخرج عن سلطانهم؛ هو هالك بجهنم لا محالة، وأن التمرّد على العُرف، هو تمرّد على الله، كما في قصة “مأساة إيمان”، رغم أنّ – معظمهم- جاهلاً حتى في ألف ـ باء دينِهِ، كما هي حال الشيخ “عبودة” أيضاً، الذي جاء إلى أوروبا بقصد الدراسة، واكتشف مواهبه الخطابية وجمال صوته في تلاوة الآيات، بعد تغيّب الإمام عدة أيام، ولم يحتَج سوى بضعة أشهر حتى صار الناس يطلقون عليه لقب الشيخ، وقد دارت معه عجلة الحظ حيث تعرف إلى إحدى الألمانيات المتحولات حديثاً إلى الإسلام، وتزوجها، أما حصوله على المواطنة فصارت مسألة وقت، وترقى في سلّم المشيخة ليصير من الأئمة المقدَّمين، وعهد إليه أن يصبح داعية في أكبر المساجد، واتسع جمهوره، وكذلك نساؤه.
ولا ينسى الرّاوي، أن يصف لك شكل رجل الدين الإسلامي الكلاسيكي، السلفي المعروف، كفضيلة العلامة المجدد الدكتور عماد زنجبيل، في حلقة “العلّامة”: (فضيلتهُ حرّكَ عجيزته، حكّ كرشه، مسّد لحيته، ثمّ نطق: “ثمّة ضرورة لتجديد الفكر الديني” ثم تشكّى وتأوّه ووصف تحجر عقول بعض رجال الدين وخورَهم عن موافاة العصر)، وكأنه بريء تماماً مما ينسب لهم.
(استمع كارل، وراقب بصمت. طاب المجلس لفضيلته، خلع البدلة، أرخى ربطة عنقه، باعد بين فخذيه، بند بين أصابعه، رفع صوته، وقال مبتسماً: “بوصفي عالماً، أبين لكم أن الكثير من رجال الدين في هذا الزمان جهلة ..”
كما لم يفُتهُ أن ينحت بعض المصطلحات المتّصلة بالفكرة كـ “النظرية الملقاطية” التي ينتسب إليها العلامة المجدد الدكتور عماد زنجبيل وهي نسبة إلى الشيخ “ملقاط”.
وفي الحديث عن الشيخ ملقاط ونظريته الملقاطية، التي تلقفها كارل، وباتت تلحّ عليه كل يوم، تذكر مقابلته مع الإمام “ملقاط” هذا، حين سأله عن سبب احتجاب “ماريا” بكل هذه الثياب، فأجابه:
(إنها إرادة الله، وإن لكل أمر إلهي حكمة، ومن ذلك أن المرأة إذا سترت جميع جسدها تكون قد عصمت نفسها ونفس الرجل من الوقوع في الفتنة. وحين طلب من عمّه مزيداً من التوضيح لهذه النظرية أجابه:
(المرأة السافرة كقطعة اللحم المرمية على منضدة تحوم حولها أسراب من الذباب والبعوض، أما المرأة الساترة لجميع جسدها فهي كقطعة اللحم المحفوظة في الثلاجة، فالنفس تقبل على الثانية وتعاف الأولى.
وفي حالة – ملقاطية- أخرى، يسلّط الكاتب أيضاً الضوء، على المشكلة النفسية الكبرى التي يعاني منها أغلب الشباب العربي، والتي – بطبيعة الحال- لا يُستَثنى منها كثير من رجال الدين، بل زد على ذلك، بأنهم يعتقدون أن الله أحلّ لهم، ما حرّم على غيرهم، بصفتهم أولياء العلم والدين، فيتلو علينا حادثة شائقة بين كارل المتسائل العفوي، وملقاط:
(سأل صهره بكل براءة إن كان ثمة حالات استثنائية يمكن فيها للرجل أو للمرأة أن يصافحا بعضهما البعض أو أن يقبل فيها الرجل المرأة الغريبة عنه، كما يفعل فضيلته عندما يلتقي بالنساء الألمانيات في وفد البلدية؟
لم تظهر حينها معالم الغضب على ملقاط، بل جرّ كارل إلى ركن منعزل من المسجد، واستفسر منه عن مصدر معلوماته، ثم قال له بهدوءٍ شديد: إن الضرورة يكون لها أحكام، فلو لم يقبّل أعضاء الوفد في كل مرة يلتقيهم؛ لقالوا عنه أنه شيخٌ متعصب وإرهابي، وهو يمثل هذا الدين، فهل يرضيك يا كارل العزيز أن يساء فهم ديننا العظيم، لمجرد قبلة بريئة بالكاد تترك أثراً على الخدود؟
طبعاً كان جواب كارل برفضه الإساءة إلى الدين ووصمه بالإرهاب من أجل قبلة ملقاطية بريئة، ولكنه عاد ليسأل بسذاجة الأطفال:
هل يمكنني يا صهري العزيز أن أطبع كذلك قبلة بريئة لا تترك أثراً على خدود الأخوات في الجمعية؟
الشيخ حال سماعه سؤال كارل، كاد يصيح بأعلى صوته، لكنه خشي أن يُفتضح أمره، فاضطر أن يبتلع غضبه، ويوضّح للسائل أن هذا جرم كبير، فالمؤمن يمكن له أن يقبل المُشركة – في بعض الأحيان- وهذا ليس له قيمة كبيرة أو هو ذنب بسيط للغاية لأن المُشركات شرفهنّ مجروح، يُمنح للقاصي والداني، أما المؤمنات فقيمتهن الحقيقية تكمن في هذا الشرف).
لا يمكنك أن تحسّ، مع تتالي الصفحات، أنك أمام حالة من “جلد الذات”، لا، بل لتشعرنَّ أنّ الكاتب، كاد يكون مقصراً في لذعه ووخزه، خاصّة أنه لا يقف في تشخيصه عند رجال الدين العرب، كأحد أهم عناصر المأساة العربية الإسلامية في المُغتَرب، ويشعرك بذنب التمادي وذنب انتقاد الدّين، بل يشدّ ياقةُ مخيّلتك، وعقلك أيضاً للحديث قليلاً، عن العربِ عامة، وسلوكهم اليومي: (عربات الألمان متواضعة عملية تراعي توفير الوقود وتحافظ على الطبيعة. عرباتنا نحن العرب؛ من نعيش على أطراف العالم وعلى تخوم المجتمع المتمدّن تكون مترفة فارهة هادرة لا تنسجم مع حالنا بوصفنا متسولين على ضرائب حكومة البلد، ولكون لا عمل لنا غير التدابر والتنافر واختلاق المتاعب هنا وهناك، عدا عن كوننا كائنات منجبة تتوالد بمتوالية هندسية).
وفي الحديث عن التاريخ والمؤرخين، في “حجرة الشيخ”، يجهد البطل الفضولي، أثناء تأديته وظيفته التنظيفية –التي غالباً ما يتهرّب منها بمرافقة سركيس- وبعد اكتشافه للكثير من الأوراق الصفراء، والكتب القديمة المهملة غير المرتبة، والمرمية هنا وهناك، للوصول إلى تعريف للتاريخ ومهمّة المؤرخ، من خلال حوار مع العجوز الذي بدا أكثر فضولاً في الإفصاح عن حكاياته:
ـ نعم، كتب التاريخ شديدة الأهمية، فهي تخبرنا بحقيقة ما حدث في العهود السالفة.
ـ بالنظر إلى حالتي الخاصة، فإن اقتنائي لكتب التاريخ يندرج في مقولة “يجب أن تعرف ماذا يكتبه عنك أعداؤك” ورغم أني لا أحمل عداءً للمؤرخ، إلا أنه يعلن العلاقة معي في إطار الحكم الأخلاقي للعلاقة الإيجابية، فأنا من حيث طبيعتي لا أحمل تجاه الآخر قيمة أخلاقية ما، فأنا لست حبّاً، ولستُ كرهاً، كما أني لست “مع” ولست “ضداً” أي أنني أندرج في علاقتي مع المؤرخ في إطار القيمة الأخلاقية السالبة، وأحسن الغلام “ماكس فيبر” عندما قال: بأن عمي العجوز يقف في علاقته مع ما يحيطه على مسافة واحدة، فهو يضع نفسه في خانة “المحايدة التقييميّة”. ولكن ما يحدث أن المؤرخ لا يستطيع أن يقاوم إغراء إصدار الأحكام في ما يكتبه حولي، وإذا عدت إلى هذه الكتابات فإني أجدها في مجملها تجعل من حياتي الطويلة تسير في مساربٍ مؤطّرة بإيديولوجيات متشاكسة ومتضاربة على نحو يدعو إلى الضحك والدهشة، وهي بذلك بشكل أو بآخر تعلن العداء على طبيعتي الحيادية، وترفض أن تعترف بهذه الخصوصية التي هي هويتي الحقيقية، والتي من غيرها أفقد كينونتي الخاصة، وإذا الأمر كما قلت لك فإن كتب التاريخ تصبح بالنسبة لي هي الوثائق على افتراءات المؤرخ حول طبيعتي الأصلية، ولذلك كان لابدّ لي من معرفة ما يكتبه حولي هؤلاء القوم الذين يناصبوني العداء رغم أني لا أرى فيهم إلا كما يرى المسافر في مسافرٍ آخرَ يسير إلى جنبه.
ـ هل تعتقد حضرتك بالفعل أنه لا توجد قوانين تنضبط بها المظاهر أو الفاعلية في سير حياتك سواء أكانت “أحادية” أو “ثنائية” الطبيعة، وإذا لم يكن ثمة قوانين تنظم حياتنا، إذاً فما عساها أن تكون؟
ـ هي في حقيقتها لا تزيد عن كونها محاولات بائسة لصياد يلقي الشباك في بحر شديد الملوحة أو أعمى يتلمس إبرة في كومة قش، إنها تلك الآمال النفسية والعقلية التي يطمح بها المؤرخ إلى إيجاد قانون في وسط الفوضى، العقل البشري الذي رُكب بطريقة الأوامر العسكرية لم يعد يتقبل أو يتصور العيش وسط مظاهر تحكمها الصدفة.
تتألف هذه الرواية من اثنين وعشرين جزءاً، تقعُ في ثلاثمئة وخمس وثلاثين صفحة، هي:
تحذير من الكتب – الوقوف على باب الجنة – جوف المارد – سركيس مرشداً – في البدء كان الوهم – الذهاب إلى الكنيسة – مدن في الحلم – الجاسوسة – فلسفة دودي – زوايا النفس – حكاية إرتاج – الجمعية الدينية – أيام الأسبوع – حجرة الشيخ – بيت الأدب – جدل في غرفة الطعام – مأساة إيمان – عينان عذبتان – بائعة الهوى – العلّامة – القصر المهجور – صاحب الربوة.
دعونا لا نتكلّم كثيراً فإننا –على حدّ تعبير ماترلينك- “دائماً ما نصغر من شأن أي شيء بمجرّد أن نبدأ في التعبير عنه بالكلمات”.
أما ما وراء الصفحات، فإننا سنستعين بوصفة بورخيس السحرية: (إننا بحاجة إلى الخيال كي نواجه تلك الفظاعات التي تفرضها علينا الأشياء) أو نتأسّى بنصيحة السنديان العجوز للبراعم الجديدة النابتة: (إننا -بني الشّجر- أكرم المخلوقات؛ لذلك اختارتنا يد العناية لنعمر عالم الغابة بالحياة، الصالحون منّا سيحظون بحياة كريمة في العالم الآخر، أما الأشرار فوحدهم يكونون حطباً للنار الأبدية).
رواية “شارع بودين Boddinstraße” للكاتب عبد الحكيم شباط
صدرت عن دار الدليل للطباعة والنشر 2017