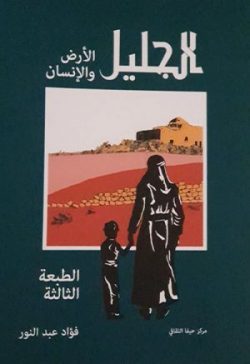حول تعليم اللغة العربية في برلين

مناهجُ شتّى معظمها يخاطب الطفل في الوطن العربي
الطفل “العربي / الغربي” يحتاج مناهج واقعية من وحي البيئة الفكرية والسياسية، التي يعيشها.
no images were found
موسى الزعيم
مما لا شكّ فيه أنّ قدومَ أعدادٍ كبيرةٍ من الوافدينَ العربَ إلى أوربا، عامةً وألمانيا خاصةً جعلَ النّاس تتلمسُ الحاجاتِ الأساسيّة لهذهِ الأعداد، ولعلّ من الهواجسِ الكثيرةِ التّي تطفو على ساحةِ المهتمّين بالعروبةِ والعربيّة، تعليمَ أبناءِ الجالية لغتهم الأم، لما يحملهُ ذلكَ من معانٍ تندرجُ في إطارِ ما هو قوميّ أو دينيّ، أو تحتَ مسمّياتٍ كثيرةٍ، منها الحفاظُ على أصالةِ هذا الجيل القادمِ إلى أوربا، خاصةً إذا عرفنا أنّ الكثيرَ من القادمين أُسرٌ ولديهم أطفال، وتبدو المهمّة أصعب، كلّما تأخّر الوقتُ، وبدأ جيلٌ جديدٌ من الأطفالِ يُولدُ هنا.
في برلين استنفرتْ مدارسُ اللّغة العربيّة للتّصدي لهذه الظاهرة، بما تمثّلهُ من مساجد َوجمعياتٍ ومراكز ومؤسساتٍ قديمةٍ ومدارسَ أنشأتْ حديثاً للعملِ ضمنَ هذا الإطار..
هذهِ الجُهود بمجملها مشكورةً على وقوفها على العمليّة التعليميّة البالغة الأهميّة، لما ترتبط به مباشرة بحياةِ النّاس.
ومن هنا يبدو السؤال لماذا نتعلم اللغة العربيّة ؟.. إذا كنّا نعيش في بلد أجنبيّ أو إذا تعلّم أبناؤنا العربيّة الآنَ، ربّما جاءَ الجيلُ الثالثُ، ولم يأبه بها، والتجربة موجودةٌ على أرض الواقع.
نقولُ: بالمجمل نتعلّم العربيّة لأنّها جزءٌ من الهويّة القوميّة، ولأنّها لغةُ الديّن والقرآن ونتعلمها حتى نتحاور مع أهلنا، وأقاربنا وجهاً لوجه، أو عبرَ وسائلِ التّواصل، كي نقرأَ الكتبَ والصحفَ، كي نسمعَ الإذاعةَ والتّلفاز، تساعدنا في دعم التّعاون الاقتصاديّ والتجاريّ، بين بلداننا العربيّة وألمانيا، وربّما تخصّصنا بها، أو في التّرجمة، أو ربّما شاءتْ الظروف وعدنا إلى بلداننا، حتّى لا يبدو أطفالنا غرباءَ مرّة أخرى، نتعلمها من أجلِ زيادة الثّقافة والمعرفة كغيرها من اللّغات، نعلِّمها لأطفالنا حتّى نرفع عن كاهلنا شيئاً من المسؤوليّة أمام أبنائنا ووجداننا والتاريخ.
لكنْ في أغلبِ الأحيانِ ننطلقُ من عواطفنا تجاهَ اللّغة، من قناعاتنا الوطنيّة والقوميّة والدينيّة، وهذا له ما يبرره وله جُلّ التقدير والأهميّة.
هل فكّرنا يوماً أنّ نُعلّم العربيّة كلغةٍ لها كيانها، ولها وجودها كأيّ لغةٍ نحصل بها على شهادةٍ موثّقةٍ ومعترفٍ بها، أو بالأحرى هل يُعْترَفُ بالشهادات التي تمنحها هذه المدارس.
و بناءً عليه ثمّةَ أسئلةٌ كثيرةٌ، طفتْ على السّطح في الآونةِ الأخيرةِ، حول آلياتِ عملِ هذه المدارسِ والمؤسساتِ، حولَ طريقةِ التّدريس، والوسائلِ المتّبعة فيها، والمناهج التي يتمّ اعتمادها وتدريسها.
جملةُ القول: يمكن أن ترى منها ما هو أقصى اليمين ومنها ما هو أقصى اليسار، حتّى وكأنّك تدخلُ أحدَ كتاتيبَ أيام زمان، ومنها ما اعتمد أحدث الوسائلِ والتقنياتِ، لكن المُحزن أن ترى بعض هذه المدارس والمراكز مازالتْ تسير أو تسيّر بأجنداتٍ حزبيّة أو قطريّة وسياسيّة أحياناً، وكأننا نسينا أننا نسير ضمن هدفٍ واحدٍ، أو رابطٍ عروبيٍّ واحد وهو الحفاظ على اللغة الأم عنوان الهويّة العربيّة، مما لاشكّ فيه أنّ بعضَ المدارس غرّدت خارجَ السرب، وبدأت تعلّم اللغة لمجرّد أنّها لغةٌ لبقعة جغرافيّة تسمّى الوطن العربيّ عامةً، أو لطفلٍ عربيٍّ بعيداً عن جغرافيته.
ولكلّ ما سبق ما يبرره، هو يعطي حريّة الاختيار للأهل في أيّ مركزٍ أو مدرسةٍ يجدون أنفسهم أو يعتقدون أنّه المكان الأنسب لنشأة طفلهم. لكنْ أيا كان المكانُ يبقى المنهجَ هو الوعاءُ المعرفيّ الذي ينهل منه المتعلّم، وإنْ كان هذا المنهج يحمل في طياته الكثير من التساؤلات.
يقولُ الدكتور نزار محمود: مديرُ المركز الثقافيّ العربيّ في برلين، وهو صاحب تجربةٍ غنيّةٍ في تعليمِ اللغة العربيّة في مدرسة الأندلس “عندما أنشأنا المدرسة طرحنا على أنفسنا السؤال التالي: ما الهدفُ من المدرسة؟
” إنّ تحديدَ أهداف عملية التعلّم، يعطينا مفاتيحَ النّجاح، كانت الإجابة أشبه بمن يخطُّطُ لرحلةٍ، عليه أن يعرفَ إلى أينَ يذهب؟.. وما الوسائل؟ وما الفائدة في المحصلة؟.
وعليه فعندما نريدُ أن يتعلّم أبناؤنا العربيّة من أجل أن يتمكنوا من التحدّث مع أهاليهم في أمورٍ حياتيّة ومعيشيّة، فإن منهاج التّعلّم في مفرداتهِ، وأساليبهِ، ومدّته، ومستلزماتهِ، ينبغي أنَّ يحققَ هذا الهدف، ويلبّي هذهِ الحاجة، كما يتطلّب اختيارَ الأسلوبِ التّعليمي المناسبِ، وتحديدَ المهاراتِ اللّغوية المطلوبة ”
من هنا تبدأ إشكالية المناهج التعليميّة في المدارس العربيّة، فكلّ مدرسةٍ لها “ليلها الذي تغّني عليه،” وإنْ لم يُعجبها، فبعدَ سنواتٍ من التّجريب، تعمد إلى استبداله، والطريفُ إنَّها تجرِّب منهجاً دراسيّاً جرّبته مدرسةٌ أخرى قبلها، لندورَ في حلقةِ منهجين دراسييّن أو ثلاثة ليس أكثر.
بعض المدارس اعتمدت ورقةَ العملِ بما يناسبُ واقعَ الحال، اجتهدت هذه المدارس أو المراكز في طباعةِ أوراقِ عملٍ، اعتقَدت أنّها تسدّ فراغ منهجٍ علميً يراعي الفروق الفردية والمستوى العمري، والتحصيل السّابق للتلميذ، لنقلْ نجحتْ إلى حدٍّ ما مع تقديرنا لنبلِ الهدف. مدارس أخرى اعتمدت منهجَ إحدى الدول العربيّةٍ، ونجحتْ في تطويعِ هذا المنهج، إذ حذفتْ ما لا يتناسبُ مع حياة الأطفال العرب هنا، من قيمٍ وأفكارٍ سياسيّةٍ واجتماعيّةٍ.
لكن بالمحصلة استطاعت هذه المدارس، أنَّ تحصدَ رضا أولياءِ التّلاميذ، بما تمزجهُ من تعليمٍ للغةِ العربيّة مع التربيّة الإسلاميّة بأسلوب مُنقّحٍ منفتحٍ على العالم بعيداً عن التّعقيد والولاءِ لجهةِ، ما مما أكسبها رضا الكثير.
لكن يبدو السؤال هنا هل تتناسب مناهجُ دولةٍ عربيّةٍ مع أطفالٍ ينهجون نهجَ حياة جديدة هنا
يقولُ الدكتور سعيد أبو صافي: مدير مدرسة النور عن قضية المناهج تحديداً: في البداية جرّبنا مناهجَ مختلفةٍ، إلى أن توصّلنا إلى قناعةٍ أنَّ المنهج المدرسيّ الأردنيّ هو الأنسب للشريحةِ العربيّة التي تزورُ مدرستنا، وبالتالي حاولنا تطويعَ المنهج بما يخدم أهدافنا التعليميّة، قمنا بحذفِ ما لا يتناسبُ مع واقع الحياةِ هنا، وتركنا للمعلم الحريّة المهنيّة في إثراء المنهج وإغناء الدرس، وبالتالي نحنُ نقيسُ مخرجاتِ التّعلم آخرَ العامِ بما لدى الطّالب من ذخيرةٍ من الكلمات، والجمل العربيّة التي استطاع تكوينها خلال العام.
وللدكتور نزار محمود رأيٌ آخر في صلاحيّة منهج إحدى الدول العربيّة في دول المهجر يقول: لا يخفى على أحد أن لكلِّ بلد عربيّ سياسته التّعليميّة التي تخصّه، فلكل مجتمع ظروفه، قيمه، وعاداته، وتقاليده، ومصادره المعرفيّة التي تشكل كلاً مترابطاً.
أضف إلى ذلك الحالة الثّقافيّة والرّوحيّة لأبناء الجاليّة العربيّة المتأثرة بحياة المجتمع الألمانيّ، وإشكاليّة التّوافق بين الاندماج والحفاظ على الهويّة. كل ذلك له تأثيره على مُدخلات ومخرجات العمليّة التّعليميّة، ومن هنا فإن اعتماد أي منهجٍ تعليميّ لأي بلد عربيّ وللأسباب السّابقة لن يلبّيَ الحاجات التعليميّة ولا يشكل إشباعاً لها.
يرى الدكتور سعيد أنَّ ضرورة الإجماع في المدارسِ العربيّة على الأقل في برلين على ضرورة اعتمادِ منهجٍ مدرسي موحّد لتعليم اللّغة العربيّة في المدارس “وهو رأي أغلب من حاورتهم من المهتمين” يقول: حضرنا أكثر من اجتماع برعاية الجامعة العربيّة، هنا لكنّنا لم نصل إلى نتيجة، لم يكن هناك إرادة قويّة عند البعض، ولو أنَّ الجامعة العربيّة حريصة على دورها كممثل للعرب هنا، لدعمتْ مادياً ومعنوياً إنشاءَ منهجٍ عربيّ موحدٍ واعتمدتهُ المدارس، لكن اللقاءات كانتْ لمجرّد طرح الأفكار وبالتالي لم نصل إلى نتيجة.
في العموم هي جهودٌ نبيلةٌ وإنْ كانت لا تخلو من المصاعب والأخطاء، ومرجع تلك الصعوبات أحياناً للقوانين، والأنظمة ولضيقِ الوقتِ أحياناً إذ غالباً ما يتم تدريس العربيّة في عطلة نهاية الأسبوع بمعدل ستِّ ساعاتٍ أسبوعياً، والتي يعتبرها التلميذ وقتَ راحةٍ له من عناءِ المدرسةِ الحكوميّة.
من هنا لا بدّ من التّوقف عندَ بعضِ القضايا التي تتعلقُ بصلبِ العمليّة التعليميّة، لنقف قليلاً عند أحدِ المناهج وهو “منهج اللّغة العربيّة لغير الناطقين بها للحبيب العفّاس”
إشكاليات المنهج:
هذا المنهج تمّ اعتماده في عدد من مدارس ومراكز برلين، بعض هذه المدارس وجدت فيه ما لا يناسب حاجات أبناء الجاليّة المعرفيّة فأقلعتْ عنه، وبعضهم مازال يصرّ على استخدامه لقناعته به أو ربما لوجود عبارة “لغير الناطقين بها” ووقوفنا على هذا المنهج لا يعني تبرئة غيره. ومن خلال خبرتي التي تجاوزت العشرين عاماً في تدريس العربيّة والإشراف على تعليمها في المدارس، اطلعتُ على بعض مطبوعات هذا المنهج وأودّ التّوقف عند بعض القضايا التي أثارتْ تساؤلاتي وأسوقُ لكم الأمثلة التالية:
ورد في كتاب التّلميذ المستوى الثانيّ، في درس فصول السّنة، الحوار التّالي في ص 34
وَجدي: كيفَ الجّو في الخارجِ ؟ / حليمة: الجّو باردٌ جداً، هذا فصل الشتاء. / وجدي: هل تشعرين بالبردِ يا حليمةُ ؟ / حليمة لا فأنا ألبسُ ملابسَ صوفيّة. / وجدي: هل سقط الثّلجُ اليومَ ؟ / حليمة: نعم سقطَ الثلجُ بكثرةٍ. / وجدي: يا فرحتي سألعبُ بالثّلج.
حليمة: وأنا سأشكّل رجلاً من الثلج.
ثمّة إشكال معرفيّ في الجملة الأولى، وهو من المُسلّمات ” فالجّو هو الفترة الزمنيّة لمناخِ منطقة ما ” كان الأحرى أن يقول “وجدي” كيفَ الطّقسُ في الخارج؟ لأنّ سؤالهُ عن حالة عابرةٍ لنهارٍ مشمسٍ أو ماطرٍ مثلاً.
تساؤل آخر: كيفَ لطفلٍ يجلسُ في البيتِ أو في المدرسةِ، ويسقطُ الثلج لنهارٍ كاملٍ ولا يعلم..! هل هذا السّياق يتناسبُ مع سنّ الأطفال وفضولهم وحبهم للثلج..؟!!. حسناً لو أنّ حليمة أخبرتنا أنّ وجدي مريضٌ مثلاً لاستقامَ المعنى وصارَ أقرب إلى المنطق.
و”يا فرحتي” أسألُكم: من منكم يستخدمُ هذا التركيب في حياته اليوميّة؟!!! ما مدى قرب هذا التركيب من حياة الأطفال؟!
حقيقةً بعض الجُمل والتراكيب في المنهج تُشعر المتعلّم بصعوبة اللغة والتنفير منها أحياناً، أو أنّ مؤلف المنهج يصرّ على انتماء ألفاظه هذه الألفاظ تصرّ على انتمائها لنمطِ حياةٍ معيّن.
مرّة أخرى تأمّلوا النص التالي في ص 30 :
عفاف تأكل ثلاث مرّات في اليوم ” الفطور، الغداء، العشاء. / ثريّا تأكل مرّةً واحدة في اليوم.
” إلى أي مدى تستقيم جملة “ثريّا” مع حياة الطفل، أو مع المنطق، المنهج موجّه إلى طفلٍ يعيش في أوربا وليس في صحراء الرّبع الخالي أليسَ الواجب احترام عقل المتعلّم ؟!
من جهةٍ أخرى بحثتُ في المنهجِ عمّا أعرفُ أنّه محببّ للأطفال، وهو الأنشودة أو قصيدة الطّفل، فماذا وجدتُ؟ في كتاب أحبّ ديني المستوى الثاني.
وجدت نشيدين: الأول بعنوان “أركان الإسلام” في الصفحة 15 والثاني “أنا انسان” الصفحة 34
أرسلتهما للشاعر مصطفى عبد الفتاح ـ وهو شاعر يكتب للأطفال ـ أسأله عن فنية هذين النشيدين؟ فجاءني الردّ التّالي:
انشودة (أركان الإسلام): في البيت الأول هناك خطأ، حيث يجب أن تكون الجملة: آمنت بالله ربّاً و بـ “طه” الحبيب نبياً، وهنا يختلّ الوزن، لكن حذفُ حرفِ العطفِ يجعلُ الطفل بعيداً عن فهم الربط بين الشطرين، وكذلك البيت الثالث فيه كسر في الوزن(خُلُقاً)
أنشودة (أنا إنسان): فيها كسور في الوزن الشعريّ في الأبيات: 2 ـ 5 ـ 7
الأنشودتان خاليتان تماماً من أيّ أثرٍ فنيّ، هما نظمٌ صُبتْ فيه الأفكار المجرّدة بطريقة ٍفجّةٍ.
وعند سؤاله عن أهميّة أنشودة الطفل في المنهج قالَ: الأنشودة: هي حاملُ اللغة الأكثرَ خلوداً على شفاه الأطفال، وفي ذاكراتهم، وقصيدةُ الطفل يجب أن تتّصف بسلامةِ الوزنِ ورشاقتهِ، من حيث اختيار البحور الشعريّة القصيرة، كما يجب أن تتصف بوحدةِ البيت، وعدم جعل الأبيات نسيجاً متداخلاً في المعاني، حتّى لا يضيع الطفل، وهناك مسألةُ البناءِ الفنّيّ، والابتعاد عن النّظم والابتعادِ عن صبّ الأفكار في قوالبَ جامدةٍ، لا تحرّك فكراً ولا شعوراً”
وعن آلية تقديم الفكرة عبر أنشودة الطفل: ثمة آلياتٌ متعددةٌ منها الأنسنة، ومنها تحويلُ الفكرة إلى قصّة شعريّة مبسّطة بلغةٍ خفيفة وعبارات سهلةِ اللفظ والمعنى.
والسؤال هنا ألم يجد الحبيب العفاس في كلّ مطبوعات الأدباء العرب أنشودة أو قصيدة تليقُ بأطفالنا ؟!
من جهة ثانية على الصعيد الفنّي فإخراج بعض الصّفحات ليس بالطّريقة الفنّية التي تجذب الطّفل خاصّةً وأنّ عين الطفل راصدٌ حيٌّ، ونحن في زمنِ الصّورة.
في الكوادر التعليميّة:
من المؤكّد أنّ التلميذ هو محور العمليّة التعليميّة، وكلّ الوسائل والأدوات ومواد المنهج تصبّ في خدمته، والمعلم هو من يطوّع كلّ هذه الوسائل بما يمتلكهُ من خبراتٍ ومؤهلاتٍ وكفاءاتٍ لخدمة المتعلم، والسؤال هنا هل كلّ من يقرأ ويكتب العربيّة قادرٌ على تعليمها في المدارس؟ أم أنَّ المسألة أحياناً تندرجُ في إطار المحسوبيّة أو العلاقات الشّخصيّة أم أنّ هناك سياسةً تعليميّةً تحكمُ وتضبطُ ذلك ؟
في بعض المدارس نعم يُعطى “الخبّاز خُبزهُ” وفي بعضها الآخر مازالت القضايا تندرج في إطار ما سبق أو في إطار حسن النوايا.
والسؤال موجه لأصحاب المدارس لو أنّك ذهبتَ إلى طبيبٍ ووجدتَ مهندساً يجلسُ وراء مكتبه إلى أيّةِ درجةٍ تقنعُ بعلاج المهندس ؟
من المعلوم أنّه في السنواتِ الأخيرةِ وصل إلى برلين قرابة أربعين مدرّساً للغة العربيّة يحملون شهاداتٍ جامعيّة من جامعاتٍ عربيّة مختلفةٍ، ولديهم الخبرة الكافية التعليم، وأعتقد أنّ أكثر من ضعف هذا العدد من خريجي كليّات التربيّة والتعليم في بلداننا العربيّة أي هم مؤهلونَ.. هم معلمون بطبيعة الحال، قادرون على النهوضِ الأمثلِ بهذه العملية بما يحملونه من خبرةٍ ميدانيّة في مدارس بلدانهم.
يُذكر أن بعض المدارس تقوم بدوراتِ التّأهيل لمعلميها، تسعى إلى تطويرهم دائماً. وقد يسأل البعض هل يحتاج تعليم الحروف وأبجدية الكتابة إلى متخصصٍ؟ الجواب بالتأكيد نعم وإلاّ لماذا أُنشأتْ كلّيات التربية والتأهيل التربوي ؟
والمعلم المختص هو الأقدر على معرفة الطرق والوسائل لإيصال المعلومة للطفل هو الأعلم بالطريقة التي يرغب فيها الطفل أن يتعلّم انطلاقاً من القاعدة (عليّ أنْ أُعلّم الطّفل كما يريدُ هو أن يتعلّم لا كما أريد أنا ) لا أن أجلسَ وراء طاولةٍ وحولي حلقةٌ من الصغار أملي عليهم وهم يسمعون فقط.
يقول أحد أولياء التلاميذ: أضاعفُ المصروفَ اليوميّ لابنتي لترغيبها حتّى تذهب أيام السبت والأحد إلى المدرسة العربيّة، وهي تقول لي: بابا لماذا نتعلّمها إذا كنّا لا نستخدمها ؟
حقيقة هنا لابدّ من تضافرِ جهودِ الأسرة وتواصلها مع المدرسة، ومتابعة تحصيل أبنائها لا أن يُلقى العبءُ كلّه على كاهل المدرسة من باب رفع المسؤولية.
كلمةٌ أخيرة:
من المدارس التي وقفت على تجربتها والتي فتحت صدرها لحوارنا وأسئلتنا
مدرسة ابن خلدون: والتي لها تاريخها الطويل في تعليم العربيّة، تجد طلاباً ليسوا عرباً يتعلّمون اللغة العربية لأنّها لغة القرآن الكريم، يحرص القائمون عليها على تعليم اللغة العربية وتعاليم الإسلام بأسلوب مُبسّط للطلاب.
مدارس أخرى كمدرسة جبران خليل جبران: والتي لها طابعها الخاص وتجربتها المختلفة إذ أنها تحرص على تعليم اللغة العربية لمجرد كونها لغة.. بعيداً عن الدّين والسياسية، تحرص على أن يكون في برنامجها الأسبوعي حصص لتعليم الموسيقى ووجبة طعام لتلاميذها وجو من التواصل والأُلفة بين أولياء التلاميذ.
ومن المدارس التي شقت طريقها بقوة بكوادر شابّة جديدة مدرسة “فِكرة” والتي أيضاً اعتمدت مبدأ تدريس اللغة العربية كأيّ لغة أخرى، معتمدة وسائل تقنيّة حديثة وكوادر متخصصة وأسلوبٍ تفاعليٍّ بعيد عن الطُرق والوسائل التقليديّة المعروفة.
من جهة ثانية ـ حتى نكون منصفين ـ حاولنا ولمدّة ثلاثةِ أشهرٍ تقريباً الاتصال بمدرسة قرطبة واللقاء بالمشرف عليها، إلا أنّ للقائمين عليها أسبابهم ربّما منعتهم للأسف من الحوار معنا.
ومادمنا نتحدث عن مسؤوليتنا تجاه هذا الجيل من الأطفال، وخوفنا عليهم من نسيان اللغة لنترك العاطفة قليلاً وننطلق من منهجٍ علميّ واعٍ ، علينا أن نكاتفِ جهودنا من أجل الارتقاء بأساليب تعليم أبنائنا العربية خاصة، وأنّ برلين من المدن الأوربية التي باتت اليوم تضمّ أكبرَ جالية عربيّة تقريباً.
نحن نمتلك هنا الكوادر المؤهّلة والوعي الكامل، ولدينا من القادمين الجدد معلمين ومؤلفين وخبراتٍ قادرةٍ على الوقوف أمام هذه المسؤولية، ولدينا أصحاب الخبرة ممن عملوا في هذا المجال في برلين لأربعين سنة وربّما أكثر.
لا ننسى جيلَ المتطوعين الأوائل من المقيمين هنا من أبناء الجّاليةِ القديمة الذين عملوا بجهدٍ وإخلاصٍ ومحبّة وأرسوا قواعدَ هذهِ المراكز والمدارس حتى صارت مستقلة في عملها تضمّ بين جناحيها اليوم أغلى ما نملك وهم أبناؤنا.