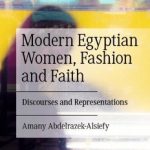حوار مع الأديبة الفلسطينيّة نِعمة خالد

حاورها: موسى الزعيم
هي إحدى القاماتِ الأدبيّةِ العربيّة، روائيّة من نسجٍ خاصٍ.. الفلسطينية نعمة خالد أو كما تُحبّ أن نناديها ” أُم النّمر” هي شاهدٌ أدبيّ على أحداثٍ عربيّة متسارعةٍ وشاهدة على آلام المُخيمات في فلسطين وسوريا ولبنان..عاشتْ تجاربَ اللجوء والنزوح بقسوتِها ووثّقت ذلك فيما كتبتْ..
هي من قرية مغارحزورفي فلسطين،ولدت في عين زيوان في الجولان السوري 1957.
من السّهل أن تدخل معها في حديثِ الذكريات، لكنّك لن تخرجَ من هذا الحديث بخسائرَ أقلّ من الدموع.
تقيمُ حالياً في ألمانيا منذُ خمس سنوات تقريباً، جعلتْ من بيتها ملتقىً أدبياً.
تُشعرك للحظة الأولى أنّك تعرفها من زمنٍ بعيدٍ، دمعتها قريبة، وحديثها دافئ مفعمٌ بالشجّن.. ولها ذاكرة تأبى أن تفوتها تفصيلةٌ واحدةٌ.
بدايات الكتابة كيف كانت؟
أنا بنتُ السياسة، بنتُ التنظيماتِ الفصائليةِ الفلسطينية، قبلَ توجّهي نحو الكتابة.
بدايةً عملتُ في التدريس قبل عملي في الصحافة، كان حلمي دخول كلية الهندسة، لكنّه لم يتحقق.. بعد استشهاد زوجي في 1983 درستُ الحقوق.
بشكلٍ عام أنا ابنةُ الحالةِ الفلسطينية، ومعنيّةٌ مباشرةً بذلك.
وأستطيع أن أقول لكَ إنني جمعتُ المَجد من أطرافه ” فأنا نازحةٌ ثم لاجئة و نازحةَ ثم لاجئة “
بداياتي في الأدب كانتْ خاطرة، نشرتها في مجلة “الحقيقة ” بعنوان “شعبي ليس الله يغفر” وكنتُ أقصدُ فيها الذين يتّخذون موقفَ المتفرّج من الحالة الفلسطينية.
أمّا مجموعتي القصصيّة الأولى” المواجهة” في 1990 فهي مُغرقة في السياسة، الطريفُ أنّها لاقت الكثير من الاحتفاء وخاصّة من المُجتمع الذّكوريّ.. لكننّي بعدما طوّرت أدواتي النقديّة، اكتشفتُ أنّها لا تستحقّ ذلك.. لكنّها عاداتنا..
بعد ثلاثِ سنوات تقريباً صدرتْ لي المجموعة القصصيّة الثانية “وحشةُ الجسد ” اشتغلتُ على الفضاء النسوي الفلسطيني، في مخيّم اليرموك.
السياسة موجودة فيها لكن بخلفيةٍ بعيدةٍ.. أمّا المجموعة الثالثة “نساء” كذلك لم تكن السياسة مباشرة فيها وإنما خلفيّة وظلّ.
بعدها جاءت رواية “البَدد” وهي قراءة نقدية للواقع، مراجعة للذات، أوعين ناقدة.
حتّى أكتبَ “البدد” كان عليّ أن أعيش الحالة في مخيّم عين الحلوة في لبنان لأرصد المُتغيرات التي حلّت بالحالة الفلسطينية.. من كافة النواحي، في البدد أسماء حقيقية، لم أتعمدْ التورية، ربّما من باب المُصادفة أواستشراف الأديب، تنبأتُ بشيءٍ ما عندما تاهت بطلةُ الرواية “سراب” في الصحراء، ثم جاءتْ صفقة القرن لتصدق نبوءة الرواية.
يعتقد بعضهم أن كلمة مخيّم تعني الكيان المُحدد أوربّما المنعزل، هل كان اليرموك كذلك؟ وكيف نزحت منه ؟
أنا بنتُ مخيّم اليرموك في سوريا، وهو يعادل قارّةً كاملةً عددُ سكّانه مليون نسمة الفلسطينيون فيه 280 ألف، فيه من كلّ جنسيات العالم فيه العربي والأوربي.. هو فضاءٌ مليءٌ بالحياة، لا يوجد حالة انعزال، وهذا يعطي الحياةَ غنىً وتفاعلاً، تشكيلتي الثقافية فلسطينية سورية، أنا نتيجة هذا الجَدْل الثقافيّ، شخصيا ًلا تعنيني تفاهات سايكس بيكو..
في بدايةِ الأحداثِ كنتُ مشغولةً بما حلّ بالمخيّم والناس فيه.. خرجتُ بعد قصف الطيران له.
كان ذلك أقسى من تغريبة 1948 في التغريبة الأولى” يَمّا” خرجنا، وجدنا الحُضن العربي باستقبالنا سوري، أردني، مصري.. في تغريبة اليرموك الأمر أقسى، أنت كفلسطيني تبحثُ عن حضنٍ يأويكَ أنت والسوري “أنا والسوري صار بدنا حُضن” في منتصف الشهر 12 أفواج النّاس في الشوارع لا أحد يعرف إلى أين يذهب المساجد مغلقة ” الناس خرجت وكأنّ على رؤوسها الطير”.
كنتُ حينها أكتبُ في مجلة الدّوحة باسم مستعار.
هل تغيّر مفهوم الوطن لديك بعد زيارتك لفلسطين ؟
في عام 2009 سافرتُ إلى فلسطين، و حضرتُ افتتاحية القدس، عاصمة الثقافة، حينها انكسر حلمي” يا
موسى” لحظتها تمنّيت لو أنّني لم أذهب، من لحظتها لم أعدْ أستطيع أن أكتب عن فلسطين كما كانت في مخيلتي، باختصار حلمي انكسر.
صار عندي مفهومٌ آخرَ للوطن، ترسّخت لديّ القناعة بأنّ الوطن ليس حجارةً وبيوت، الوطن بأهلهِ وسكّانه، رحتُ أبحث.. وأبحث لم أجد الأشياء المحفورة في ذاكرتي والتي كان أبي يحدّثني عنها، في المرّة الأولى كنتُ كلّي دَهشة، أعيش حالة (النوستالجيا) كنتُ مبهورةً بكلّ ما هو حولي.
في زيارتنا إلى قصر “هشام الأثري” كان الطريق كلّه رمالاً وتراباً،عند عودتنا كان التراب قد علِق على بنطالي، قلت في نفسي كيف أنفض تراب أريحا عن بنطالي؟!! هذا تراب فلسطين خليّه.. في بيت لحم وأنا في الفندق كنتُ أفتح النافذة وأقول، هذه سماء بيت لحم، أخاطب نفسي وأقول “نعمة خالد في بيت لحم ” استعرتُ مقولة “ناجي العلي” وأنا انظر إلى القمر “والله قمرنا حلو ” كانت حالة الحنين مَخزونة تعشعش في ذاتي بطريقةٍ عجيبةٍ.
في المرّة الثانية انتهت الدهشة، تحوّلت إلى عيون وآذان ترى وتسمع، بدأت الأشياء( الجذور والأحلام )في ذاتي تتكّسر، كنت أسمع ذلك داخلي، الأشياء التي أبحث عنها ليست هي ،أبي كان يروي لي غير ذلك، لم يقل لي أنّ هناك امرأةً عجوز تبيع البقدونس أوالنعناع لتعيش! كان يحكي لي عن أرض الخير، لم أكن أتوقع أن أدخل إلى صيدلية لأطلب دواءً للصداع، فتعطيني الصيدلانية دواءً اسرائيلياً، على الأقل نفسياً لم أكن مهيّأة لهكذا حالة.
عندما عدتُ بدأت أفكر، وأبحث عن مُبررات لأقنِع بها ذاتي على الأقل، جموع العمال التي تقف صباحاً عند الخطّ الأخضر، ذاهبةً إلى العمل في المصانع الإسرائيلة؛ تريد أن تعيش فالبطالة لا ترحم.
من هنا بدأتُ أركّبُ الوعي على الحالة، وأعيد تفكيري بما رأيت، وليس بالقضيّة الفلسطينيّة، كقضيّة حقّ لا يمكن المساس بها، الآن أنا داخل الحالة، ويجب أن أقرأ الواقع بطريقةٍ مُغايرة تماماً، عكس ما كنتُ فيه مراقباً.
تُرجمتْ روايتك ليلة الحنّة إلى اللغة الألمانية، هل أضافَ لكِ ذلكَ شيئاً جديداً؟
صدرت رواية ليلة الحنّة عام 2005 وترجمت إلى الألمانية في2009 حاولت أن أرصد فيها حالة الهِجرة اتجاه أوربا، هِجرة الشباب والعقول المِعطاءة التي يمكن أن يُعوّل عليها في تغييّرالواقع، أتحدّثُ عربياً بشكلٍ عام .
بصراحة لم أشعر أنّه أضاف لي شيئاً جديداً، أو دعني أخبركَ: الأمرعندي سيّان!
عندما ترجمتْ ليلة الحنّة، كنتُ في سوريا، جاء الناشر الألماني إلى دمشق، وأقام حفل توقيع و مؤتمر صحفي،احتفاءً بهذا الحدث، وتمّت الترجمة بطريقةٍ احترافيةٍ، كنتُ على تواصل مباشر مع المترجمَين، خاصّة أنّ الرواية فيها شيء من الميثولوجيا والمقولات والأمثال الشعبيّة المُغرقة في البداوة..
عندما جئت إلى ألمانيا كلاجئة في 2015 دعيتُ إلى الكثيرمن الفعاليات الثقافية، مثل الأكاديمية الإنجيليّة مع مجموعة من الكاتبات العربيّات اللواتي تُرجمت أعمالهن إلى الألمانية، كذلك استضافتي في عددٍ من المُدن والجامعات مثل جامعة برلين الحرّة، وقرأت فيها مقاطع من الرواية بالعربية.
كَتبتَ عنها في الصحافة الألمانية، وقرأ بعض الممثلون الألمان مقاطعَ منها على الجمهور، لكن بسبب ضعف لغتي الألمانية لم أكن مُهتمة بردات الفعل النقديّة لدى الألمان.
شخصياً لم أكن مشغولةً بهذه التفاصيل، أرسل لي الناشرإلى سوريا عدداً من النسخ، لكنني لم أهتمّ لذلك كثيراً..باختصار وللأسف لا أستطيع قراءة النص بالألمانية.
في أوربا عامّةّ وألمانيا خاصّةً عددٌ لابأس من العرب، من أهلك وأقربائك، هل يشكّل ذلك لك وطناً بديلاً؟
قطعاً لا يشكّلون ذلك، ولا حتى مجتمعاً موازياً بالنسبة لي.
مفهومُ الوطن هو حالةٌ من حالات الهويّة، وبحكم أنّنا -العرب- أبناء العائلة ففي الغربة، العائلة تتمددُ وتتراخى، تأخذ أبعاداً كثيرةً و تتماهى، عندما تكون ضمن عائلةٍ صغيرةٍ لديك من الحبّ والشّغف ما يكفي لمن حولك، لكن عندما تتشتت العائلة وتغدو المسافات أكبر، أنت أمام حالة تشبه حالة الجمرة التي في داخلك تتوهّج وتتوهج، لكنّها تتآكل، كلما نفختَ عليها، إلى أن تتلاشى، كلمة واحدة ” كيفك” مثلاً قد تُشعل فيكَ هذه الجذوة من الحنين..
عند خروجك وابتعادك لا بدّ أن تعيش في البداية حالة الحنين، لكن هذه الحالة هشّة مُغطاة.. بوعي أو بلا وعي لا أعلم، هي موجودة وعائمة، وأنا مُتأقلمة معها، لكن لا أرض صُلبة تحتكَ.. أنت معلّق بين البينين.
هذه الحالة تمرّ بمراحل.. أوْلاها تحت القصف أو القتل، أنت معرّض للموت في أيّة لحظة، تبقى مع التيار، لكنك في أيّة لحظة يمكن أن تعيش حالة فَقْد، في لحظة من اللحظات تصبح في مواجهة مع الفقد أنتَ أو (هُمْ).. وتسأل يا ترى “مِيْن أنتَ أمْ هُمْ” هذاهو السؤال القاتل..
كان همّي الأكبر أن أُخرِج إخوتي وأطفالهم من نار الحرب،اخترتُ (هُمْ) وليس أنا حتّى لا أتوجّع لأنّ الفقد يعني لي الكثير، لا أريد أن أتألم بفقدِ أحد.
عندما جئت إلى برلين.. يا إلهي كم كنتُ وحيدةً ” ياريت كنتْ أعيش في زنزانة مِتر بمتر” هذا الفراغ الواسع البارد كبير عَلَيّ “يمّا” قاتل، شعرت أننّي في سجن كبير، سجن الثقافة واللغة سجن الحنين.. سجون.. ثم بدأتْ الهويّات في داخلي تتكسّر، واحدة تِلوَ الأخرى أحاولُ أُمساكها بأسناني، بروحي، و رغماً عنّي “تفلت” منّي تريد أن تغادرني وأمسكُ بها.. أسمعها تقول: “حلّي عنّي اتركيني”
اخوتي وأهلي هنا ليسوا وطناً،(هُمّ َ) بالنسبة لي وَجَع كلما التقيت بهم، يزداد وجعي.
هذا الفراغ الواسع لا أريده، أنا بنت مخيّم لا ينام، في أي لحظة تخرج إلى شارع اليرموك، تجده يزدحم بالناس، المحلات مفتوحة،أم كلثوم تصدح ليلة العيد، بياعي الورد والآس، بياعي السكاكر، ريحة القهوة والكعك والخبز، المخيم بركان من الناس..
أنا أعرف أوربا من قبل، زُرتها كثيراً لديّ معرفة مُسبقة عن الحياة هنا..لم أفكّر في العيش هنا يوماً.
لديّ سؤال يشغلني دائماً وحتّى اللحظة، لماذا علاقات الناس هنا باردة؟ يا ترى المناخ له علاقة؟! لا تفسير عندي، مُمكن البرودة تطبع العواطف بطابعها؟ هل يريدُ العربي أن يعيش مثل الألمان؟
برلين لم تغيّرني،أعرف أنني أعيش حالة (النوستالجيا) بشكلٍ ربّما خاطئ، لكنني مازلت مُتمسّكة برائحةِ الخبز و”وفقش الزيتون” وتنظيف أعواد الملوخيّة على باب الدارمع الجارات.. ليس بيدي أشعر أنّها المتعة الحقيقية، لا أشعر بمتعة تحضير الطّبخة هنا …تحسّ الخشب عندنا أحنّ.. طاولتي في دمشق أكثرحنيّة أسمعها تناديني: ضمّيني، حتّى تقسيم البناء هنا لا تواشج أو تداخل فيه، الزوايا الحادة، فلسفة البناء فيها قسوة.
هل تقرئين ما يكتبه الأدباء العرب هنا، أو لنقل هل ثمّة أدب مهجريّ جديد؟
أنا مُطلعة على بعض التجارب الروائية هنا، قرأت لعدد من الكتاب لكن أعمالهم كتبتْ في سوريا، كما شاركت في عدد من الندوات عن بعض الروايات لـ(مازن عرفة، ونجاة عبد الصمد).
على صعيد تناول الموضوعات الأدبية لدينا من الحِمل والإرث الثقيل ما يكفي الكاتب أن يمتح من الواقع الكثير، أقول للكاتب: وثّقْ ما يحدث، فمهما كان خيالك وقّاد لن يصل إلى ما حصل، يكفي الكاتب أن يكتب الواقع، لاداعي للعب والفنتازيا، اشتغل على الحالة.. أنا شخصيّاً أنتظر كي تختمر الفكرة عندها أقرأ الحالة بطريقة أوسع.
ربما على صعيد الشعرفهو أسرع في التقاط الحدث لأنّه عاطفيّ أكثر.
وسائل التواصل.. ما دورها في ثيمة الحنين في المهجر ؟
هناك شيء أكبر من الحنين، هل أنت موجود؟ “لسّاتك عايش”؟ القضية لها علاقة بالروح..
رغم أهميّة هذه الوسيلة إلاّ أنّها قاتلة، عندي رغبة أضمّ أختي، أن أمسك يدها لا أستطيع، أشعر أنّني في سجن و الشاشة هي القضبان، كم هي مهّمة وكم هي قاتلة..
في الرسائل الورقيّة أنت تُمسك الورقة التي أمسكها الكاتب، تُعطّر، وتوضَع فيها وردةً، ميرمية..
اليوم فقدنا جزءاً من انسانيتنا، أشعر أحياناً أنني روبوت، صباحاً أتصفّح الفيس بوك لأقرأ النعوات وأقول مَن يا تُرى اليوم؟ هذه الوسائل تقتلنا، ولا نستطيع التخلّي عنها.
سمعتُ أنك تكتبين روايةٍ جديدةٍ، هل أستطيع أن أعرف بعض التفاصيل؟
أشتغل الآن على رواية بعنوان (كريستينا والمخيم) لم أنتهِ بعد، لكن تُرجم منها فصلان إلى الألمانية، اشتغلت فيها على فكرة المخيّم، مخيّم اليرموك وحصار برلين، واجهتُ فيها شخصيتين من المخيم ومن برلين، هنا التقيت مع شخصيّات عاشتْ حصار برلين في الحرب العالمية الثانية، التفاصيل متشابهة، هنا لم يمت أحد جوعاً، بينما في المخيم مات أكثر من مئتي شخص، وشتّان ما بين طيّارالشوكولا هنا وطيار البراميل هناك.
على صعيد اللغة كنتُ أطرّز تطريزاً، أنا مغرمة باللغة والانزياح، أمّا في كريستينا والمخيم فقد خرجتُ بلغةٍ جديدةٍ هي لغة الحياة.
.