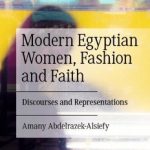الوباء.. والعزلة.. في الأدب

موسى الزعيم
تبدو الفترة الزمنية التي نعيشها حافلة بالتغيرات السريعة مشبعة بالترقب خاصة وأن زائراً ثقيل الظل حلّ ضيفا على الكوكب كوفيد 19 أو فيروس كورونا ، قلب برامج الحياة وصار النظر إلى قُرب نهاية العالم أقرب، لعلها دائرة الوباء بأسمائه المختلفة تدور كلّ حين على هذه الأرض.
من هنا تبدو حساسيّة الفنون الإبداعيّة عموماً والأدب خاصّة في التقاطه الأحداث الآنيّة والاشتغال عليها، والنظر إلى الواقع من خلال زوايا يرى أنّها مُعتمة أو ميّتة ،وتبدو مهمة الأديب أو المبدع بشكل عام في اختراق مكامن العفونة والظّلام في المجتمع، ومحاولة ايصال النّور إليها، لتغدو أكثر صحيّة وسلامة و وضوحاً وتعرية أحياناً، وباعتبار أن الطبيب معنيّ بالشّأن الصّحيّ خاصّة في محاربة الوباء والمرض وتخفيف الألم، فإنّ للأديب جبهات أخرى لا تقلّ أهميّة من خلال محاربة الجهل والظلم والفساد وغيرها من القضايا التي يرى أنّها تجعل العالم أكثر سلاماً، من هنا يُمكن أن ينظر إلى دور الأديب وما يُنتجه من قيم إبداعيّة وفنيّة.
وعليه يغدو المدخل إلى السؤال التالي هل الأدب معنيّ بالتأريخ لحالة الوباء ؟ أم أنّ الوباء بشكل عامٍ عتبةُ يمكن للكاتب من خلالها النفاذ إلى قضايا شائكة، مُريبة لا يمكنه البوح بها والتحدّث عنها مباشرةً، تشغل ساحة فكرهِ، فيلبسها ثوب الجائحة المرضية لتغدو أكثرَ إدهاشاً و قدرةً على إثارة المَخاوف لدى العامّة.
والكاتب ليس معنياً بالتّفسير الديني للوباء الذي اختلفت فيه وعليه فتاوى رجال الدّين – بغضّ النّظر عن ديانتهم ومذاهبهم- إذ اعتبروه عقوبة سماوية يجب أن يكفّر البشر بها عن ذنوبهم، كما هو حالنا اليوم أو مع الطاعون الذي اجتاح العالم من قبل.
والكاتب ليس معنياً بالإحصائيّات والتفاصيل اليوميّة، بل هو معنيّ بالحياة والطبيعة والبيئة والمجتمع بشكل عام، معنيّ برقي الإنسان و تخليصه من آلام البشرية المعنويّة، سالكاً بذلك سبل المتعة الفنيّة.
على صعيد الآداب العالمية شكلّت رواية “الطاعون” للروائي “ألبير كامو” علامة فارقة في هذا الشأن، و كذلك رواية “الحبّ في زمن الكوليرا” للروائي ” غابريل غارسيا ماركيز ” و رواية “العمى” للكاتب البرتغالي “ساراماغو” وروايته “الموت في فينيسيا” للألماني “توماس مان الذي تأثر فيها بفلسفة “نيتشه” حيث نظر إلى الوباء من خلال جماليته، وفكّكه فلسفيًا،هذه الروايات حققت أرقاماً خياليّة في عدد القراء، وغيرها الكثير من الأعمال التي اشتغلت على هذه القضية والتي صورتها بأدق تجلياتها من خلال عتبة الألم عند الإنسان واشتداد كثافة الحبّ عند شخصياتها، وقرب الناس من بعضهم عاطفياً رغم التباعد الاجتماعي .. وفي كثيرٍ الأحيان كانت هذه الأعمال تكشف الجانب القبيح لدى البشر، من خلال تجّار الأزمات، وتشوّه العلاقات الداخليّة والنفسيّة لدى البعض في بعض الحالات كان حبّ الذات هو المُسيطر عليها طبقاً لما تقتضيه غريزة البقاء، لكن في المُحصلة كان القرب من الموت والتماسُ معه ومحاولة التّغلب على الألم من أهمّ سمات تلك الأعمال الروائيّة.
كيف صوّر أدبنا العربيّ الأوبئة؟
لا بد من القول بدايةً إنّ صورة الوباء أو المرض الساري في تراثنا العربي قليلةٌ ونادرةٌ.
في الشعر
إنّ المُتتبع لانعكاس صورة الوباء في التراث الأدبيّ يتوقف قليلاً عند الشعر، ولعلّ أبرز النصوص الشعريّة التي صوّرت مرض الطاعون قصيدة الشاعر ابن الوردي” عمر بن مظفر المعرّي” المتوفى سنة 749 هـ والذي مات مصاباً بالطاعون، ابن الوردي الذي كان شاهداً على هذا الوباء الذي استمرّ مدّة خمسة عشر عاماً، ضرب خلالها مصر وبلاد الشّام، ولابن الوردي “رسالة النبا عن الوبا ” في هذا الشأن صنّفها الدارسون ضمن فنّ المقامات الأدبيّة، والطريف أنه يري في تلك الفترة أن الصين هي سببُ هذا الداء فيتحدّث ” عن الصين التي لم تتمكّن من حماية نفسها منه فصدّرته الى البلدان المجاورة كالهند و الاوزبك وغيرها، يذكر أنّ آخر بيتين كتبهما قبل وفاته متحدّياً الطاعون
لستُ أخافُ طاعوناً كغيري فما هو غير إحدى الحُسنين
فإن متُّ استرحتُ من الأعادي وإن عِشتُ اشتفتْ أذني وعيني
كما يرى ابن الوردي أنه لكثرة النعوش و الموتى في تلك الفترة فقد أثرى العاملون في دفن الموتي ” الجنائزية”
في الشعر الحديث نلحظ أسماء كثيرة تطرّقت الى قضيّة المرض، وخاصة السلّ والطاعون، من هؤلاء الشعراء ” أمل دنقل ، السيّاب ، على الجارم ، التجاني يوسف.. وغيرهم إلاّ أنّ الشاعرة العراقية نازك الملائكة في قصيدتها ” الكوليرا” أثارت إشكالاً ما زالت أصداؤه تتردد إلى اليوم من خلال تجديدها في شكل القصيدة العربية على نهج التفعيلة الواحدة، تقول نازك الملائكة أنّها كتبتها عام 1947.و فيها تصوّر معاناة مِصر من فتك الطاعون الذي راح يقتل كلّ يوم أكثر من عشرة آلاف شخصٍ تقريباً.
فيها تصّور صمت الشوارع وعربات نقل الموتى والخوف المُرتقب لدى الأطفال..
الصمتُ مريرٌ ..لاشيء سوى رجعِ التكبير
حتّى حفّار القبور ثوى لم يبقَ نصير
الميت منْ سيواريه لم يبق سوى نَوح وزفير
الطفل بلا أمٍ وأبٍ
يبكي من قلبٍ ملتهبٍ
وغداً لاشكّ سيلقفهُ الداءُ الشرير
بعض الشعراء عالج القضيّة بأسلوبٍ ساخرٍ فعندما حلّ الوباء بلبنان مثلاً عام 1907 قاول الشاعر أسعد رستم
يا أيّها الطاعون إنّ بلادنا منظومةٌ ومناخُها موزونُ
حتّى جنابك جئت كي تقضي الشتا فيها فأنتِ لها مديونُ
أمنَ العدالة أن تقيمَ بأرضها ضيفاً وتقتلَ أهلها يا دونُ؟
في الرواية العربيّة
يرى بعض الدارسين أن الرواية العربيّة في بداياتها لم تحفل بالقضايا البيئية، كانت تعول دائماً على قضايا المجتمع، كالحبّ وتحرّر المرأة، والتحرّر السياسيّ والخلاص الاجتماعيّ من القهر والظلم والجهل، وبالتالي فإنّ الرواية انحازت إلى المجتمع، في حين كانت البيئة المحيطة تغدو ديكوراً أو إطاراً، ربّما أيضاً أنّ القارئ العربي لا يحفل بتلك الموضوعات من جهة أخرى حتّى رواية أدب الخيال العلميّ شهدَ تأخراً في أدبنا العربيّ قياساً بالغرب.. البعض يرى أننّا نستقطب التيارات والمذاهب الأدبيّة جاهزة من الغرب..
على العموم في البدايات نجد رواية نجيب محفوظ “الحرافيش” والتي تطرّقت إلى الطاعون الذي حلّ بمصرَ نجيب محفوظ المعروف عنه تأريخهُ لتفاصيل وخفايا المجتمع المصريّ عالج قضايا الأوبئة كالطاعون والسلّ في رواياته وخاصّة في رواية “الحرافيش” حيثُ ضرب الطاعون مصر في القرن الثامن عشر، يصور نجيب محفوظ عاشور الناجي الذي هرب مع عائلته من المدينة، بعد أن حلّ بها الطاعون إلى مدينة خالية من البشر، يحاول عاشور بناء مدينتهِ الفاضلة فيفشل !
.. يعمد نجيب محفوظ إلى مزج الواقعية بالفنتازيا في الرواية من خلال تصويره لحركة المجتمع وانتقاله من صيغة إلى أخرى، والأوبئة والحروب بطبيعة الحال، وكذلك في روايته “خان الخليلي” أيضاً يرصد حالات الفقدِ والموت المفاجئ نتيجةَ مرضِ السلّ.
من جهة أخرى كتب سعيد مكاوي ثلاثيته ” الطاووس، الطاعون،و الطاحون” يعالج فيها ما حلّ بمصر من أوبئة وأمراض زمن المماليك وكذلك فعلتْ الروائية الفرنسة “أندريه شديد” من أصل مصري صاحبة رواية اليوم السادس والتي أُنتجت فيلماً سينمائياً فيما بعد.
من جهة أخرى يتطرق الروائي السوري “حنّا مينا” في روايته “المصابيح الزّرق” لمرض السلّ أيضاً..
أمّا الروائي السوداني أمير تاج السرّ فله رؤية خاصة في روايته ايبولا 76 في الرواية يتحدث تاج السرّ عن الوباء الذي داهم أحد المشافي في الجنوب، وقضى على أفراد طاقمه إلاّ أنّ طبيباً واحداً نجا وراح يروي حكاية ما حدث، والميزة في هذه الرواية أنّها تنبأت بعودة الفيروس لكن بشكلٍ جديدٍ وبالفعل هو ما حدث، في الرواية يتحدّث الراوي بعين الطبيب، وفق رؤيتهِ وتحليله الطبيّ للأحداث.
أمّا في رواية حارس المدينة الضائعة للكاتب الأردني إبراهيم نصرا لله والتي كتبت بين أعوام 1996\ 1997 فإنه يتنبّأ فيها بما سيحدث بعدد 22 سنة من كتابتها الرواية التي تجنح للغرائبية والسخرية السوداء بعض تفاصيلها بدأت تتحقق على أرض الواقع اليوم، البطل يحكي رؤيته المستقبلية لمدينة عمّان بعد موت سكانّها، وبقاء رجلٍ واحدٍ يعمل مدققاً لغوياً في إحدى الصحف، يضع تصوره للعمل مثلا “أون لاين” أو حصوله على تأشيرة سفر بين حيّ آخر في المدينة.. ربّما هي رؤية الكاتب واستشرافه للعالم بشكلٍ مختلفٍ عمّا هو عليه بين يديه الآن.
والملاحظ أن بعض الأعمال الأدبيّة الخاصّة بحالة الوباء خرجت إمّا بصيغة النُصح و الإرشاد أو أنّ بعضها بالغَ إلى حدّ الفنتازيا أو الأسطورة والخرافة.
الأدبُ والعزل أو الحجر المنزلي:
تختلفُ مظاهر التصدّي للوباء، وطرق الوقاية منه باختلاف العصر، وتطوّر وسائلهِ التقنيّة والطبيّة، وفي الوقتِ الحاليّ وكنوعٍ من الوقاية من انتشار فيروس كورونا، النصائح الطبيّة تتّجه إلى الحجر المنزلي، ومنع الاختلاط، والتواصل الاجتماعي المباشر بين الناس.
كلّ ذلك فرض نوعاً جديداً من نمط الحياة، يسميه البعض العزل الاجتماعي،و من الملاحظ في الفترة الحالية أنّ الإقبال على قراءة الروايات التي تتحدّث عن الأوبئة بشكلٍ لافتٍ وقد أخبرني أحد أصحاب المكتبات العربيّة في ألمانيا أنّ الطلب ازداد بشكلٍ كبيرٍعلى روايات (الحبّ في زمن الكوليرا، والطاعون ، والعمى)
هذا المصطلح الحجر الصحي أو العزل، خلق مساحة للتأمل و الإبداع، ولا بد هنا أنّ نذكر أن هناك أعمالاً أدبيّة وصلت إلى العالميّة نتيجة العزل، فالفرنسي “مارسيل بروست” الذي كان مصاباً بالربو ولا يجرؤ على فتح نافذة منزله أخرج إلى العالم بحثه الروائي الفلسفي ” بحثاً عن الزمن المفقود ” محل اهتمام النقاد وعلماء النفس، وكذلك المبدع اللبناني “بولس سلامة” الذي كان يقبع في سريره لا يرى من الحياة سوى سقف غرفته، أبدع في الشعر والفلسفة ويكفيه كتابه ” الصراع في الوجود”.
بعضهم أراد الاستثمار في العزل أو الحجر المنزلي، فصار هناك منصات أدبية ومبادرات مجتمعيّة ثقافيّة، ومنها منصّة “أدب العزلة” التي أطلقتها مؤسسة سعوديّة هي هيئة الأدب والنشر والترجمة وتهدف إلى استثمار البقاء في المنزل لنشر الأدب وإبداع نصوص كتابّية في مجال الشعر والقصة والرواية وغيرها من الفنون الإبداعية، تحت صيغة الاستثمار الإبداعي في العزل، لإبداع نصوص جديدة من وحي الواقع الحالي، ومن وحي العُزلة، وقد لاقت إقبالا جيداً تبعتها منصّات أخرى في نفس التجربة ولنفس الغاية.
ومهما كانت المُسميات، أدب الحجر أو العزل أو حتّى أدب السجون ، فإن ذلك يضيف قيمةً فكريّة إبداعية من خلالها يرى المبدع أو الفنان أنّه بعيد عن صخب الحياة ألمْ يعتزل كتاب التّيار الرومانسي الأوائل الحياة وهربوا بعيداً إلى عالم الطبيعة هرباً من صخب المجتمع” لكن بإرادتهم واختيارهم، اليوم الأمر يبدو مختلفاً.. لعلها المُعادل الآخر لأن يكون الأديب في القاع ينهل منه آلام المجتمع وتطلعاته بعينيه وقلبه.. فالعزل وجهة نظر من زاوية بعيدة يتأمل فيها المبدع ببصيرته، ويرتد إلى ذاته ينشغل فيها بالتحليل والتركيب الفلسفي وبناء عالم أفضل.
من جهة أخرى يبدو الأمر على غير المتوقع، فإن لهذا الحجر ثمنه، وأعتقد أننا سنخرج يوماً وقد تدّلت “كروشنا” أمامنا، ربّما هي ضريبة الخمول والكسل، وقلّة الحركة.. وهنا تحضرني أبيات لشاعر رأيت أنها تصف حالي وحال الكثيرين في الحجر المنزلي فالشاعر محمود الساعدي راح يشكو للطبيب عِظم كرشه فيقول :
شكوتُ إلى الطبيبِ عظيمَ كِرشي فَرَقَّ لشكوتي ولسوءِ حالي
وأخبرَني بأن الكِرشَ ذُلٌّ وهَمٌّ مثلُ أثقالِ الجبالِ
وقد سألَ الطبيبُ : بما تعاني؟ فقلتُ : الحالُ أبلغُ مِنْ مقالي
وقُلتُ ألا تراني كيفَ أبدو؟ ألا يُغنيكَ هذا عنْ سؤالي!!
گفيلٍ صِرتُ في شكلي ومشيي وحُبلى بالتمامِ وبالكمالِ
بالمحصلة الفترة الحالية التي نعيشها في زمن كورنا أو كوفيد 19 لا بدّ أن تفرز أدباً خاصاً بها و بهذه المرحلة، سيكون مختلفاَ في الطرح والمعالجة للوباء، خاصّة وأنّ المعطيات الحياتيّة ووسائل الاتصال اليوم تغيرت بشكلٍ كبيرٍ عمّا كانت عليه، وصار النظر إلى قضية الوباء يأخذ بعداً مختلفاً إذ جعل العالم متوحدا ً في إيجاد حلّ لهذه القضية، بينما الأدب يستشرف المستقبل الآمن والأديب يتحسس رؤوس الجميع قبل رأسه.
.