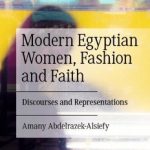من برلين إلى دمشق
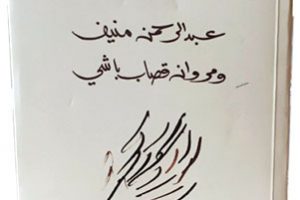
رسائل مروان قصاب باشي وعبد الرحمن منيف
موسى الزعيم
بين دمشق وبرلين تدور أحداثُ احدى وثلاثين رسالةً، شغلت صناديق بريد المبدعَين الروائي عبد الرحمن منيف والفنان التشكيلي مروان قصاب باشي، في فترة ما بين عامي 1990 – 2003 صدرت هذه الرسائل في بيروت عام 2012 في كتاب يحمل عنوان ” في أدب الصداقة “وبمقدمة مميزة للناشر الدكتور فواز طرابلسي.
مروان قصاب باشي واحد من أهم وأكثر الفنانين العرب حضورا في المعارض العربية والعالمية والذي خطط للمجيء الى باريس لكن ظروف حرب 1956 منعته وغيرت طريقه إلى ألمانيا وهو المعروف بإبداعه في رسم الرؤوس والوجوه والتي تبدو دائما تحمل همومه وانشغالات وجدانه على الصعيد العربي والعام بشكل خاص.
في كتاب أدب الصداقة
هواجس اللوحة غير المكتملة، والرواية التي تُعاند كاتبها، مشاغبات الألوان وسحر مزجها مع أوجاع الواقع العربي وانتكاساته، بدء من نكسة حزيران مرورا بحرب الخليج ومجزرة قانا وغيرها من الانتكاسات العربية، بالإضافة إلى الذكريات الطفولية التي عاشها الفنان التشكيلي قصاب باشي وظل أمينا لها في دمشق، حيث يغدو على حد قوله “هذا الطفل أبو الرجل”، الرجل الذي ظل أمينا لحياته ونشأته الثقافية الأولى في روابي دمشق، أمينا لذاكرة تحفر عميقا في مكنونه المعرفي الأول رغم تأثره بالتعبيرية الألمانية حتى غدا أحد أهم رموزها.
يفتح الكتاب أبواب قلبي الرجلين فيبوحان بمكنون نبيل، امتزج فيه العمل بالألفة والمحبة وبذكريات الماضي وتطلعات المستقبل، يتشاركان الآراء والأفكار في خطوات إبداعية كثيرة حتى ليختلط عليك الأمر جمالياً حين يتحدث عبد الرحمن منيف عن الفنّ والألوان والحركة التشكيلة والعدد الكبير من أصدقائه الفنانين، بينما يحكي مروان من قصاصاته نتفاً إبداعية مرسومة بالكلمات.
في هذه القصاصات والتي كما يسميها في انفتاحات على الكتابة تشغله، في مرسمه في أثناء رسم إحدى لواحاته فتداهمه تلك الأفكار فيدوّنها رسائل إلى عبد الرحمن منيف، فهو يرى فيها رديفاً ذاتيا لانشغالات اللحظة التي يمزج فيها اللون على الورق وكذلك الكلمة،
فيما يرى عبد الرحمن منيف في رده على هذه القصاصات أنها جنون الكتابة الجميل.
في معرض إحدى الرسائل يحكي عبد الرحمن منيف إنّ هذه الرسائل لا تخضع للقانون السائد: الرسالة وجوابها، بل ومن باب المُداعبة أنّ هذه الرسائل في كثير من الأحيان تتلاقي في الطريق بين برلين ودمشق “باتت رسائلنا كالمسافرين تتلاقى في الطريق” وأحيان أخرى يأتي الردّ من أحد الطرفين على رسالة لم تصل بَعدُ، ” أكتب رسالة وقبل أن تصل يأتي الرد وكأنك كنت تتوقع ما سأقوله .. يقول مروان.
حتّى أنّهما يسمّيان أيام الخميس ـ أيام وصول الرسائل ـ بالجسور..
بينما “حواشي الرسائل” على حدّ تعبير عبد الرحمن منيف، “فهي بمثابة الفخذِ عند طائر السُّمّن، أو القلب الذي ينتقل إلى الشفاء عند القبلة أو لمسة الفرشاة الأخيرة عند انتهاء اللوحة.
وسلسلة الرسائل والأسئلة مستمرة وبالتالي فإن الكثير مما يُكتب يمضي ويبقى في نفس الوقت، “إذا لم أجب على سؤال اليوم قد أجيب عليه غدا “حسب ردّ قصاب باشي.
يرى الروائي عبد الرحمن منيف في بدايات رسائلهِ أن هذا النّوع من الكتابة يُقيم جسراً بين الفنون، يجعلها مُتصلة، متكاملة، وربما يهيئ ذلك صيغة جديدة في الابداع والعمل الإبداعي والفني عموماً.
وهي فكرة يطرحها منيف من بين اشتغالاته الفكرية القلقة” ماذا لو وضعنا أمام أعيننا مئة سؤال، وهي الهمّ الشّاغل وأعطينا لأنفسنا المساحة الكافية للإجابة؟
تتداول الرسائل عدد كبيراً من المشاريع الثقافية والإبداعية المشتركة بين المبدعين وبين أطراف أخرى من مثل فكرة انتاج فيلم إلى اصدار الكتب التي تتعلق بالحركة الثقافية التشكيلية، بمتابعة دائبة وحثيثة لما يتم انتاجه فنياً في العواصم العربية وخاصة بيروت وعمّان ودمشق، وبالتالي ومتابعة الحركة النقديّة المتعلقة بالحركة التشكيلي والإبداعية عموما حيث شغلت الرسائل أفكار ومداولات كثيرة حول إصدار كتاب يتعلق بأعمال قصاب باشي وما رفقه من التخطيط لذلك وصعوبات النشر والعمل والتنضيد وضياع بعض اللوحات وغيرها أو كتابه الذي أهداه لأطفال فلسطين “من مروان إلى أطفال فلسطين” وهي مجموعة أعمال أهداها إلى جامعة بيرزيت ومركز خليل السكاكيني في رام الله.
في حين يحار من يتابع أخبار الحركة التشكيليّة العربيّة ويُحاول التوثيق لها في الرسائل فتجد اهتمام عبد الرحمن منيف الدائم بأصدقائه التشكيليين ومتابعة أخبارهم.
في حين أن مروان يتابع أخبار عبد الرحمن ومشاريعه الكتابية في ابداعه الروائي خطوة خطوة، حتى يكون أول قارئي أحدث ابداعاته وبالتالي يرسم غلاف الرواية الجديدة له، ويمكن للقارئ أن يتتبع ذلك من خلال الفترة الزمنية في بداية عام 1999 التي أبدع فيها منيف روايته أرض السواد ليقول لصديقه:
“اليوم وضعت نقطة الختام في اليوم الأخير من اقامتي في بيروت، وبعد أن عُدت إلى دمشق وتركتها تبردُ قليلاً، قرأتها في المرّة الأولى والثانية في القراءة الثالثة، تصبح كأيّة سمكةٍ جاهزةٍ للأكل، صحيح أن فيها كمية من الحسك غير قليلةٍ لكن في المُحصلة يمكن أن تُؤكل”.
من جهة أخرى يكشف مراون عن هواجسه الأولى وإرهاصات بداية اللوّحة، والشروع في خرمشة بياضها .. يا عبد الرحمن إنّ العمل الفنيّ كما نعمل ليس بمجال الهدية تأتي مع اليمام إلى الشبابيك، بل إنّه كمن ينتشل زرعة الورد بعد أن يمسّها برفق، بأنفهِ ليحفر تحتها القنوات الأرضيّة المُظلمة ويسير فيها منحنياً جاثياً واقفاً يدافع بغريزته وعقله ويديه … يتابع الطريق حافراً بأصابعه وأظافره مستمراً رغم التّحدي دون وهنٍ حتى يسوّي الطريق ويخرج إلى النور مع رائحة الشمس والتراب، حاملاً وردةً جديدةً منتصراً بها ومن ثم يبدأ البحث عن وردةٍ أخرى لا تًطال إلاّ بالخيال..
في رسالة آخرى يشبّه قصاب باشي اللوحة بقصّة الحياة، فمن المُمكن حقاً أن نرسم لوحة يتيمةً نعمل عليها مدى الحياة، آلاف الطبقات يوماً بعد يوم، تجاربنا ورؤيتنا حتّى الموت، هكذا تبقى اللوحة قصّة الذات كالجبال والبراكين، تحوي في داخلها آلاف السنين.. “هكذا يُخبر طالبتهُ التي زارتُه في مرسمهِ وسألته عن لوحةٍ مقلوبةً باتجاه الجدار.
إذاً هي حكاية “سيزيف” الجديد حسب رأي قصاب باشي، إذ يشبه رحلة عذابهِ مع اللوحة برحلة سيزيف مع صخرته إلاّ أنّ الفرق بينهما أنّ سيزيف يُدمن العذاب في دحرجة صخرةٍ واحدةٍ، بينما هو يُدمن الصعود مع صخرتهِ ومن ثمّ البقاءُ لفترةٍ في القمّة، وبعدها تبدأ رحلة العذاب مع صخرةٍ ” لوحةٍ” جديدةٍ.
ولعل المهتمّ أو دارسَ ظروف وإرهاصات ولادة العمل الإبداعي بشقّيه الكتابيّ والتشكيليّ، يجد ضالته في مراسلات الرجلين وبما تحويه من البوحِ والإشارات وإلى الظروف النفسيّة والعامة ومعاناة المُبدع في ولادة إبداعه بالإضافة إلى الظروف الزمانية والمكانية التي عاشها المبدع أثناء عمله، في الغالب يتمّ التعامل من النص الإبداعي أو المعطى الفني بمعزل عن حياة الكاتب أو الفنان وهذه إحدى النظريات، لكن في غالب الأحيان يدفع المبدع ثمناً باهظاً من أعصابه على الأقل في سبيل تحقيق المتعة الفنية والجمالية.
ويمكن لقارئ الرسائل أن يجد ذلك عند عبد الرحمن منيف وهو يبحث عن مكانٍ بعيدٍ عن الضجيج عن دعوات المعارف والأصدقاء التي فيها الكثير من المجاملات وموائد الطعام وهدر الوقت، فيستأجر منزلاً في ريف اللاذقية أو بيروت، هرباً من حرّ دمشق كذلك
فدمشق “قاتلة في الصيف وتبدد الوقت”.
هذه الخلفيات التي باح بها المبدع لصديقه، تشكّل عالماً رديفاً للنص، ممتعاً في القراءة، مغرياً في التنقيب في ثنايا حياة المبدع، لكن في غالب الأحيان لا يتمّ التوقف عندها إلاّ إذا كتبَ المبدعُ ذلك في مذكراتهِ وتمَ إصدارها يوماً، لكننا كقراء ومتلقين لا نحفل إلاّ بإدهاش العمل الإبداعي على الورق وبين أيدينا.
غير أن الرجلين لم يتبادلا أحاديث العمل والفنّ فقط، بل كانت الأخبار والهموم والفرح والحزن حاضرة دائماً بين ثنايا سطورهما
وفي غالب الأحيان كانت تنتهي الرسالة بعبارة ” الأصدقاء يسلمون عليك أو تذكر أسماؤهم في الختام.
الرسائل الجديدة لأخوان الصفا
من جهة أخرى يبدو أنّ فكرة الرسائل استهوت عبد الرحمن منيف فيقول لصاحبه في إحدى رسائله أنّه انتهى من رواية أرض السواد وهو عازم الآن على الاستمرار في فتح نافذةٍ جانبيّة للرسائل المفتوحة، لعلّه يجد في هذا الفنّ مساحةً جديدة من السرد الإبداعي وتحريضاً على الكتابة، من خلال طرح الأسئلة الإشكالية المثيرة المُقلقة دائماً مع شخصيّات هي بالأساس إشكالية، أو لها حضورها على المستوى الفكري والسياسي العالمي.
فيخبر مروان أنّه سلّم الرسالة الأولى وكانت حواراً مع “بينوشه” امبراطور تشيلي المخلوع، وأنّه بدأ برسالة أخرى الآن “للرفيق”
غورباتشوف، في حين أنّه ينوي كتابة رسالة مشابهة كلّ أسبوعين، وينتظر نشرها في إحدى الصحف، وسوف يخبره في حال نشرها.
وحسب رأيه كلّ ذلك يأتي بسببِ الغضب والتآكل والأفق الأسود، الذي يعشه المثقف والإنسان على الساحة العربية والعالمية.
مروان تسكنه حكايا الأمكنة:
لم تكن الرسائل بين المبدعَين مشاريع عمل وإنما كانت تحمل في طياتها الكثير من البوح والشغف.
في رسائل مروان حكايا الذكريات في طفولته الأولى في دمشق، فهو يغرف من ذاكرته العميقة الصافية وحسب مقولته هناك “إن الطفل هو أبو الرجل” الطفل الذي بقي يعيش في داخله يحرك مكنون ابداعه.
هذه الحكايا فيما إذا خرجت إلى النور وصنّفت كانت عملاً إبداعياً في غاية الأهميّة، لما تحمله من فطرية القول وعفوية الأحدوثة.
ودمشق كانت المسرح
جاء البوح والإفراج عن هذه الذكريات بتحريض من أسئلة عبد الرحمن منيف، هي لعبة الأسئلة المستفزة إبداعياً، ففي قائمة الأسئلة المقترحة والتي وردت في رسالته وعلى المكونة من ست صفحات وضع فيها قائمة من الأسئلة الاحترافية فيما يتعلق بالفنان وعالمه الداخلي والمحيط، من حيث اللون والطبيعة، هذه الأسئلة هي حالة فريدةٍ تليق بفنان بحجم قصاب باشي، استطاع منيف العودة بمروان إلى الطفولة البِكر التي شكّلت مِهاد مكنونه الإبداعي التشكيلي وغدت المحرّض له في غالب الأحيان ومن خلالها بقي أمينا لشرقه وثقافته رغم حظوته ومكانته التي وصلت إلى العالمية.
من هذه الحكايا ضفدع السيد جورج ومستنقعات الغوطة، وحكاية الكلب الأبيض، من خلال سرديته الدرامية لها في أكثر من رسالة لنجد أن “بيوض” كان كلباً أبيض وكان له بالغ الأثر في نفسه من خلال ما لاقاه هذا الكلب من عذابات والنهاية المأساوية.
ومن خلال ذلك يمرر قصاب باشي اجابته عن اللون الأبيض التي سأله عنها منيف في إحدى رسائله.
سهرات الأسرة عند أصدقاء والده وحكايا السمر، قهوة جارته الحموية، وحكايا السيران والغوطة وغيرها من تراجيديات الحياة الفطرية ومنها ما يصل حدّ الفانتازيا التي عاشها وسمعها، كل ذلك يكشف عن قدرة سردية إبداعية جميلة جاءت عفوية الخاطر دون تنقيح أو تشذيب، لكنها بتكنيك قصصي حكائي مدهش.
في رسائل الرجلين ذكر لعدد كبير من الشخصيات الإبداعية العربية التي اعتنت بإبداع الرجلين فهناك نزار قباني ومحمود درويش وسعد الله ونوس وعادل قرشولي.
.