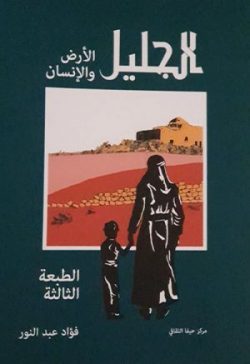قراءة في عالمِ أمير حمد ناصر القصصيّ

موسى الزعيم
يعدّ الكاتب أمير حمد ناصر، من الكتّاب العرب الأوائل الذين كتبوا القصّة القصيرة في ألمانيا، فقد سبق أن صدر له عدّة كتبٍ، تجمع مابين القصّة والنص الشعري الحداثي والمقال الصحفي.
في القصّة القصيرة، يكتبُ بأسلوبٍ شيّق، يشكّل عالمه السّردي من خلال التّداعي، فعينٌ على ذّكرياتِ الماضي، وعينٌ على الحداثة ترصد الحاضرَ وبين السّودان وبرلين، يمتدّ تدفّق نهر إبداعه القصصيّ.
هذه المجموعات صدرتْ تباعاً بين أعوام 2014 و2016 وهي( مساءٌ متوتّر على نهر هافل) و (منزلٌ تحتَ القمر) وكتابُ (هجرة عكس الرّيح) الذي يتناول رواية الطيّب صالح موسم الهجرةِ إلى الشّمال.
في قصصه يحاول الكاتب إيجاد بيئةٍ قصصيّة خاصّةٍ به، وعالم سرديّ له ميزتهُ ونكهتُهُ إذ لا ينفصلُ في قصصه عن البيئة التي ولد وترعرع فيها، يبقى أميناً لتلكَ الأرض التي أنجبته، وبالمقابل يرصدُ الحالة التي يعيشها في الغربة، يحاولُ في نصوصهِ أن يقيمَ جسراً أدبيّاً بينَ بلده الأصليّ السّودان و مُغتربهِ ألمانيا.
يبدأ نبضُ ذاكرتهِ الطفوليّة البكر هناك في أفريقيا ماضياً، لتنتهي القصّة عندهُ هنا في أوربا حاضراً.
بعضُ القصص تدور أحداثها في إحدى الضّفتين في مجاهل غابات أفريقيا أو صخبِ مدن أوربا، شخصياتهُ القصصيّة عابرةٌ للزمان، والمكان لها جذورٌ نبتتْ في تربةٍ أفريقيةٍ وظلال أورفتْ في مكانٍ آخر.
في قصصه تَجدُ الغابةَ والعاصفةَ والنّخيل والرّمل والطّبل والكرفس وقبورَ الأولياءِ الصّالحين، كما تجدُ نهرَ شبريه، وشوارع برلين ومراقصها وصديقهُ التّركي والمغنّي الكمروني وبائعُ الزّهر الصّيني، وجارته الألمانية، وعالمٌ مترعٌ بالفنّ، وحياة الصخب حينا ً والرّتابة حيناً آخر وغيرها من التفاصيل.
وبرلين المدينة التي يتقلّبُ طقسها كتقلّب قلبِ عاشقٍ مراهقٍ، هي الأمّ التي تضمّ القادمين إليها من شتاتِ الأرض العاشقةُ الهاربة نحو المستقبل، المدينة التى ألقت مخلّفات الحرب الماديّة والفكريّة خلفَ ظهرها، وانعتقتْ ترقصْ في صخبٍ وفرحٍ.
يسعى أمير حمد ناصر في قصصه إلى الاشتغال على المزج بين واقعية النصّ وفانتازيا الخيال، فهو قادرٌ على أن يدير دفّة القصّة ويحرفَ بوصلةَ المشهدِ، لتجد نفسك في ساحة قريةٍ بدائيّةٍ تحيط بك أشجارُ النّخيل، وعواصفُ الرّمل، لكن سرعان ما يُنقَلُ المشهد في صحوةٍ فنيّةٍ إلى القطار المسافر عبر غاباتِ أوربا وسهولها.
في كتابه (مساء متوتر على نهر هافل) قصصٌ قصيرةٌ، فيه عددٌ من القصص حيث برلين مسرحاً لكثيرٍ من أحداثها.. برلين التي يُقيمُ الكاتب فيها منذ أكثر من أربعينَ عاماً شكّلت أرضيّةً لعالمهِ القصصي المعاصر، حيثُ تدور أغلبُ أحداث قصصهِ، وإن كان ينقل عدسته بين الفينة والأخرى إلى بلاده السودان.
في( مساءٍ متوتّر على نهر هافل) يستوقفكَ العنوان بدايةً..فالتّوتر سمةُ الغَريبِ هنا، ومتلازمة قلقِ الحياةِ اليوميّة ترافقُ الإنسانَ طيلةَ الأربعٍ والعشرين ساعة..
والتأمّل سمة المبدعين، ولطالما كانَ النهر موحياً وملهماً لكثيرٍ من القصص، كيف لا وقد ترك الأديب في وطنه شريان حياةٍ كاملةٍ وهو النيل، ينظر بفطريّة حبّه للنيل يرى صورته مرسومةً على وجه ماءِ “شبريه” في برلين.
في قصص المساء المتوتر يُمهّد لقصصه في مقدمة الكتاب، بأنّه من بيئةٍ أسطوريّة ينحدرُ من مدينةِ ” واو ” جنوب السّودان “هذه البيئة التي تُحيلنا إلى غاباتٍ كثيفةٍ ووحوشٍ وظلالٍ داكنةٍ ترسمُ في مخيلتنا عالماً من أساطيرَ وحكاياتٍ غرائبية..”
فنّياً يضعنا على الطّريق كي نشكّل معهُ عالماً مختلفاً، من خلال مدينةٍ تعجّ بروحِ الاختلافِ والألفةِ وتنوعِ الأعراقِ والثقافات..
في قصّة مساءٍ متوترٍ: والتي حملتْ المجموعة عنوانها، يبدأ الكاتبُ قصّته من قلقِ النّوم يبدأ بالعدّ – كما علمتهُ أمّه في الصِّغر- إلى عشرة، لكنّ ذاكرتهُ تبدأ بالدوران، يرصدُ بدقّة تفاصيلَ حياةِ ليلةٍ واحدةٍ من ليالي المهاجرين الأفارقة في مرقصٍ برليني، تحت الأرضِ.. يقولُ على لسانِ البطل “..الأفارقة يحلّون مشاكلهم في المرقصِ، يتخلّصون منها كما تنزلقُ الأفعى من جلدها “
يرسمُ الكاتب صورة لهذا القلق، المرافقِ له، من خلالِ بيئةٍ جديدةٍ مختلفةٍ عن موروثه الثّقافي الذي تشرّبه.. عليه تزجيةُ الوقتِ في مكان ما، بحثاً عن المتعةِ والتّجريب عن حالةٍ تزيلُ عنهُ دبقَ الرّتابة والمللِ المُصاحبِ، فيصفُ الوقتَ بدقّة فنيّة جميلةٍ
” لماذا يزعجني الوقتُ إلى هذه الدّرجة، كلّ شيءٍ حولي هنا منوطٌ بالوقتِ اللّعين، دقاتُه الرتيبة،الوئيدة كلّ شيءٍ، المُنبّه العتيقُ، المذّكرة الجداريّة على نمطِ اللّوح المسماريّ البابلي ولوحةُ الزّمن السريالية لدالي ،هل يمكن أن أُعلّق الزّمن مثلهُ على جذعِ شجرةٍ وأنام، أهمله ولو مؤقتاً”
يتعرّف على امرأةٍ ذاتِ مزاجٍ خاصٍ في المرقص، يرقصُ معها، لكنْ كلّ محاولاته في جرّها إلى السرير تفشل، لكن بالمقابل تشاطرهُ الذّاكرة، ترفض الحديثَ عن السياسة والطبخِ وغيره.. تقول له: حدّثني عن النّاس في افريقيا الفتيّة، الهائجين خلفَ القَطيعِ ومنبعِ النّيل المُقدس، و طقوسِ التّعميد، قلْ لي شيئاً عن ظلالِ الغاباتِ الدّاكنة..وأقراصِ النّجوم الدانية”
تبقى المرأة التّي في مُخيلتهِ فكرةً، تُرجعهُ إلى مهدِ الطّفولة، يُنطقها هو بما يتمنّى، يحاولُ النّوم يغيّر طريقة العدّ فتصيرُ على شكلِ كسورٍعشريّة.
ولعلّ قارئ المجموعة القصصيّة لابدّ أن يتوقّف عندَ قصّة في غايةِ الأهميّة إبداعيّاً وهي قصّة (السّاحة).
كعادةِ الكاتب تبدأ القصة بعالمه الطفولي المشحونِ بالذكريات،هذه الحالة، تُعرف عند الكتّابِ المُهاجرين بلحظةِ توقّف الزّمن عند ذكرياتِ الوطنِ، المكان والشّخصيّات تبقى على عمرها، ترفض بشكلٍ لا إرادي أن تكبر أو تشيخَ في خيالِ المُهاجرِ.
السّاحة.. حيثُ ملعبُه ومكانه المُفضّل، يبني فيها بيته من الرّمل الذي سرعان ما تذروه ريحُ العاصفةِ.
القصّة تقفُ على قضيّة في غايةِ الأهميّة، فالسّاحةُ هي الوطنُ عامةً، وما يدور من أحداثٍ فيها، يمكن أن نعكسها على المتغيّرات في تلك البيئة التي يدورُ فيها الصّراع الطّبقي والفكريّ، بين القديمِ المحافظِ والتيار الذي ينشدُ التّغير، وإن اختلفتِ الوسيلةُ، بغضّ النّظر عن مشروعيتها، بين تاجرٍ اشترى السّاحة بما فيها، وأرادَ أن يقيمَ عليها مشروعاً سياحيّاً، يرتاده سكّان القرية، وبين فئةٍ من الناس اعتبرتْ شراءَ التّاجر للسّاحة سرقةً، لتراث القرية وتاريخها.
إلاّ أنَّ هناك فئةً صغيرةً تحاولُ تمييعَ القضايا الكُبرى و شخصنتها، كما فعلتِ الأمّ في القصّة، حيثُ عزتْ حزنهُ إلى عدم لقائهِ ابنة خالته لأنّه يحبّها بينما هو مشغولٌ بقضيته الكبرى وهي متابعة ما يدورُ في السّاحة من أحداثٍ.
بيئة السّاحة موجودةً في كلّ مجتمعٍ، لكنّ الكاتب تناولها بطريقةٍ تحللُ نمطَ تفكير هذه الفئة البسيطة.
“في المساء جلس أبي وأمّي يتحدثان عن السّاحة، أمسكت أمّي بكفّي ” أنتم في الواقع لا ترغبون في السّاحة ولا تعميرها وإنّما التّحدي فقط، فقد انصرمت أعوامٌ عليها وأنتم لا تحرّكون ساكناً، إلاّ حينما جاء هذا الرّجل الثّريّ، لقد أيقظكُم من خمولكم، أنتم راغبون في التّحدي لا غير”
قد لا يختلفُ الحال كثيراً في قصّةٍ أخرى وهي قصة (الكتّاحة) أو العاصفة الرّمليّة، والذي يسترجع الكاتب أحداثها في القطار، بين برلين وزيوريخ، تعود به الذّاكرة في إلى قريته، يروي تفاصيل دقيقة مخزونةً في عمقِ مخيّلتهِ، وتلافيفِ ذاكرتهِ “فالرّحلة في الذّاكرة تجديفٌ ضدّ التّيار” كما تقول مس روز في القصة.
يختار السّارد اسم البطل “النّخيل” هذا الطفل سمّاه أبوه بهذا الاسم تيمُناً بالأشجارٍ الباسقة أو كما يسميها الأشباح.
صورة العاصفة الرمليّة مأخوذةٌ من حياةِ الكاتب في الرّيف، كعادته يرجع شريط ذكرياته إلى هناك حيث العاصفة، تحمل مستويين لغويين: الأول المعنى المعروف، والثاني مبطّن رمزيّ، وهو إرادةُ التّغيير لدى جيل الشّبابِ في تلك الفترةِ، وربّما نسفُ الواقعِ عامّة.
من جهةٍ أخرى العاصفة الرمليّة، أخذتْ معها الكثير من الأشياء كالطّبل والتلفاز وغيرها بل وأخيه الذي اختفى عن مسرح الحياة.
يستيقظ الكاتبُ من غفوة ذكرياته، ويعود الشريط إلى الحاضر حيث “مس روز” تراقبُ السهول الخضراء من نافذة القطار، لتقول له ربّما زرتُ موطنكَ في إحدى عطلات الصيف ” ..وطني أبحرَ مقتلعاً جذوره، ما من شيءٍ يشي إليّ بوجودهِ، إلاّ ما يرويه عنه القاطنون هناك ”
المجموعة القصصيّة الثانية عنوانها (منزلٌ تحتَ القمر):
تضمّ عدداً من القصص، منها قصّة / مسوّدة، الطائر، النّافذة، المريض رقم11 وغيرها/ أمّا قصّة خربشات على الجدار والتي يعتمد الكاتب فيها تقنيّةٌ فنيّة جديدةٌ، وإنْ كانت تجنح نحو أسلوبه المُعتاد في استعارة ذاكرةِ الطفل، فدائماً ما يستعينُ به ويغرفُ من ذاكرتِه الفطريّة الصّافية، قصصاً، جميلةً عابقةً بهواء الغابات، حادّةً كرملٍ الكتاحةِ، صافيةً كبياضِ قصره الذي بناهُ في ساحة القرية.
الجدارُ لوح ذاكرةِ البطل، يخطّ عليه ما يشاءُ، وبفطريّةٍ يرسمُ الصّراعَ من جديدٍ بأسلوبٍ آخرَ ونكهةٍ مختلفةٍ.
القصّة تعالجُ حالة الرّكود، والتعلّق بالغيبياتِ عند فئةٍ من النّاس، هذه الفئة ترفضُ التّغيير بل تعتبرهُ جرماً، يمسُّ كرامتها، فحبُّ أبيه للشيخِ “التّوم” مقدّس عنده، وقد أدمنَ زيارةَ ضريحهِ ذي البابِ الخشبيّ الثقيلِ، والقبّة المخروطيّة العابقةِ برائحةِ البخور.
كان الطّفل كلّما عادَ من زيارة الضّريح، يرسمُ أو يخططُّ ما توارد إلى ذهنهِ من مجرياتِ أحداثِ هذا اليوم..
” بابٌ تآكلت قائمتهُ السفليّة بسبب دودةِ الأرض، لن أحدّث أبي بهذا فسيغضبُ لأنّه يعتقد بقابلية الضريح لكلّ الأزمنة”
يطلبُ الأبُ بعضَ الحِجارةِ لتوسيعِ سور الضريح، بينما يظهرُ موقف الأخِ المُعارضِ قائلاً: إنّ حجارته لا تضرُّ ولا تنفعُ متى ستتغير.. من يومها اختفى أخي من مسرحِ الحياة ”
يقول الطفل: وجدت ُفي غرفة أخي أوراقاً مكتوبٌ فيها “القباب، تخلّفٌ، جهلٌ، هذه القرية مسرحٌ هزليّ، متى تستبدلُ هذه العقول الأثريّة بحاسوبٍ جديدٍ”
يشتغل الكاتب دائماً على متلازمةِ البيئة المكانيّة، فالمكان حاضرٌ، عنده بشكلٍ لافتٍ، يشكل عالماً مستقلاً، يأخذ منه حيزاً كبيراً في لغةِ الوصف.
ففي قصّة (طريق برليني) مثلاً يتطرّق إلى جدار برلين وحكاياتِ مآسيهِ، التي يعرفها الألمان، يتحدّثُ عن تجربةِ صديقهِ “شرودر” في عبورِ الجّدار الفاصل بين شطريّ المدينة.
في القصّة يقفُ وسطَ الشّارع، يرصدُ موقف الألمان من تفاصيل الحياةِ البسيطة مثلاً من مخالفةِ إشارةِ المرور، أو كيف تساوي هذه المدينة في نظامِها العام، بين ساكنها الأصليّ والوافدِ إليها، تصهرهُ في حبّها، تجعلُ سريرَ النّهر متكأً للعاشقين والحالمين فيها.
الأمكنةُ حاضرةُ كحيّ “كرويتسبرغ” ونهر شبريه Spree والمقاهي على كتف النّهر وسكك الحديد والقطارات،المحطّات الحدائق والتماثيل والجيرانُ، على اختلافِ نمطِ تفكيرهم، وجنسياتهم ومشاربهم الثقافية.
في قصص أخرى، يعمدُ الكاتب إلى تقنيّةٍ ذكيّةٍ فهو يسوقُ أحداثهُ مثلاً من المرآة أو لوحةٍ فنيّة رآها في مستشفى، أو معتقل، ثم يبدأ بتفكيك رموزِ الألوانِ والخطوطِ بقدرةٍ تحليليّةٍ فنيّةٍ إبداعيّةٍ عاليةِ الدقّةِ يمتزج فيها الأدبُ بالفنّ والفلسفةِ، كما في قصة (مُعتقل) أو في قصّة “انتظار” التي يحاور فيها لوحةً فنيّةً في المستشفى” على الجدار أطلّتْ لوحةُ لكاندنسكي، صرفتني بطلاسمها عن كلّ ما يدور حولي في غرفة الانتظار.. ها أنا ذا أتأمّلُ لوحتكَ مأخوذاً بألوانِها، ماذا تريد أن تقول..؟”
إنّ قارئ قصص أمير حمد ناصر يلحظُ مدى تأثّره بمعلّمهِ الروائيّ الكبير الطيّب صالح هذا التأثر لم يأتِ اعتباطاً وإنما شغفاً وحبّاً بالروائي المعلّم، كيف لا..؟! وقد درس الكاتب أعمال الطيّب صالح وتشرّب روحَ فكرتِها، وعرفَ سرّ النّبع الفنّي فيها.
نلحظُ ذلكَ من بابِ الوفاءِ للمعلّم، من خلالِ تكراره لذكرِ شخصيات رواية “موسمِ الهجرةِ إلى الشّمال” مثل شخصيّة “ودّ الرّيس” وشخصيّة “مصطفى السعيد” أيضاً، حتّى أنّه في قصّة (الطّائر) يحاولُ الاقتراب أكثر من روح الرواية.
فالطائر المُهاجر يحطّ قريباً من شرفتهِ، على شجرة الدّردار، و ينتظر أسراباً أخرى، لعله ضيّع الفصول فجاءَ في غيرِ موعدهِ ، بينما الصيّاد مهووسُ بالبحث عن البندقية لقنصهِ وأكله، في حين ينشغلُ الحيّ بأكملهِ بهذا الطائر، لا بل يصل الأمرُ إلى البوليس والصّحافة، في المساء يختفي هذا الطّائر ، ليكونَ مجرّد فكرةٍ عابرةٍ، خلّفتها تغيراتٌ بيئيّةٌ، مُناخيّةٌ وربّما جيوسياسيّة..
عالمُ أمير حمد ناصر القصصيّ، مشغولٌ دائماً بمحبّة بيئتين مكانيتين، الأولى أنجبتهُ ورعتهُ طفلاً، والثانية احتضنتْ شبابهُ، وساهمت في تشكيل وعيهِ ومعرفته.
في كلا المكانين تكوّن عالمهُ الإبداعي المتميّز، ليكونَ حالة إبداعيةً لها خصوصيتها في محطّة الإبداع العربيّة والألمانية.
يُذكر أنّ الدكتور أمير حمد حاصل على درجة الدكتوراه بدرجة الشّرف في الأدب العربيّ عن أطروحة ٍ بعنوان /أثر البيئة في أعمالِ الأديبِ الطيّب صالح/ وقد عمل مشرفاً ومترجماً في منظّمة حقوق الإنسان في ألمانيا، وكل كتبه صادرة عن مؤسسة الدليل للطباعة والنشر في برلين وهي رسائل من المنفى هجرة عكس الرّيح ومنزل تحت القمر ومساء متوتر على نهر هافل..