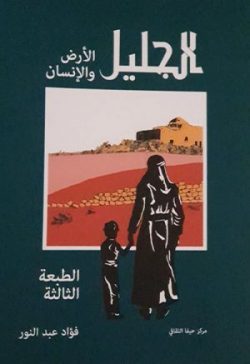الكواكبي أول من ربط بين التخلف والاستبداد
سعد القرش
في أوجز عبارة، لخص عبد الرحمن الكواكبي أسباب الانحطاط بكلمتيْ “الاستبداد السياسي”. جاء الرجل مطاردا من بلاد الشام، ونال في مصر حظوة رسمية وأهلية، وتمكن فيها من نشر ما لم يجرؤ على نشره في بلاده الواقعة تحت وطأة الاحتلال العثماني، كما كتب عمله الخالد “طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد”. كتاب يمنح مؤلفه أعمارا متجددة كلما وجد قارئا عربيا يحلم بالحرية، وإذا كان ابن المقفع يحيا بكتابه “كليلة ودمنة” فالكواكبي يكفيه هذا الكتاب، الأيقونة العابرة للأزمنة والأجيال والثورات والثورات المضادة، بوصلة معيارية يهتدي بها كلما قامت ثورة لا نطمئن لمصيرها، أو لاحت في الأفق ريح القوى المضادة للثورة. كأن الكتاب منشور ثوري ببرنامج للمستقبل خرج لتوه من المطبعة، ويستهدفنا هنا والآن.
أراد الكواكبي بكتابه تحرير الإنسان الفرد من أسر الدكتاتورية والخرافة والجهل والأوصياء وأي معتقد يسهم في النيل من حريته، وسجل في السطر الرابع من المقدمة أنه “مسلم عربي” هجر دياره، واتخذ في مصر مستقرا، “مغتنما عهد الحرية فيها”، فوجد لدى سراة القوم في مصر، وفي الشرق عموما وفي القلب منه العالم الإسلامي، أسبابا مختلفة للانحطاط، أما هو فبعد بحث دام ثلاثين عاما “تمحص عندي أن أصل هذا الداء هو الاستبداد السياسي، ودواؤه دفعه بالشورى الدستورية، فقد استقر فكري على ذلك”.
كان الكواكبي حاد البصيرة، وهو يضع أسفل عنوان كتابه هذا الإيضاح “وهي كلمات حق، وصيحة في واد.. إن ذهبت اليوم مع الريح.. لقد تذهب غدا بالأوتاد”.
توق إلى الحرية
تعامل الرجل مع الأشواق الإنسانية إلى استرداد الحرية بخيال شاعر، ولم يفرض على أحفاده وصاية، أو يورثهم يأسا وقع ضحيته آخرون رهنوا المستقبل بوقائع ومعطيات تبدو إزاحتها مستحيلة، ففي ظل احتلال مركب (تركي وأوروبي) لأغلب الدول العربية لن يرى اليائس أملا في الخلاص، أما الحكيم فيؤمن بأنه لا نهاية للتاريخ، ويعي أن للإمبراطوريات وللأباطرة والمستبدين دورة حياة لا بد أن تنتهي، وأنّ زادَ حياتها ينفد كلما ارتفعت درجة الوعي، ومستوى التعليم القادر على خلخلة أركان الاستبداد. وتوارثت الأجيال وديعة الكواكبي، وحافظت عليها، وفي كل جيل يستدعى الكتاب، باعتباره “الدليل”. وفي ميادين الحرية التي حملت لواء الثورات الشعبية، في مراحل البراءة في بدايات عام 2011، حضر “طبائع الاستبداد” ومؤلفه الذي ربح الرهان.
ولكن لبقاء قبر الكواكبي في مصر دلالة رمزية، واحتفاء مستمرا بعلامة ولد في التاسع من يوليو 1855، في حلب الشهباء التي كانت مركز ولاية عثمانية، ويرجع مؤرخون أصوله إلى الإمام علي. وفي سن السادسة توفيت أمه، وتولت خالته تربيته، وأتقن التركية والفارسية، فأتيح له الإلمام بالثقافة العصرية إضافة إلى المعارف الدينية. وفي سن العشرين عمل محررا في صحيفة “فرات” الرسمية الصادرة بالعربية والتركية، وبعد سنة صار محررها الرسمي. وفي عام 1877 شارك في إصدار “الشهباء”، أول صحيفة عربية في حلب، مع صاحب امتيازها هاشم العطار. وانتهج الكواكبي خطا إصلاحيا لا يخفي معه الإشارة إلى استبداد السلطان عبد الحميد، فقرر والي حلب كامل القبرصي إغلاقها بعد ستة عشر عددا.
وأسس الكواكبي عام 1879 صحيفة “الاعتدال” بالعربية والتركية، وسرعان ما أغلقت، فأمد بصره إلى آفاق أكثر اتساعا، وكتب في صحف عربية منها “النحلة” في بريطانيا، و”النجاح” و”المصباح” في لبنان، و”الأهرام” و”المؤيد” و”المنار” وغيرها في مصر.
وتقلد الكواكبي مناصب رسمية، فكان أمينا للفتوى، وقاضيا في حلب التي انضم إلى عضوية مجلس إدارتها، وتولى الخطابة والإمامة في مسجد جده أبو يحيى الكواكبي. واكتسب من جسارته خلال أعماله الرسمية عداوات الولاة ورجالهم المستفيدين من الفساد الإداري، وكان من الطبيعي أن يتعرض للمضايقة والعزل، واستقال ليتفرغ للمحاماة، كما سجن مرتين عام 1886، وقام الوالي عثمان الأعرج بتحريض طائفة من الأرمن فاغتصبوا مزرعته، حتى ضاقت عليه حلب، وأسر في نفسه رغبة الهجرة إلى مصر، واتخذها برغبة شخصية وتكليف من الخديوي عباس حلمي الثاني قاعدة انطلاق إلى رحلات في الجزيرة العربية والهند وبلاد المغرب. وأتاحت له صحف مصر نشر مقالات مناهضة للاستبداد، وإصدار كتابيه “أم القرى” عام 1900 وكان قد كتبه في حلب، و”طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد”عام 1900، وصدرت التعليمات السلطانية بمنع دخول الكتابين إلى الممالك العثمانية.
الكتاب الذي خشي الكواكبي أن يكون “صيحة في واد” ربما تذهب مؤقتا مع الريح، أشبه بقذيفة تعرف هدفها، ولا تتلكأ في الوصول إليه من أقصر طريق لإصابته، عبر مقدمة قصيرة، ومدخل عنوانه “ما هو الاستبداد؟”، وثمانية فصول هي “الاستبداد والدين”، و”الاستبداد والعلم”، و”الاستبداد والمجد”، و”الاستبداد والمال”، و”الاستبداد والأخلاق”، و”الاستبداد والتربية”، و”الاستبداد والترقي”، و”الاستبداد والتخلص منه”.
قدم المؤلف تعريفا لعلم السياسة بأنه “إدارة الشؤون المشتركة بمقتضى الحكمة”، أما الاستبداد فهو التصرف في هذه الشؤون “بمقتضى الهوى”، ويتجلى الاستبداد في تصرف فرد أو حكومة مطلقة بلا خشية من حساب أو مراقبة، كما يتحكم الأب والأستاذ والزوج ورجال الدين ورجال المال، وأشد درجات الاستبداد “حكومة الفرد المطلق، الوارث للعرش، القائد للجيش، الحائز على سلطة دينية”. وبعيدا عن قمة السلطة السياسية، فإن “من أقبح أنواع الاستبداد استبداد الجهل على العلم، واستبداد النفس على العقل، ويسمى استبداد المرء على نفسه، وذلك أن الله جلت نعمته خلق الإنسان حرا قائده العقل، فكفر وأبى إلا أن يكون عبدا قائده الجهل”.
ولا ينسى الكواكبي طرح هذه الأسئلة: لماذا يكون المستبد شديد الخوف؟ لماذا يستولي الجبن على رعية المستبد؟ بماذا ينبغي استبدال الاستبداد؟ ثم يترك الإجابة التي ستأتي في ثنايا الفصول.
وتبدأ المقدمة بهدوء عقلاني يطرح أرضية جاذبة للنقاش، وفي نهايتها يعلو الكريشندو الأخير، في جمل قصيرة عالية النبرة لا تحتمل التأويل، كأنه يتعجل إلقاءها قبل أن يغادر، إذ “لا شك في أن إعانة الظالم تبتدئ من مجرد الإقامة في أرضه”، وهذه الجملة تناسب عصر الكواكبي الحافل بثنائيات الرعايا والمواطنين، المعدمين الفقراء وملاك الأرض ومن عليها من بقايا الأرقاء رغم تحريم الرق. وليس متصورا الآن بعد هذا الشوط الحداثي، وصعود مفهوم الدولة الوطنية رغم جبروتها والطغيان العسكري أو العشائري أو الطائفي لحكامها، أن يغادر مظلوم “أرض ظالم”؛ فهي ليست أرضه، وكلاهما مواطن ولو نظريا بحكم “نص” الدستور.
الاستبداد والدين
يختتم المقدمة بخلاصة تنأى عن تقديم عزاء لمظلوم لأنه أيضا شريك في الظلم، “فلا يولى المستبد إلا على المستبدين، ولو نظر السائل نظرة الحكيم المدقق لوجد كل فرد من أسراء المستبدين مستبدا في نفسه، ولو قدر لجعل زوجته وعائلته وعشيرته وقومه والبشر كلهم، حتى وربه الذي خلقه، تابعين لرأيه وأمره. فالمستبدون يتولاهم مستبد، والأحرار يتولاهم الأحرار، وهذا صريح معنى “كما تكونون يولى عليكم”.
بدأ الكواكبي فصول كتابه بالدين، واستند إلى اتفاق أغلب الباحثين في تاريخ الأديان على أن الاستبداد السياسي ثمرة الاستبداد الديني، “ومن المعلوم أنه لا يوجد في الإسلام نفوذ ديني مطلقا في غير مسائل إقامة شعائر الصلاة… ولكن واأسفاه على هذا الدين الحر”، وقد أدى هذا التحالف إلى نتائج تتناقض وجوهر الدين، فالاستبداد في المسلمين “شوّش تاريخ آل البيت عليهم الرضوان”، كما يكرس كهنة المستبد خداع الشعب، ويجتهدون في تثبيت الأوضاع الظالمة القائمة، ويحبطون كل أسباب التمرد والثورة، بإيهام الناس بأن الاستبداد والفتن “قضاء جاء من السماء لا مرد له، فالواجب تلقيه بالصبر والرضاء، والالتجاء إلى الدعاء.. وليكن وردكم: اللهم انصر سلطاننا”. ولن يفيد الدعاء، فالاستبداد “داء أشد وطأة من الوباء، أكثر هولا من الحريق، أعظم تخريبا من السيل، أذل للنفوس من السؤال”.
القانون مقابل الطاعة
في ذلك الوقت المبكر، فرق الكواكبي بين دستور يفرض على الحاكم في الغرب “التزام القانون”، ويجعل المواطنين يمنون على حكامهم، في مقابل رغبة الحاكم الشرقي في إبقاء الرعية “على الانقياد والطاعة”، ومن هنا يحتاج الشرقيون “إلى حكماء لا يبالون بغوغاء العلماء المرائين الأغبياء، والرؤساء القساة الجهلاء، فيجددون النظر في الدين، نظر من لا يحفل بغير الحق الصريح.. والأمر الغريب، أن كل الأمم المنحطة من جميع الأديان تحصر بلية انحطاطها السياسي في تهاونها بأمور دينها، ولا ترجو تحسين حالتها الاجتماعية إلا بالتمسك بعروة الدين تمسكا مكينا، ويريدون بالدين العبادة. ولنعم الاعتقاد لو كان يفيد شيئا، لكنه لا يفيد أبدا”.
وفي رأي الكواكبي أن المستبد “فرد عاجز، لا حول له ولا قوة إلا بالمتمجدين”، وأن الاستبداد ليس قدرا، ويمكن الخلاص منه بوسائل دستورية وقانونية تتعلق بالفصل بين السلطات، وتحدد الحقوق العمومية والشخصية، ونوعية الحكومة ومهامها، ووسائل مراقبة أدائها، كل ذلك بعيدا عن الرهان على تدين الحاكم ووعده وعهده “ويمينه على مراعاة الدين، والتقوى، والحق، والشرف، والعدالة، ومقتضيات المصلحة العامة، وأمثال ذلك من القضايا الكلية المبهمة التي تدور على لسان كل بر وفاجر، وما هي في الحقيقة إلا كلام مبهم فارغ، لأن المجرم لا يعدم تأويلا، ولأن من طبيعة القوة الاعتساف، ولأن القوة لا تقابل إلا بالقوة”. ووضع ثلاث قواعد لرفع الاستبداد:
– الأمة التي لا يشعر كلها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية.
– الاستبداد لا يقاوم بالشدة إنما يقاوم باللين والتدرج.
– يجب قبل مقاومة الاستبداد، تهيئة ماذا يستبدل به الاستبداد.
فهل كان الرجل يتحدث عن العالم العربي في نهايات القرن التاسع عشر؟ أم عنا بعد ثورة تعرضت لكبوتين في مصر التي أقام فيها وصادق أعلامها. وقد تقرب إليه مثقفون أتراك زعموا معارضتهم للسلطان، ولكنهم رصدوا أحواله ورفعوا التقارير. وفي ليلة الجمعة 13 حزيران 1902، تناول في مجلسه مع أصدقائه السوريين بعضا من القهوة وفاجأه ألم في بطنه، واستند إلى ابنه كاظم عائدا إلى البيت، وتواصل القيء الذي انتهى بنوبة قلبية في منتصف الليل، وحين عاد ابنه بطبيب كان قد توفي ويرجح الكثير من كاتبي سيرته أنه مات مسموما.