قراءة في كتاب مسؤوليّة المثقف للمفكر محمد بن حامد الأحمري

تقديم/ د. عبد الحكيم شباط
يُبين المؤلف دوافع تأليف هذا الكتاب، بالآتي: “وعندما اخترت الكتابة عن مسؤولية المثقف أردت أن يكون الحديث عن واجباته، وعن الأشياء التي يُسأل عنها حاضرًا في حياته أمام نفسه ثم أمام مجتمعه وضميره، وهي في النهاية مسؤولية أمام ربه”. (ص42). فالذين يكتبوا، ويحاضروا، ويتصدروا المنابر في العالم العربي هذه الأيام كُثر، ولكن قلة من تلمس لديهم الإخلاص في الطرح النظري أو التطبيق العملي، وهذا الكتاب تخصص في إبراز المسؤولية والواجبات التي ينبغي أن يضطلع بها المثقف، ولو أن كل كاتب التزم بذلك، لشهدنا إرتقاء في مستوى المعرفة في الثقافة العربيّة، ولنرصد هذا الحوار الداخلي:
“عندما أتممت هذا النَّصّ فكَّرت حقًا في عدم نشره، كما فعلت مع نصٍّ سابقٍ له من طراز قريب تركته ليموت نهائيًا؛ وسبب ذلك أني أستحي من نفسي قبل النَّاس حينما أطالب بمواقف وأفكار وأحث عليها، ثُمَّ أجدني أعاني مما أعيبه على غيري، فما أصعب أن تطلب مِن النَّاس ما لا تفعل، أو تطالبهم بأكثر مما تقدر عليه” (ص9).
فالقيمةُ الحقيقية لا تكون إلا في عملٍ أخلصت فيه النوايا، وهذا ما يستديم أثره بين النّاس. ويزيد الكاتب هذا الأمر إيضاحًا، حين يسوق لنا اقتباسًا عن الفيلسوف ويليم جميس، بقوله أنَّ مسؤولية المثقف إنما تتمثل في “حماية المجتمع والدفاع عنه ونقد السُّلطة” (ص 91). فإذا صحّت النّوايا، وارتفعت الهمة، فلا ضير إن وقعت المثالب، فإنّنا قد جبلنا على نقصٍ يبتغي الكمال، “إن المثقفين الناقدين هم ضمير الإنسان المعاصر، والمذكرون بإنسانيته وإنسانية الآخرين من حوله، ويبقى النموذج مثقلًا بأخطائه وأنانيته وضعفه” (ص14). ولابد للمثقف من موازنة غلبة العقل والعاطفة، وأن تكون البداية من إصلاح الذات قبل التوجه إلى المجتمع.
أما المطلب الثَّاني، فهو الإنتماء إلى الثقافة التي يعمل فيها المثقف، لأن الاشتغال في ثقافة الغير يترك المثقف معظم الوقت على الهامش وبتأثير محدود، ويبقى نِتاجهُ -غالبًا- غير معترف به، بل يجعل منه –أحيانًا- أجيرًا تابعًا لغيره بما يخالف مصالح أمته ودينيه وثقافته، وقناعاته، كما حدث لبعض المثقفين العرب وكذلك لبعض الحكومات، عند نهاية الحرب الباردة، فيصف المؤلف حال هؤلاء: “ولما انتهت مواجهات المعسكرين استمرت الهامشية وفقدان التوجه لدى أتباع المعسكر الغربي ولدى الحكومات، فأصبح هؤلاء المثقفون الأُجراء جنودًا في إيقاع بلدانهم تحت احتلال غربي مقّنع، ويبيعون دورهم في سوق الغزاة من كل نوع ..”. (ص224).
لدينا اليوم أساتذة كبار في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وليسوا أقل قدرًا من علماء الغرب في شيء سوى أنهم يعملون على نظريات لا تنتمي لثقافتهم العربية، فهذا يعمل في نظريات علم الاجتماع الفرنسي وذاك الألماني، وغيره الروسي أو الأمريكي والبريطاني وغيره .. وهم بالنسبة للدراسات الغربية مجرد أشخاص تابعين، وليس لأبحاثهم قيمة تذكر لأنه يُنظر إليهم على أنهم مجرد شراح أو ناقلين أو باحثين ضيوف، وبالمقابل لا يتم الاحتفاء بهم في الثقافة العربية كعلماء لأنه ليس لديهم فرضيات أو نظريات تخص المجتمعات العربية أو الإسلامية بل هم مجرد أساتذة جامعات أو موظفين حكوميين أو باحثين في تخصصات غربية.
ثمّ لابد للمثقف من ملكات نفسيّة وعقليّة تؤهله لشغل هذا الدَّور، ويستشهد المؤلف برأي مُهم لمؤسس علم الاجتماع الألمانيّ ماكس فيبر، بأنَّ “المثقف هو من يحمل صفات ثقافية وعقلانية متميزة، تؤهله للنفاذ في المجتمع والتأثير فيه بفضل المنجزات القيمية الكبرى” (ص35).
وهذا يعني أنه ليس كل مشتغل في الشأن المعرفي أو الثقافي قادر على لعب دور المثقف، بل لابد من توفر شروط كثيرة في شخص المثقف وتكوينه وسوف يستعرضها المؤلف بالتفصيل في صفحات الكتاب، تحت عنوان جامع، هو “تكوين المثقف”، ومن أطرف ما نقرأه تحت هذا المبحث اقتباس يسوقه الأستاذ الأحمري، عن الدكتور شاكر مصطفى، في وصف حال بعض من يزعمون الثقافة في العالم العربي، بأن “أحدهم يقرأ في العام كتابًا ويتحدث عنه عامًا”. (ص49). ولكن في المقابل يوضح المؤلف بأنه لا يشترط للمثقف بأن يكون الأعلم أو الأفقه بل الأقدر على الاستجابة للموقف الثقافي المستجد، والأخبر في أساليب الوصول إلى أكبر الشرائح الاجتماعية والتأثير في الشأن العام، فإن تحقيق الانتشار والشهرة في الأوساط الشعبية للمثقف ليس بالضرورة أن تعكس قدراته العلمية أو المعرفية بقدر ما هو تملكه لأساليب التأثير والإقناع والتفاعل مع الأحداث المستجدة المختلفة، وبلغة المؤلف “والمثقف المؤثر اجتماعيًا يحتاج أن يكون له مزاج معرفي، وثقافة آنية تطلعه على ما يحدث، وله حس اجتماعي وعلاقة بالناس وشؤونهم، وعندما يضعف في جانب من الجانبين يظهر ذلك في كتابته وحديثه، وفي أي طريق يخاطب به الناس”. (ص51). ولذلك يصف الكاتب المثقف الشمولي الذي يبرع في تخصصه مع القدرة على الخوض في الشأن العام بأنه “المثقف العام”. مع التأكيد على أن نماء الثقافة ورواج المثقف يشترط تَوفر مساحة مِن الحرية “للحوار”، وبيئة ثقافية متنوعة بتنوع مخرجات الثقافة ذاتها، وتنوع مشارب المهتمين بها والعاملين بها.
ويعالج الأستاذ الأحمري بعمق ظاهرة “اغتراب المثقف”، والاغتراب هنا ليس بالمعنى الذي ناقشه سجموند فرويد (Fremdheit)، الغربة النفسية بين ظهراني العشيرة، بل بمعنى المثقف الذي يعيش في مجتمع غريب عنه –غالبًا- ثقافيًا ومكانيًا، وهي ظاهرة شديدة الأهمية، ويتناولها المؤلف من زوايا أكثر واقعية مما لمسناه لدى كُتَّاب آخرين، ولعلَّ الأبيات الَّتي يقتبسها عن المتنبي تشفي الغليل، وتلهب الحماس:
“ذراني والفلاة بلا دليل ووجهي والهجير بلا لثام
وما في طبّه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام
تعود أن يغبّر في السرايا ويدخل من قتام في قتام”
(ص85).
ومحاولة تأصيل هذه الظاهرة الملاحظة بشدة في ثقافتنا العربية منذ القدم، ويذكر لنا أمثلة من اغتراب ابن خلدون، وابن عربي، ومالك بن نبي، وأدوارد سعيد، والأفغاني، ومحمد أركون، وغيرهم، ويمكننا أن نضيف تجربة الأستاذ الأحمري ذاته ما بين أوروبا وأمريكا إلى تلك التجارب، وربما هي متأصلة منذ زمن ظاهرة “شعراء الصعاليك”، الذي عاشوا خارج قبائلهم، بل ربما منذ زمن غربة الأنبياء بسبب اضطرارهم للهجرة لمخالفتهم معتقدات أقوامهم، أو غربة الفيلسوف العربي- الآرامي “لوقيان” كما نجده في عمله “الأكاذيب والحورات”، في القرن الأول للميلاد، حين اضطر للعيش مكرهًا في روما حوال سبع سنين، وكذلك غربة الفيلسوف العربي- الأمازيغي “أفولاي” في عمله الساخر “الحمار الذهبي”، في حدود القرن الثاني للميلاد، حين اضطر للتنقل في بلدان عديد من روما القديمة إلى شرق آسيا، فظاهرة التغرب متجذرة في مجتمعاتنا وثقافتنا منذ القدم، ولعلها ظاهرة ترافق كل المجتمعات الإنسانية، لذلك تكلم الكاتب عن غربة كارل ماركس، وفولتير، وجاك دريدا، ولويس ألتويسر، ومحمد أسد، وغيرهم كثر، إلا أن غربة المثقف ليس كلها شرًا، بل هي تسهم في شفافية رؤيته لمشاكل مجتمعه الأصلي، وتعزز التزامه تجاهه، فهو يدفع نير الغربة وقسوتها بأن يجعل الثقافة وطنًا بديلاً له أو كما يقول المؤلف: “والمثقف المنفي قد تصبح الثقافة وطنه، وكما يصنع منها المقيم منزله فهو يجعلها الموطن والبيت” (ص83). والمثقف الملتزم بقضية أو بشأنٍ عام لابد من أن يتعرض لضغوطات متعددة تلزمه المواجهة وغالبًا الاصطدام بالسلطات القائمة سواءً أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو دينية أو سياسية، ولعل الأخيرة أشد خطرًا لأن الاصطدام بالسلطة السياسية قد يكلف المثقف الملتزم خسارة عمله أو حريته أو حياته أو ينفى خارج وطنه، إلا أن هذه المخاطر لا ينبغي أن تثني المثقف الملتزم صاحب الضمير الحي عن الإلتزام بموقفه النقدي، وفي ذلك يقول المؤلف: “إننا نطمح حينما نتحدث عن المثقف أن يعبر عن حاجات الناس ومآسيهم ومطالبهم وطموحاتهم (..)، ويكون هو أمينًا على سيادة الخير في المجتمع، عندما يكون المثقف حريصًا على إحقاق الحقوق، صادقًا فيما يؤمن به، محاولًا الخلاص من عيوبه وتحيزاته ومن جماعات الضغط عليه”. (ص102).
ونلاحظ أن الكاتب قد اتبع منهجية علمية، تذكرنا بمنهجية ماكس فيبر الصارمة في “بناء الأنماط المثالية”، وذلك من أجل إعادة ضبط تعيين مفهوم المثقف النموذجي، ثم تكوينه وتصنيفاته، وفاعليته، ومواضع ضعفه وقوته، والتزامه أو انهزامه، إخلاصه أو تزييفه، وما هي القضايا الكبرى التي تشغله، حيث تتقاطع الموضوعات العامة كالديني، والسياسي، والعلميّ، والعلماني، والاقتصادي، والإعلامي .. إلخ، وإمكانية الحديث عن قواسم ثقافة إنسانية جامعة في مقابل الثقافات المحلية، وما هي العلامات الفارقة التي تميز دور المثقف عن أدوار من يشاركه في تصدر المشهد العمومي كرجل الدين والسياسي والاقتصادي، وغيرهم، كما عالج العمل ظاهرة نفاذ التيارات الصهيونية ومن في ركبها في الدوائر الثقافيّة، وكذلك اختبار مصداقية مزاعم نهاية دور المثقف.
ونعلم أنه ثمّة أعمال كثيرة عالجت من قبل موضع الثقافة والمثقف، ولكن لعل ما يميز هذا العمل، على وجه الخصوص، هي أمور ثلاثة:
الأول أنه استوعب في لحائه وحواشيه معظم الأعمال السابقة عليه في الموضوع ذاته، واستطاع أن يهضم مادتها ويوظفها في متن العمل. والثاني أن العمل من أوله إلى آخر ينضبط بمنهجية علمية صرامة، واضحة، جعلت إمكانية تسلل الحشو أو الكلام المبتذل -الذي نلمسه في الكثير من الأعمال العربية- أمرًا ممتنعًا في هذا الكتاب، إلى درجة أن مادته، تقارب مادة كتب المتون المكثفة، أما الأمر الثالث، فهو أن هذا العمل جعل نصب عينيه تطبيق المقولات العامة على خصوصية الثقافة العربية- الإسلامية، ووضع المثقف، والتثاقف فيها، على نحوٍ يمكننا الزعم فيه بأن الكتاب يشكل مدخلًا منهجيًا تأصيليًا في موضوعه، وسيصعب مستقبلًا لأي باحث -منصف- أن يعالج إشكالية المثقف والثقافة في العالم العربي من غير أن يعود إلى هذا العمل.
ونختم بدعوة القراء والمشتغلين في الشأن الثقافي إلى الاشتباك النقدي مع مادة هذا العمل، من أجل تطوير مقولاته، ومفاهيمه، ونتائجه، واختبار مدى فاعليتها، ولاشك أن الحوار النقدي البناء، من اللوازم الجوهرية لتأصيل الطروحات والمشاريع العلمية الجادة.
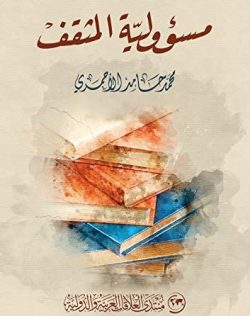
.







