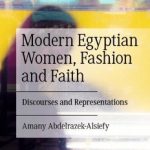الثنائيّات المُتناقِضة في رواية قارئِة الفنجان

للكاتب نذير حنافي العلي
موسى الزعيم
للوهلة الأولى وأنت تتأمل عنوان رواية نذير حنافي العلي (قارئة الفنجان) الصادرة حديثاً في بيروت 2021 أنك أمام عتبة نصيّة تستشرف من خلال عنوانها كُنهَ المحتوى أو كما هو متعارف عليه أنّك أسير الانطباع الأول وهو أنك أمام عرّافة تجلسُ على طرف الطريق، تلقي بأحجارها وتقرأ ” البَخت ” لكَ أو أنّك في حضرة امرأة تقلّب في يدها فنجان قهوتكَ وتتلو بدهشة عليكَ ما تخبئ خطوطَ البُنّ على صفحة بياض فنجانك، وربما يأخذك حدسك الأول إلى قصيدة نزار قباني وأنغام عبد الحليم في الأغنية المثيرة للشجن والجدل معاً .
لكن وخلال ثلاثمئة وخمس وأربعين صفحة وعبر سردٍ خفيفٍ بعيدٍ عن التعقيد والمعجميّة يأخذ بك حنافي العلي إلى أمكنة وأزمنة تداخلت بشكلٍ مكّثف، وهي لعبة أتقنها الروائي عبر متن صفحات الرواية.
يطرح الروائي أسئلته “الضدّية” في الرواية عبر ثنائيات، يلبسها ثوب الفلسفة، يحاول من خلالها الوصول إلى إجابات رغم تشعب الموضوعات التي تطرحها الرواية، إلاّ أن الكاتب استطاع مسك خيوط السرد عبر الصفحات من أولها إلى آخرها .
ومن خلال أسئلة تُقلق (جاد) الشخصيّة الرئيسة في الرواية وتدفعه إلى الارتحال عبر فضاءات وأمكنة متعددة، تبدأ من قرية نائية في بادية الشام على طرف الفرات، تقبع إلى جانب تلّ آثريّ يحوي مدينة “دورا أوربوس” لتتوزع عبر محطّات مكانية تطبعُ تأثيرها ” الأمكنة” في حياة جاد وتدفع به إلى خوض تجارب جديدة في مُدن عدّة منها دمشق، بيروت، وتونس، وباريس، إلى برلين والتي تدور فيها الأحداث الأهم من الرواية.
يُحاول جاد الفنان المُثقل بذاكرة مُتعبة، تحمل في طياتها الكثير من التناقضات التي صادفها، وأقول صادفها لأنّ جاد حسب سياق الرواية، لم يبدُ من ملامحه الزمانية أو الشخصيّة أنه بهذا السنّ الذي يمحنه الخبرة في الحياة، لتخوله أن يغدوَ فيلسوفاً، بقدر ما كانت الأسئلة تشغله كإنسان في مُقتبلِ العمر، يجهد في البحث عن تفسير لهذه الأسئلة والهواجس، يُفلسفها حسب مُعطيات ثقافته وخبرته الحياتيّة التي حصّلها من قراءاتهِ أو لاً وعلاقته بالطبيعة البِكر من حوله ثانياً، إذ لم يظهر المجتمع المحيط به مجتمعاً قابلاً لنقل المعرفة” على الأقل في زمن وعي جاد، يتعامل مع الموجودات المحيطة به على أنها أمرٌ مسلّم به واقعياً، لا يجهد في تفسيرها في ظلّ مناهج تعليميّة تلقينيّة في مدرسة لا يحبّها وجامعة حافلة بالتنظير، بخيلة بالفرص، وأسرة يعاني فيها الأب من انكساره واحباطه الحزبيّ ” البعثيّ” المعلّب نتيجة خطأ تافهٍ يجعله محطّ سخرية وتندّر الباقين.
وهذا لعالم المحيط بجاد مترعٌ بالمشهديات ” النهر، التل، حقول القمح ، الرعاة ” جاد الفنان الذي يدفع سفينة السؤال كلما أجبرتها المواقف على الانجراف عكس جهة الريح، ليتكشف أرضاً صُلبةً جديدةً يحاول النهوض والوقوف عليها من جديد، وهكذا كانت حياته، قائمة على هذه الثنائيات حياة سأم راكد.
جاد يستهويه الرسم، فيعمل في طفولته في منشرة للخشب، يجعل منها مَشغله ومَرسمه، هو يرسم لأنّه لا يملك سوى الرسم في هذا المكان .
يفسّر جاد تعلّمه للرسم، كصنعة في الصّغر، لكنّهُ يميل إلى الالهام ، يلجأ إلى الزوايا المُعتمة في الحياة ويعتمد على شاعرية الألوان، يتمثّل المقولة “الفن هو الكلام الذي لا ينطقه لسان” لذلك كانَ قليلَ الكلامِ كثيرَ الصمت والتأمل .
يعمل مرغماً مدرساً للرسم في مدرسة القرية، وفي المنشرة يعيد انتاج علاقته بالوجود، تتفتّق مُخيلته على الأسئلة الرعوية الأولى، عن الموت والحياة، وعلى كتفِ الفرات قريباً من التلّ يتفتح قلبهُ على الحبّ الأول لزينب، زينب التي تمسكُ فنجان جاد، تقلبهُ تُخبره بأنّه سيكون له معرضٌ خاصّ يوماً ما وتقترح عليه أن يُسمّي لوحاته الأولى قارئة الفنجان.
في الخط الثاني من الرواية ” آنة ” والتي ستسوقها الأحداث للقاء جاد في برلين يوماً ما، يسوق الراوي أحداث الرواية بخطوطٍ مُتداخلةٍ، عبر عدّة أزمنة، تتأرجح بين الماضي والحاضر والماضي البعيد أحياناً في محاولة لنبشِ المستور من سيرة حياة آنة وعلاقته بالحاضر، آنة ابنة الرجل الروسي الذي هجر زوجته في برلين، بعد انهيار جدار برلين، وأمها التي خالفت رأي أهلها وتزوجته، ثم سافرت الأسرة إلى فرنسا ومن ثم استقرارها في تونس ” فتغرق الرواية في سيرة حياة آنة وأمها وأختها وصديقتها سارة ، وحياة أسرهما والظروف والتداعيات التي أوصلت كلّ منها إلى نقطة اللقاء، لقاء جاد بآنة” رسم الراوي علاقتهما كحبيبين في برلين، هذا الحب الذي يرى فيه جاد أنه” يستطيع وحده ملء الفراغات الكبيرة التي لا يمكن معرفة حجمها “
ومن ثم راح يعيد فكّ شبكة الأحداث أولاً بأول مستلماً زمام السرد بدل الشخصيات أحياناً .
جاد الذي جاء إلى بيروت للمشاركة في معرضٍ فني، إلاّ أنّ حظّه يقوده إلى منظمة تنقذُ الفنانين المهددين من الحرب الدائرة في سوريا، وينجح في الوصول إلى برلين، كفنان مطلوب منه بطريقة أو بأخرى أن يرسم علاقة الفنّ بالحرب، وتدور حياته في منحنيات الروتين في ألمانيا و علاقته بآنة، ويمرر من خلال ذلك أحداث الثورة التونسية، يحاول إعادة رسم ملامح ” البوعزيزي” في محاولة منه لإعادة فهم ما حدث، أمّا الثورة السورية يتحدث عنها من وجهة نظره كفرد، وليس من جهة تداول المفاهيم ،التي قامت من أجلها، فـ”ورد” أخت آنه مثلاً تحاول أن تجعل من الثورة التونسية سَبقاً صحفياً على صعيد التقاط الصورة الصحفية، وتجاريها آنه في ذلك، في حين أن جاد لم ير من الثورة سوى الخراب الذي حلّ بين دمشق ودير الزور، والتداعيات في دمشق على حواجز النظام في طريق سفره مع لوحاته إلى بيروت، ومن بعدها الصور التي تتوارد إلى ذاكرته بخراب التلّ وهجرة الفلاحين وتصحّر القرية، بالمقابل لا يفتأ بين الحين والآخر في الحديث عن سلطة البعث التي مهّدت لحكاية الخراب القادم مُحملاً هذه السلطة ما آلَ إليه المجتمع السوري، لعلها بداية أحدوثة الثورة في سوريا لم تختمر في ذات جاد بعدُ كفنّان، فقد ظهر تفاعله مع الحدث خجولاً ،فكان كمشاهد راصدٍ يُحاول عدم الخوض في تفاصيل الدم .
فجاءت شخصيته مُثقلة بهواجسها الفنيّة والفكرية، وتفلسف الواقع ضمن إطار لوحة فينّة فيها ما يخصّ روح هذه الشخصية، أو كما وصف نفسه ” رسامٌ يبددُ الوقت، يتعلّق بلوحاته مثلما يتعلق بوطنه” الذي يحتفظ له في ذاكرته بثلاث صورٍ وهي ما بقي عالقاً منه في رأسه ( التلّ ، والده ، المدرسة) ثلاثة رموزٍ لو تم ّتفكيكها لكانت سيرة حقيقية لوطن جريح، خبره جاد عن قرب.
الثنائيات المتضادة
يرى الراوي أنّه ” لفهم فكرةٍ ما علينا أن نفهم نقيضها، جاد الذي وقع أسيراً لفكرة التضاد هذه، لا يعرف كيف يتخلّص من كونه جزءاً من ثنائية أو ضداً لشيء“
فاللغة التي يقوم عليها إيقاع الكون مليئة بتلك المفردات المتضادة ،التي تغزو حياتنا، ويمكن الاستدلال عليها بشكلٍ واضحٍ في أي كتابٍ مقدّس، وهنا تسأل نفسكَ أيهما أسبق العذاب أم الرحمة؟ الايمان أم الكفر ،وعليه تنسحب متوالية التضاد عبر متون الرواية، فالضوء والظلام، الأبيض والأسود، الأرواح والاجساد الايمان ، أو القُبلة والبصقة.. هل يظهر الحبّ في القرب أم البعد ؟ السحر والجمال في صورة الأطفال الفقراء .. وغيرها ..
أمّا بالنسبة للفنّ فكانت الفكرة أولاً: كيف لجاد أن يعبّر من خلال الألوان عن فكرتين متناقضتين” راح يجسّد الموت بقعةً بيضاءَ والخلفية سوداءَ؛ وهي الحياة ” من خلال ذلك يسعى إلى قلب المفاهيم، ليس في إطار ثورة، وإنما من جهة محاولة الفهم لما يحدث.. وإقلاق الساكن، وتحريك الراكد من حوله.
من هنا نفهم لماذا عمد الروائي إلى تقسيم روايته إلى تسعة أقسام، أطلق على كلّ قسم عنواناً مختلفاً، إلاّ أنها تشترك أغلبها في قضيةٍ واحدةٍ، وهي النزوع نحو الفلسفة، والأقسام تدور في فلك تلك الثنائيات، فجاءت كما يلي “الحلم واليقظة ، الحبّ والرسم ، الأرواح والأجساد، الوعي والذاكرة ، الانسان والفن، الانسان والتاريخ، الانسان والذاكرة، البكاء والضحك، الانسان والخوف “
جاد الذي يتعامل مع ما يراه من خلال أسئلة يطرحها على ذاته، أسئلة تتعلق بالإنسان والوجود وحسب رأيه ومن له الحق أن يسأل أكثر من الفنّان، ليسأل ما هو الموت ؟ أو أيهما أكثر رجفاناً أمام الموت ؟ العقل أم الجسد البشري ؟
التعامل مع التاريخ:
تسلط الرواية الضوء على قضية لها أهميتها في الأرض السورية، وهي قضية التعامل مع الآثار أو المكتشف الأثري، يرصد الراوي علاقة سكان القرية مع ” دورا أوربوس” أو تلّ الصالحية واللّقى واللوحات المُكتشفة فيه، فقد تحدّث عن تلك العلاقة من ثلاثة محاور :
الأول: ما يُنسج حول تلك الأمكنة من أساطير وخرافات، لا تمتّ للواقع بِصلة والتعامل مع هذا التلّ على أنّه المكان الموحش الغامض، أمّا الثاني فعلاقة النظام والحكومة بالتلّ، فمدّرس التاريخ إسماعيل مثلاً في القرية لم يكلّف نفسه قراءة تاريخ جارهِ التلّ، لأن ذلك لم يخطر على بال المناهج التعليمية يوماً، أو لم يكن من ضمن اهتماماته الشخصيّة، بينما الثالثة فهي السلطة والمتمثلة بشخص مدير الناحية هي إبراز منجزات القائد الخالد، واهتمامه بالتاريخ والأثار، وكأن التاريخ يبدأ ويتوقف عند إنجازه، واهتمامه وماعدا ذلك فمحض ثرثرة يعاقب عليها المرء، والمضحك أن من توّلى شرح تفاصيل وتاريخ التلّ هي (صوفيا) الفرنسية القادمة مع الوفد السياحي؛ صوفيا التي هجرت العيش في فرنسا وسكنت القرية إلى جانب التلّ إلى حين ضَجِرت واكتشفت رتابة الحياة، فسافرت مع اسماعيل باتجاه صخب باريس . تبدو المقاربة مُدهشة في مكان وجود التلّ إلى جانب المسلخ، وما يُذبح فيه من ثيران، وخيط الدم المُتسرب عبر قناة الفضلات إلى الفرات ،أعتقد نجح الروائي في مدّ رمزية خيط الدّم وإحالته إلى المغول “مغول العصر” فالتلّ هو مكتبة الأمة العامرة بما تحويه من أوابد، وتسرب الدم إلى النهر ما هو إلاّ نذير شؤم .
الحَكايا في متن الحكاية:
في رواية “قارئة الفنجان” الراوي مشغولٌ بالقصّ، و بتفريغ ذاكرته من حمولتها، تسكنه حكايات الأمكنة التي مر بها، لعلها تحوي إجابات عن أسئلته، يتوقّف عند حكاية صراع الانسان مع العِجل، حكاية السعلّوة التي تخطفُ من يمرّ ليلاً قرب النهر، وما تبعها من أساطير رافدية، عن مملكة العالم السفلي ” ارشكيجال ” و رسائل إخوان الصفا في فلسفة الحركة والسكون ، و وقوف جون كنيدي في برلين ومناداته “Ich bin Berliner” إلى حكاية الشاعر نزار قباني مع الفنان عبد الحليم حافظ حول قصيدة قارئة الفنجان، ومادر حولها من نقاشات، إلى قصة الفنان لؤي كيالي واحتراقه مع لوحاته في ظروف غامضة، وغيرها من الحوادث والقصص التي لم تمرّ اعتباطاً في متن السرد، بل استطاع الروائي توظيفها في السياقات وإن كانت في بعض الأحيان تستهلك حيزاً كبيراً من صفحات الرواية وتعطل الحدث الرئيس فيها ، مما جعل الراوي أحيانا يتدخل بشكلٍ مباشرٍ في توجيه القارئ كقوله “كما جاء في بداية الرواية” ص263 حين يستشعر أن القارء تسربّت من بين يديه الأحداث.
جاءت لغة السرد غزيرة سهلة، خالية من أي تعقيد، إلاّ أن الراوي يعمد في بعض الأحيان إلى تكرار الجملة في ذات المعنى أو المعنى المشابه، لكن بشكل مُختلف في ذات السياق، ومن المتعارف عليه أن التكثيف في اللغة أحياناً يعطى الجملة مساحة أكبر للتأويل ويعطي الفرصة الأكبر للقارئ للحفر في متون السرد.
تأتي رواية قارئة الفنجان، بعد روايته الأولى” فضاء بلا نوافذ “الصادرة باللغة الألمانية
* نذير حنافي العلي روائي سوري يقيم حالياً في ألمانيا
.
.