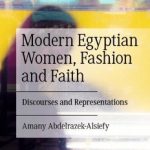إشكاليّة التوثيق الحكائيّ والتصنيف الأدبيّ في رواية “رغيف التنّور” لـ “نزيه مير علي”

موسى الزعيم /
انحازت الرواية العربيّة المكتوبة في أوربا إلى القضايا الشاغلة، صارت على تماسٍ مباشرٍ معها وخاصة فيما يتعلق بقضية اللجوء والحياة في أوربا، وجدت الرواية أبواباً جديدة مستحدثة، تطرقها من جهة الموضوعات الساخنة أو طريقة معالجتها لتلك القضايا لكن يبقى هاجسها الأول ما يحدث في الشرق أو الوطن الأم.
ساهم ذلك في توسيع الدائرة التي تغطيها الرواية وتشغل مساحتها إنسانياً وبيئياً وبالتالي فهو إغناء للأدب العربي من خلال توسيع آفاقه، خاصة وأن الكثير من هذه الأعمال الروائية قد أخذت طريقها إلى الترجمة.
ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة أنّ عدداً من كتاب الرواية و- خاصة كتّاب التجربة الأولى- ما يستندون إلى مخزون الذاكرة، يعوّلون عليه في بناء رواياتهم، إذ تجد أن قسماً من هذه الروايات صار شاغلها الأول المقارنة بين بلاد المهجر وبين الوطن، بين عالم جديد متسارع لم يألفه الكاتب، لم يستطع الاندماج فيه، أو مقاربة الموضوعات التي تشغل المجتمع الجديد، فيغدو نكوصه باتجاه الذاكرة باعتبارها الفعل الماضوي الثابت والذي غالباً ما يرتاح إليه وكثيراً ما يعفيه من إعمال مخيلته الأدبية من خلال الاسقاطات والرمزيات وغيرها، يمزج ذلك كلّه بحنينه إلى هذا الماضي فيكتب بلغة المشتاق معولاً على ما في نفس القارئ أحيانا أو على التجارب المشابهة التي يعيشها المجتمع أو ربما يكتب أيضاً بلغة المتحسّر على ذلك الماضي إن كان سلباً أو إيجاباً .
من هنا يمكن قراءة العمل الأدبي (رغيف التنّور) والذي مُهر غلافه بـ رواية قد صدرت مؤخراً في ألمانيا للقاص السوري نزيه مير علي .
رغيف التنور تتخذُ من حكايا البيوت الريفيّة القديمة في محافظة حماة السورية بيئة سرديّة لها، يأتي ذلك من خلال ذاكرة طفلٍ يعي تفاصيلَ معاناة أسرته، ويخزّن في تلك الذاكرة الكثير منها، وقد جاء الوقت ليفرغ ما فيها، ثم لينظر إلى تلك الذكريات عبر بُعدٍ زمني قاربَ الستين عاماً، بل أكثر، بعد أن غدا بعيداً عن وطنه، هاجر إلى ألمانيا ولم يحمل معه إلاّ تفاصيل عمر طويل فيه الحلو والمرّ رغم أنّ الشقاء الإنساني هي السمّة الغالبة لشخصيات الرواية.
ترصد الرواية حالة أسرة الراوي وتنقّلها من بيت إلى آخر من خلال رصد ظروف وأسباب هذا التنقل فلكلّ بيت سكنته الأسرة حكاية مع مالكه، وجيرانه، ومهنة الأب، والتّنور وغيرها من القصص الشيقة الأليفة إلى القلب، أمّا رغيف الخبز فله حكايته التي يرويها السارد ويرصد لنا تطورها عبر الزمن هذا الرغيف في انتقاله عبر التنور ثم إلى فرن الحيّ وما رافق ذلك من حكايا واعتراضات ومواقف.
تلك الحكايات يوثقها نزيه مير علي من خلال سردها على ألسنة عدّة رواة، يتغير فيها الراوي بين الحين والآخر، فالأم تروي لابنها في سهرات المساء حكايات وقصص عانت منها الأسرة قبل ولادته.
هذه الأسرة الريفية البسيطة التي تعيش في بيئة جبلية في مجتمع أقرب إلى المجتمع القروي القريب من البادية، تعاني من شظف العيش في مراحل ُمتعددة لأسباب تتعلّق بالوضع العام في البلاد إلاّ أنها كانت دائماً تجد الحلّ في إيجاد لقمة عيشها بطريقة كريمة، فالأب يعمل في المرحلة الأولى لحّاماً “جزار” من خلال تلك المهنة تروي الأم قصصاً مختلفة عن مهنة الأب، تسرد لطفلها القابع إلى جانبها بعض هذه الحكايا وما رافقها من طُرف ودعاباتٍ مرّت، بعد ذلك يعمل الأب في شركة للنفط في البادية السورية، هنا تبدو المفارقة الطريفة في اللغة بين اللحّام أي الجزار واللحام الرجل العامل في مجال التعدين و لحام الحديد، لكن الأب الباحث عن لقمة خبز شريفة، يقنع ربّ العمل بأنّه يعمل في مهنة من أجل إطعام أطفاله الستة، الأب المتمسك بعنفوان شخصيته، يربح قضيته ضدّ الشركة التي عمل فيها ويحصل على مبلغ ماليّ جيد يعينه على استمرار حياته بما يحفظ ماء وجهه، بعد ذلك ينفرط عقد الأسرة من بين أصابعه حين يهاجر أبناؤه إلى بلدان الخليج العربي للعمل هناك، كانت أمنيته أن يراهم قبل موته يزورهم في مغتربهم، يطمئن عليهم جميعاً ليعود ويسلم روحه إلى بارئها.
تبدأ الرواية بعنوان فرعي لمقطع قصير هو ” البيت الخامس ” كان الأب قد تشاجر مع أصحاب البيت السابق، كان البيت الجديد أكثر سماحة “شرح برح” أوسع، التنور قريب منه وهذا الأهم في الحكاية نوافذه من خشب السنديان وله فتحة سماوية تسكنها الشمس، الغرف مشيّدة من الحجر النافر المنحوت، في باحته شجرة مشمش وشجرة دراق ..
ترصد حكايا البيت الخامس قصص مشاحنات النساء على تنور الحيّ التي تصل في الغالب إلى حدّ الاشتباكات.
وهنا يرصد الراوي خوف الزوج على زوجته من دخولها تلك المشاحنات والقيل والقال، تتبدى الرجولة والشرقية بوجهها الجميل من خلال شخصية الأب الحامي و الخائف على عرضه والضابط لإيقاع حياة الأسرة. يجد الأب حلاً لتلك المشكلة، إذ يبني لزوجته تنوراً خاصاً بها على سطح المنزل، يُبعدها فيه عن مشاحنات النسوة، ولتكون فيه سيدة نفسها، تكسب ودّ الجارات حين تدعوهن إلى الخَبز على تنورها.
أمّا عن صورة تلك المرأة الام فيقول الراوي
“هذه الأم كغيرها من أمهات ذلك الزمان، لم تكن مناضلةً في حزبٍ ثرثارٍ، ولا خريجةَ مدرسة أو جامعة .. مدرستها وجامعتها بيتها، وحزبها زوجها وأولادها، كانتْ مسالمةً فيما تفكر أو تفعل تعرف من الحبّ ما يكفيها وزوجها.. “
فيما بعد ينتقل المجتمع إلى ثقافة “خبز الفرن” كان من المعيبِ أحياناً أن تعتمد على ذلك الخبز، لعلك تُتهم بالتّرف أو الكسل وربما بالتبعية للغرب، وهنا يأتي دور أحد أبناء الأسرة وهو المكلف بإحضار الخبز من الفرن وما يرافق ذلك من معاناة في الاستيقاظ باكراً والتدافع بين الأجساد الضخمة ومن ثم متعة الوصول إلى الكوة ورؤية الفرّان ” هذا بحدّ ذاته كان انجازاً عظيما” ومن ثم الحصول على الرغيف، كل ذلك كان يرافقه قصص طريفة أحيانا ومحزنة، في كثير من الأحيان في بلد يمتلك أفضل أنواع القمح في العالم وبين التقتير الذي تمارسه السلطة على أبنائها، فيما بعد يتحول فرن الحي إلى صناعة الكعك.
تنتقل الرواية إلى رصد أحداث صغيرة لكنّها تحفر عميقاً في الوجدان خاصّة وجدان الأطفال من تلك القصص محنة شراء بنطال العيد أو الحذاء وغيرها من القصص التي تبدو عادية في حياة هكذا أسرة إلاّ أن لها الأثر البالغ في حياتها..
تلك الحكايا، يأخذ الراوي خلفياتها من خلال عددٍ من الشخصيات التي يظهر تعاملها السلبي أو الإيجابي في الحياة، بين بائع يَعرف الوضع الماديّ للأسرة فيمهلها بثمن ألبسة العيد للسنة القادمة، وبين نموذج آخر يعمد إلى ” الاحتيال ” كما حدث مع صاحب أحد البيوت الذي كانت تستأجره الأسرة، فينما كان يُصلح مِدخنة الحمام ويشرب الشاي مع الأب، يقرع الشرطي الباب يحمل إنذاراً بإخلاء البيت، فقد دبّر صاحب البيت ذلك سراً وهذا ما لم يقبله رئيس المخفر كنموذج للفرد الإيجابي الذي يقف عند أخلاقيات وضوابط المجتمع، ليس بمسماه الوظيفي وإنّما بشهامته.
تتوالى حكايات البيوت على لسان الأم لابنها، إلاّ أنّ الطفل الذي غدا شاباً، أوقف دراسته الجامعية وانتقل مباشرةً إلى العمل مع إخوته في الخليج.
هنا تأخذ الرواية منحاً سردياً آخر، ‘ذ تنقل عدسة رصدها، باتجاه بيئة الصحراء في الخليج وصعوبة العمل فيها ومشقته وخاصة في الطقس الحار.
فتتبدل الشخصيات المحيطة بالراوي، فنرى العامل المصريّ والخليجي و جنسيات أخرى، تتشابك خيوط الرواية، فتضيع الفكرة من بين يدي القارئ أحياناً مع توالي ظهور شخصيات جديدة.
على العموم يصير الخبز سهلَ المنال في تلك البلاد، تطلبهُ متى تشاء، إلاّ أنه سيغدو معجوناً بقهر انساني من نوعٍ آخر، يصير مغمّساً بالزيت والنفط.
تنتهي الرواية بهجرة أفراد أسرة الراوي تباعاً إلى أوربا، واستقرارهم فيها بعد الثورة وبعد قمع النظام السوري للحراك السلمي، يبقى بيت الأسرة وحيداً، ينتظر من يلقي عليه نظرة ولو بعد حين.
– إنّ القارئ لرواية رغيف التنور، يلحظ الحشد الكبير للقصص التي تمر عبر صفحاتها وكذلك الشخصيات الكثيرة التي تناولتها، والفضاءات المكانية التي تنقّلت فيها، وكيف كان الراوي ينقل عتبة السرد عبرها.. ثم ليعود إلى المكان الأول، هذا الانتقال ” بين هنا و هناك ” كان ايقاعه سريعاً يربك المتلقي، خاصة وقد تتشابه بعض الحكايا والشخصيات المعنية فيها.
كان هناك الكثير من القصص والحكايات التي مرّت في حياة الراوي والتي كان حريصاً على نقلها بالتفصيل، يُشعركَ وكأنّه ملزم بتوثيقها و تدوينها، كما في قصّة الجاموسة وقصة العجل وغيرها والتي عاصرها أو سمعها أو رويت له، بعضها يحمل سخريّة مرّة تعكس الواقع و المجتمع.
بالتأكيد ما من قصة ألاّ ولها هدفٌ أو مغزى أقلّه المتعة، أمّا أن تصير هذه القصص فائضاً على بنية العمل الأدبي باعتقادي هذا ما يبعده عن سياقه كـ”رواية” أو بمعنى آخر هذه السياقات السردية المتراكمة أبعدت العمل الأدبي عن بنيته الدرامية وقربته إلى حالة المذكّرات الشخصيّة، خاصة أنها استدعت التاريخ لكنها لم تقم بمحاكمته أو لم تُقم مصالحة معه أو حتى الانقلاب عليه، كان ذلك السرد لمجرد نقل صورة الواقع في تلك البيئة وفي فترة زمنية طويلة نسبياً ولسان حال الراوي يقول: هكذا كنّا نعيش في يومٍ ما.
من جهة: أخرى كان الراوي أمينا للواقع، وهنا يُحسب له هذا الجهد الكبير في توثيق هذه الحكايا لأفراد أسرته وقد كان مشغولاً بهم، هو معني بالدرجة الأولى بمصائرهم وخلاصهم الفردي أكثر من الخلاص الإنساني أو التحرر الاجتماعي .
– البناء الهيكلي للزمن العام في الرواية واضح تماماً، منذ تشكل وعي الطفل الراوي إلى شبابه وخلاصه من الخدمة العسكرية ومن ثم سفره إلى الخليج ثم هجرته أخيراً إلى أوروبا، الأحداث التي مرّت بها الأسرة قبل ولادته أو لم يكن شاهداً عليها روتها له أمه.
– كُتبت الرواية بلغةٍ بسيطةٍ، أقرب إلى اللغة المحكيّة، اعتمد الكاتب فيها على مستويين لغويين، الفصحى واللهجة العامية والتي اعتمدها السارد كثيراً في حواراته، فنلحظ عدداً كبيراً من المقولات والعبارات والأمثال الشعبية والحوارات الطويلة والتي استقاها من البيئة التي نقل منها حكاياته، سواء بيئة القرية، أو البيئة المصريّة، أو الخليجية، أو غيرها.
– فيما أرى أنّ الكثير من هذا الاتكاء على اللهجات العامية المتنوعة، شكّل عبئاً على العمل الأدبي.
إذ عادة ما يتمّ توظيف تلك السرديات القصيرة في المتون لدلالة معينة تكون أحياناً مؤشراً على انتماء تلك الشخصيات لبيئتها المحلية فتعمل الجملة المحكية أو المثل الذي يتم تضمينه على أنه تأكيد لانتماء هذه الشخصيات لتلك السرديات المتداولة في البيئة التي تعيش فيها، ومن خلال ذلك هناك عدد لا بأس به من الكلمات والعبارات مغرقة في المحلية يُشكل على القارئ فهمها.
على سبيل المثال بعض الكلمات التي لم أجد لها تفسيراً معجمياً مثل “زخمني، قاشر، نعفاً، يقصح، هبيش ” وهنا أقف عند استخدامه كلمة (الملالة) فإذا كان يقصد بها ما تلبسه المرأة فهي المعروفة بالشامية ” المِلاية ” أمّا الملالة فلها معنىً آخر تماماً.
مع ذلك ففي كثير من مقاطع الرواية تجد سرداً أدبياً – بالفصحى- مشغولاً بدقّة وعناية، تتمنى لو أنّ بقّية المقاطع سارت على هذه الوتيرة.
على العموم لم تطرح “رواية” رغيف التنور الأسئلة، ولم تقف عند القضايا الإنسانية الشاغلة في الوقت الحاضر بقدر ما كانت معنيّة بتصفية الحساب مع الذاكرة.
فما بين دفتي الكتاب وثيقة سردية لها أهمتها وخصوصيتها وقد أحسن الكاتب في تدوين تلك السرديات، أمّا من جهة تصنيف العمل على أنّه “رواية” فالحكم متروك للنقد.
نزيه مير علي كاتب سوري مقيم في برلين
.