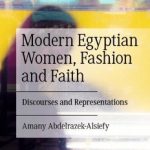لماذا عُدتَ.. ؟!

موسى الزعيم /
قصة قصيرة
“كانتْ أمّي تُكررُ على مَسامعي.. على قدّ بساطكَ مُدّ رجليك ..آهٍ يا أمّي بِساطي الصّغير بقيَ تحتَ أنقاضِ بيتي والرّصيفُ صار أطول”
ما الذي أتى بكَ ؟
سنواتٌ طويلةُ وأنا أبحثُ عن خيطٍ يوصلني إليكَ، أو خبرٍ يتعلّقُ بكَ، حتّى لو كان سراباً.!
في هذهِ الأوقاتِ العَصيبةِ، حَمدتُ الله أنّ كلّ من أحبّهم، ابتعدوا عن دائرة الخَطرِ، فالـــعائدُ إلــــى أرضِ الوطنِ، كمن يعبثُ بمصيرهِ.
اليومَ على غيرِ المتوقّع تقفُ أمامي بلحمكَ ودمكَ…!
غرغرةُ الدّمعِ فضحتْ مكنونَ أشواقنا .. تعانقنا بلهفةِ كلّ مشتاقِي العالم ..
قلتُ لكَ: ما الذي جاءَ بكَ…؟
فالوطنُ تحوّل حسبَ قانونِ الحربِ إلى عاملِ طردٍ، لا استقطابٍ، أغلبنا ميّتون ولو معنوياً.
لمحتُ عينيكَ تبحرانِ نحوَ الأشجارِ والأبنيةِ، تراقبُ عصافيَر الدّوري على أسلاكِ الكهرباء.
فعرفتُ أنّه الحنين.. وأدركتُ أنّه مثلُ لجّةِ الماءِ، يشدّنا إليهِ.. يدورُ بنا في زوبعتِهِ، حتّى نغرقَ، وليس لنا إلاّ الانصياع .. الحنينُ أقوى منْ كل ّ منبّهاتِ العالمِ.
تصفعُني إجابتكَ حينَ أسألكَ عن العجوزِ أمّكَ، وعن أبيكَ المريضِ، لكنّ ردّك أقسى من حجرِ “المَرْزين”
لم أتواصلْ معهم …! لا أعرفُ شيئاً عنهمْ منذُ سنوات…!!
أحسستُ أنّ حَجراً ثَقيلاً سَقطَ في جوفي..
ـ حسناً و أخوتُكَ…؟
تجيبُ بنبرةِ الواثقِ :
” ما بدّي حَدا “
أنظرُ في وجهِكَ، فيَجرِفُني تيّار الحنينِ إلى الّذكرياتِ، لكنّ شيئاً يوقظني منْ شُرودي.. ربّما جَفافُ كلماتِك وخلوّها من معاني الألفةِ.
ـ ماذا تفعلُ هنا ؟!
ـ جئتُ معَ أسرتي، والآنَ أُنهي أوراقَ عودةِ زوجَتي إلى العمل، والأولاد إلى المدارسِ، سأسافرُ وحدي هذهِ المرّة..
ـ وكم ستطولُ إقامتكَ هنا ؟
– لا أعلمُ.. عندي الكثير من الأعمال، التي يجبُ أن أنتهي منها قبلَ سفري..
– لا تقلقْ سأتولّى مساعدة زوجتِك و أولادك هنا..
يعاودنُي الحنينُ إلى الحديثِ عن الماضي، تمتدُّ يدي إلى حقيبتي فأُخرجُ مَخطوطَ روايتي.
تفَضّل، هنا دوّنتُ بعضَ ذكرياتِ ماضينا، ذكرتُك بين شخصيات الرواية.
اقرأْ وستعرفْ.. لكنْ للكتابةِ بقيّة.. ربّما تكتملُ بحضوركَ.
تقتُلني لامبالاتكَ، حتّى أنّك لم تقرأ العنوان، لم تُعِرْ انتباهاً لشيء.. تتعمّدُ تغييرَ الحديثِ، كلّما حكيتُ لك عن أهلنا و الذكرياتِ…
أحسستُ أنّ الأسئلة تَهربُ من بينِ شفتيكَ.. ومن بابِ المُجاملةِ ..سَألتني ” كيفَ حالكَ…؟ ” هل ما زلتَ تسكنُ في البلدةِ ؟
لا يا صديقي دُمّرَ بيتي، وانتقلتُ إلى هنا إلى المدينة، سكنتُ في قبوٍ حتّى هيّأ اللهُ لي بيتاً عندَ ناسٍ طيبين.. أجورُ السّكنِ هنا خياليّة.. يبدو أنّ النّاسَ صاروا يستثمرونَ في مأساةِ بعضِهم.
وقفتَ لتغادرَ.. وقلتَ وأنتَ تهمُّ بالخروجِ.. نلتقي.. ومضيتَ .
مرّت أيامٌ.. اتصلتُ بكَ عِدّة مرّاتٍ.. كنتَ تدّعي أنّكَ مشغولٌ.. عَذرتُكَ، لأنّكَ كما قلتَ.. لديكَ الكثيرُ من الأعمالِ، عليكَ أن تنتهي منها قبل سفركَ.. وانتظرتُ أياماً أخرى..
البارحة رأيتُكَ في طرفِ شارعنا مُسرعاً، لوّحتَ لي بيدكَ من بعيد..
بعد أيامٍ التقينا.. كررتَ مقولتكَ أنّ أعمالكَ تزيدُ، أفكاركَ.. مشاريعُكَ..تكبرُ..استثمارُ رأسِ المالِ هنا يُقلقكَ.
أسألكَ ونحنُ نشرب فنجانَ القهوة عن أصدقائِنا القدامى، الذينَ هاجروا معكَ شركاءِ الفقرِ والحزنِ، فتجيبُ ” لا أعلم.. لم ألتقِ بأحدْ”!
اعذرني يا صديقي، لا أمتلكُ من مفاتيح حديثي معكَ سوى الماضي.. المستقبلُ هنا تعطّل، حتّى صِرنا نشكُّ في وصولهِ.
الماضي هو القاسمُ المشتركُ بيننا.. الهاجسُ الوحيدُ الذي يشغلني كلّما تأملتُ تجاعيدَ وجهكَ. هو أي لا أستطيعُ إلاّ أنْ أراكَ كما كنتَ قبل خمسةَ عشرَ عاماً.. حيثُ توقّفَ الزمنُ.. وافترقنا.. اعذرني إذا استفزّتك أسئلتي.
هل زرتَ أمّكَ ؟
هل سألتَ عنْ أختكَ ؟
أختُكَ.. التي كانتْ تزحفُ لتفتحَ لكَ البابَ.. تتعلّقُ برقبتكَ عندما تعودُ بعد كلّ غيابٍ..
” أنا ” لا أنسى بَريقَ الأملِ والفرحِ في عينيها، عندما كنتَ تَعِدها بالعلاج بعدَ أن تتخرّج، وأنّك ستختّص بالجراحةِ العصبيّةِ لأجلها…هل نسيتَ ؟
وكعادتكَ تغيّرُ الحديثَ.. وقبلَ أن تغادرَ تلتفتُ لتقولَ:
ـ اليوم مساءً نزوركُم ونكملُ الحديثَ..
كنتُ سأخبركَ: أنّني رأيتُ أمّك وهي في السّبعين من عمرها.. تسوقُ أغنامها نحو المرعى..
“ربّما ذاتُ النغمات التي كنّا نرعاها أنا و أنتَ يومَ كنّا صغاراً “
أمّكَ غضبتْ عليكَ يا صاحبي، لأنّها طلبتْ منك المساعدةَ في علاجِ أختك.. ورفضتْ زوجتكَ استقبالها، صرتَ حديثَ القريةِ يومَها.. بكتْ.. دعتْ عليكَ.. وتنكرتْ لك..
قالتْ يومها: نسيُتهُ يا بنيّ نسيُتهُ.. ثمّ التفتتْ إليّ وهي تجففّ دمعها في أخاديدِ وجهها ” الله يحميه وين ما كان “
أمّي قالتْ لي: ” صاحبُك طلع ولد خايس “
لا أخفيكَ.. شعرتُ بالفرحِ الغامرِ عندما قلتَ إنّكَ ستزورني اليومَ، أدركتُ للحظةٍ أنّكَ انتهيتَ من أعمالكَ، ستتفرّغُ قليلاً لذكرياتنا.. لماضينا
نجلسُ جلستنا الحميمة كما كّنا أيام الصيف، آملُ أنْ أعيش َمعكَ ومع أولادنا بعض َتفاصيلِ العُمرِ الذي عشناه في شقاءٍ ودراسةٍ.
في البيتْ كان أولادي يلحّون في السّؤال عنكَ.
يريدون أن يعرفوا شيئاً عن صديقِ أبيهم، الذي طالما تحدّث لهم عنه، وهم يقلّبون الصّور.
قلتُ: بُنيّ هو صديقي، بل أخي تربّينا معاً. درْسنا.. لعبناً.. سبحنا في عيونِ الماء، جمعنا البلّوطَ أيامَ الثّلجِ لنطعمَ الماعزَ. عملنا في الحفريّاتِ يومَ مرّ خطّ الماءِ من القريةِ.. تقاسْمنا رغيفَ الخبزِ وحبّة البصلِ..
أحببتُه لأنّهُ مثالُ الشّابّ الصّابرِ على الفقرِ.. يعتمدُ على نفسِه.. لقمتُهُ التي في فمهِ ليستْ له..
أخوتهُ كانوا يرسلونَ له مصروفَه الشهريّ، مع العلم أنّ كلّ واحدٍ منهم يعيلُ أسرةً كبيرةً.. يقطعونَ من خُبزِ أطفالهم ليساعدوهُ.
ابتسمُ وأنا أقول لصغيري: كنّا نلبس بنطالاً واحداً.. فيضحكُ ” كلّ واحد رِجْل بابا ” لا..لا بُنيّ نتشاركُ الألبسةَ كما نتشاركُ الأقلامَ.
ـ إذاً لماذا لم يتصلْ بكَ حتّى الآن…؟
ألم تقلْ إنّه كان صديقكَ المحبوب…؟
ـ سافرَ إلى خارجِ البلادِ، ولا تنسَ أننا غيّرنا مكان إقامتنا أكثر من مرّة، بسببِ العملِ والظروف ِالراهنةِ….
كانتْ جدتكَ عندما تضعُ لي المؤونة أيامَ الدّراسةِ، تَحسبُ حِسابهُ في “الزيتون و المكدوس والمربيّات”.. نعتبرهُ الأفضلَ بين ثلّة الأصدقاءِ. كانتْ تقولُ: هو طبيبٌ ليسَ مثلكم…! كنّا كلمّا استأجرنا غرفةً، ندعوه ليسكنَ معنا. حتّى لا يتكلّفَ مصروفاً زائداً، وكانَ أهلنا سعداءَ بذلكَ لأنّه “طبيب”.
كنّا الأكثرَ إحساساً بهمومهِ ومعاناتهِ.. ندرك القسوة في أنّ طالباً في كليّة الطّبّ، يعملُ معاونَ سائقِ حافلةٍ أيامَ العُطلِ…
في المساءِ جلسنا جميعاً…تناولنا الشّاي..
كنتَ تغصُّ عندما يأتي حديثُ الماضي.. كانتْ ملامحُ الحزمِ والجدّ طاغيةٌ على وجهك، نظراتُ الزيغ في عينيكَ.. تأمّلتُ هيئتكَ.. أجزمُ إنّ ثيابك يومَ كنتَ طالباً، كانتْ أكثرَ أناقةً.
ويشغلكَ الحديثُ عن مشاريعِك في المُغتربِ و حياةِ البَذخِ.. التي لم تعرفْ طريقها إليكَ حسبَ ما أرى.
طلبتَ أنْ نقومَ بجولةٍ صغيرةٍ في البيتِ.. توقفتَ قليلاً عند المكتبةِ.. قلّبت بعضَ أوراقِ الكتبِ.. وقلتَ لم أقرأَ منذُ سنواتٍ.. وقلتُ لك أتذكرُ يومَ كنتَ مُغرماً بنزار قباني.. ومدنِ الملحِ وصادق جلال العظم وموسم الهجرة إلى الشمال..
شدّتكَ الأركانُ الهادئةُ، في غرفةِ الأولادِ.. ولمساتِ الألفةِ والحبِّ التي تعبقُ بالمنزلِ.. نظرتَ سَريعاً إلى شَهاداتِ التقدير والجوائز، التي عُلّقت على الجدرانِ. أحزنني أنّك لم تعرها اهتماماً..
فقط سألتني هل البيت ملكٌ لكَ…؟
ـ لا لا العم مُصطفى.. صاحب البيت، أعطاني إيّاه بأجرٍ رمزيّ بعد أن هاجرَ أولادُه، قال: إنّ أولادَه سيبيعون البيت، لكنّهم أجّلوا ذلك.. بل إنّه هو منْ رفضَ البيع أكثر من مرّة.
كثيراً ما يأتي العم مصطفى إلى هنا.. نجلسُ في الحديقة، نتناولُ القهوةَ، تحتَ شجرةِ ” النّفناف”
كنتَ و ما إن تتوقف عن الكلامِ، حتّى تبدأ زوجتك حديثاً له أوّل وليس له آخر.. ما أفهمهُ منها أنّك بنيتَ نفسكَ بنفِسك..
وتعودُ الزّوجة.. تتحدثُ عن الموضةِ، والأبنيةِ والمشاريعِ. عن الأحلامِ العريضةِ.. ألحظُ التبرّم من حديثها في عينيكَ..
عندما خرجنا إلى الحديقة، رأيتُكَ تتوقّفُ طويلاً عند شَجرةِ النّفنافِ التّي مدّت أغصانها إلى الشّارع، واشتبكتُ مع شَجرة الياسمين، لتغطّي سماءَ الحديقة، عرّشتْ على أطراف شجرة ” الأكدنيا “.
التفتُ إليك.. وأنا أمسكُ غُصنَ الوردةِ..
أتذكرُ شجرةَ النّفناف في بيتكم…؟ ابتسمتَ في حزنٍ ..
عندما كنّا نأتي و لا نجِدُكَ، نقطفُ منها وردةً، ونرميها إلى أرضِ الدّار حسْبَ عددنا وردة.. اثنتان.. ثلاث..
وإنْ عرفناكِ في الداخل، نقذفُ حصاةً صغيرةً على النافذة، أو على الباب.. تفتحُ و نجلسُ تحتَها.. نحكي و نشتكي لبعضنا. عن الأحلامِ و الخيباتِ والفقرِ والسياسةِ.. نستذكرُ كلّ أيّام الدّراسةِ في سهراتِ الصّيفِ نُخططّ لمئةَ عامٍ قادمٍ…
..وتشْردُ ..
عندما نزحتُ من بيتي، لم أحملْ معي إلاّ القليلَ من الكتبِ، والكثيرَ من الذكرى، وها أنا على بُعدِ مسافة كيلو متراتٍ قليلةٍ منه، بعد أن أصبحَ رُكاماً.
لم أجدْ منكَ كلمةَ مواساةٍ ..رأيتكَ تذرعُ أركانَ الحديقةِ بخطواتكَ الواسعةِ، تسألُ عن مساحةِ البيتِ.. وعن عددِ الغُرفِ.
قلتَ إنّ الحنين إلى الوطن أعادكَ، لكنني وجدتُ الوطنَ قد غابَ عن ذاتك..
هل ما زلتَ في سَكْرة الحنين…؟
في الحقيقة احترتُ معكَ.. الوطنُ أمّكَ.. أخوتكَ.. جيرانكَ.. أصدقاؤكَ قبل أن يكونَ حجراً وتراباً..
وقفتُ أمامكَ هذه المرّة وبصراحةٍ تامّة قلتُ لك: ما تخفيهِ مكشوفٌ، أهلكَ على بعد دقائق من هنا..
أعلمُ أنّك تُكابر، وتتجاهل.. تحرّكْ انزعْ عنكَ قِشرة المُكابرة، عُد كما عرفناكَ..
الوقتُ يمضي.. أمامكَ فرصةٌ تجمعُ فيها شتاتَ ذاتك.. فالزمن لا يتوقفُ، ولن تستطيعَ شراؤه أبداً..
أخرَجنا من دوّامة حديثنا، صوتُ زوجتكَ التي تنادي عليك بالمغادرةِ.. تعمدتُ أن أقرصَ ابنكَ من خدّه حتّى أحمرّ، وقلتُ مداعباً: أبوكَ كانَ في عمركَ لمّا سقطَ من على ظهرِ الحِمار وانكسرتْ ذراعه.. كنّا يومها نجمعُ ما تبقّى من حبّات التينِ على الأشجارِ بعد موسم قطافها لنبيعها..
ألحظُ الحنقَ على وجهِ زوجتكَ.. وأدرك تنكّرها، لماضيها وماضيك، وأعلمُ أنّها لا تميّز بينَ الخيمةِ وبردعةِ الحمار.. كلّ ما تعرفهُ من حاضرها أنّها زوجة اسْتشاري أعصاب..
غادرْتَني.. وأنا أحسّ صمتَ القَهر يأكلُ عينيكَ. قلتُ في نفسي ربّما تاه صاحبي أو فقد رُشدَه.. لكنّ طريقَ العودة واضحٌ.
بعدَ أيامٍ قُرِعَ جرسُ البابِ.. فتحتُ، فإذا بالعمِّ مصطفى، عندما دخلَ قرأتُ في وجههِ ملامحَ الحزنِ.
قال: الأولاد باعوا البيت.. والتسليمُ بعدَ شَهر.
ـ لكن يا عم لم يأتِ الشاري إلى البيت ليراه.!
ـ بل أتى مع أسرتِه وأعجبهم كثيراً.
ـ يا عم صدّقني .. لم …!
قاطعني.. جاءَ رجل مع أسرتِه منذُ أيام.. تذكّرْ…!
الأولادُ باعوه البيت عن طريق المحامي..
ثم أخرج ورقة من جيبه وقال: هذه نسخةُ العقدِ.
على كلّ حالٍ لديك خمسة عشر يوماً حتّى تُخلي البيت، تدبّر أمرك.. الرّجل الذي اشترى البيت سافرَ وكلّف المحامي بمتابعةِ الأمر.
قالَ وهو يغادر:
أنتَ تعلم أنّيّ وحيدٌ مع زوجتي، إذا رغبتَ تعالَ واسكنْ معنا ريثما يدبّرها ربّك.. أهلاً وسهلاً بكَ.
لم أخبرْ أحداً أنّي لمحتُ في أسفلِ نُسخة عقدِ بيع البيت…
اسمكَ، وتوقيعكَ، يا صديقي.
.