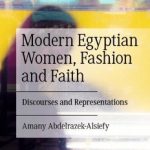قراءة في رواية “حيّ نوليندورف”

موسى الزعيم
الرواية الصادرة عن دار الدليل للطباعة والنشر، للدكتور عبد الحكيم شباط تأتي ضمن مشروعه الإبداعي والذي يُعنى برصد الحالة الديموغرافية لمدينة برلين، بعد وصول عددٍ كبير من اللاجئين إليها خلال السنوات الأخيرة.
تقع الرواية في مئة وخمس وستين صفحة من القطع المتوسط، وهي في بنيتها الشكليّة مجموعة من القصص المتشابهة في مصائر شخصياتها والمختلفة في خطّ سيرها.
وتطرحُ تساؤلات المكان، وتأثيراته على الهويّة والخصوصيّة، يبدو ذلك من خلال وعي الروائي بالمكان الذي تدور فيه الأحداث، كعتبة أولى، وارتباطه بالسرديّات الدائرة في مُحيطه، وبالحالة السيكولوجية والنفسيّة للأشخاص في حي نوليندورف، والذي من المُفترض أن يكون جنّة حسبَ التصورات الواردة إليهم في أوطانهم قبل هجرتهم.
الصراع في الرواية صراع اثبات كينونة الانسان ووجوده في بيئةٍ جديدةٍ، شخصيّاتٌ قلقةٌ، حائرةُ، يشوب حياتها الكثير من الانكساراتِ والخيبات.
الرواية قصص منفصلة لعدد الشخصيات من خلفيات ثقافية، وإثنية متنوعة، يعيشون في بيئة مكانية واحدة، وسط برلين، لكلّ شخصيّة حكايتها وهمومها وأحلامها والتي تتقاطع مع حكايا البقية، بشكل أو بآخر لتصبّ في نهاية درامية في مكتب السيدة (ماريون) الموظفة الألمانية.
من جهة أخرى: لا تعالج الرواية قضية اللجوء والهجرة بشكلها الحالي فقط، وإنّما تتطرق لها بشكل عام عبر فترة زمنية أطول، تعود في بعض الأحيان لعشرين سنة مضت.
سكّان حي نيولندورف ” سكّان الرواية “
في هذا الحي البرليني تدور قصص الباحثين عن فرصة أفضل للحياة، بغضّ النظر عن الأسباب التي دفعتهم إلى الوصول إلى الفردوس المُشتهى.. أرض الجرمان ، والتي يعانون فيها في الحصول على المواطنة رغم استيفائهم الشروط القانونية ودفعهم مستحقاتهم الضريبة.
بعدسة سينمائية، تدور كاميرا الراوي في المكان، ترصد ما حولها في ” زوم ” تبدأ من الدائرة الصغرى ثم تتسع أكثر فأكثر.. بناء مكوّن من أربع طبقات تشغل إحدى طبقاته السيدة “ماريون ” امرأة لا يتعدى طولها متراً ونصفاً جسدها، نحيل وشاحب، جمجمتها مدوّرة، فمها عريض، وأنفها قصير ومُدبب كعقب المطرقة.. نظراتها غامضة، تبعث في النفس التوجّس والنفور، شعرها فتائل بنيّة خشنة، غزاه الشيب فصار مثل شعر الماعز.. تفوح منها رائحة كبراز القطط.. „
ماريون خبيرة “بالرايخ الثالث”.. لديها تحفظات حول الهجرة، وهي خبيرة بالقانون المُتعلق بالمهاجرين، درست القانون، تعمل في المكتب المسؤول عن منح “المواطنة” والإقامة، لديها شغف في تعطيل الاجراءات، تِبعاً لهواجسها، بينما القانون الألماني في الغالب يتغاضى عن أخطائها وفي أغلب الأحيان لا يحاسبها،.. تعيش مع أمّها، علاقتها بها سيئة، تكيل لها الشتائم، شخصيّة يشوبها الكثير من التناقضات لديها مكنون هائل السوداوية والاستعلاء.
في ذات البناء يعيش التركي تونجاي” صاحب مطعم الدونر” والذي كان يدرس الهندسة في بلاده، وبسبب ميوله السياسية تمّ اعتقاله، ليهاجر بعدها إلى ألمانيا بحثاً عن الحريّة والعدالة.
في الطرف المقابل من الشارع محلّ مثلجات لـ “جاكومينا” الإيطالية والتي جاءت لتدرس في إحدى جامعات برلين، وبعد حصولها على الدكتوراة في “السياسة داخل المجتمع الليبي”، لم تجد عملاً إلاّ “محلّ بيع المثلجات”..
أمّا “سيمون” زوج المرأة الألمانية سليفا والتي افتتحت محلاً للموضة، تشارك فيه زوجها الموهوب القادم من ليون الفرنسية..
بينما “مفتاح” القادم من مجاهيل إفريقيا، الذي يعاني من اختلاف الطقس والملل، يعمل سائق دراجة لتوصيل الطلبات عند سيمون، و “أنور” أستاذ الأدب المُقارن، خريج جامعة الهمبولدت، الكاتب الباحث عن فكرةٍ جديدةٍ لروايته، والذي يعمل في محلّ لبيع الفروج المشويّ.. و”باولا” القادمة من الأرجنتين.
ترصدهم جميعاً عين أم ّ ماريون، العجوز “الألمانية” تجلس على شرفتها، تراقبهم جميعاً، يتبادلون الابتسام معها، بروح من الرضا، وفي كثير من الأحيان يمدّون لها يد العون، ولو بتلويحة يدٍ من بعيد تُعيد ضخّ الحياة الجافة في عروقها.
هؤلاء جميعاً يضعهم الراوي في دائرة جغرافيّة افتراضية، لكنّه يعطيها صفة الحقيقة، من خلال تأكيده على ركائز موجودة في المكان عينه، مما يضفي على النصّ سِمة التوثيق والواقعية في أغلب الأحيان.. بالمحصلة أفرادٌ يمتلكون طاقات علميّة وبشريّة وكفاءات هائلة، لكن ظروفهم ألجأتهم إلى واقع مُتخمٍ بالتعقيد والنّفور.
المكان باعتباره جاذباً وطاردا ً.
تُحدد سلطة المكان في العمل الروائي باعتباره ذا حدود وأبعاد، يضع الراوي عناصر هذا الفضاء على أنّه بيئة مناسبة لعمله و من هنا يغدو للمكان بعداً هندسياً أو جغرافياً أو ربّما فيزيائياً.
وبالتالي هذا الوصف المكاني بدقّة للحي يجعل ما هو متخيّل سردياً حقيقياً؛ على أرض الواقع، لتقول: إنّ هذه الشخصيات، عاشت هنا بالفعل. من خلال وصف البناء والمطاعم، أسماء الشوارع، ومحطّات القطار، كلّها تُعطي تصوراً أولياً أنّها حقيقية موجودة في ذلك الحيّ، كذلك ارتباط اسم أحد شوارع الحي بقصة شاعرة ألمانية تعرّضت للاضطهاد له رمزيته ودلا لته في متن الرواية.
هذا الحي يمثّل بشكل عام حالة ألمانيا وعلاقتها بالقادمين إليها.. فما يدور فيه هو انعكاس لمعاناة يعيشها اللاجئون في ألمانيا و اندماجهم في المجتمع، وصعوبة تفاعلهم مع الحياة، وبالأخص من جهة تقبل الآخر “صاحبَ الأرض” لهم في بعض الأحيان.
يحللّ الكاتب ارتباط الشخصيات بالمكان وردود أفعالهم، وتفاعلهم فيه، ويُرجعنا إلى أسباب وصولهم إلى ألمانيا بغضّ النظر عن تسميتهم ” لاجئ، نازح، وافد، دارس.. ” يغوص في أعماقهم يحلل أسباب معاناتهم وانكسار ذواتهم وضياع أحلامهم، وتجاهلهم، وتبديد طاقاتهم وامكانياتهم العلميّة عن قصد بسبب انتمائهم أو لون بشرتهم، وتحويلهم إلى أعمال يدوية، وعادة ما تتقاطع خطوط مشكلاتهم في مجاهيل مكتب ماريون في ثنائية ضديّة.
تعيدك الرواية أحياناً إلى أجواء روايات الأحياء القديمة، تقرأ وكأنك في القاهرة أو استنبول وتنسى أنك في برلين ..
فتفاعلات المارّة، ضحكاتهم، طعامهم، جلساتهم وحواراتهم في محلّ مثلجات الإيطالية جاكومينا ومطعم التركي تونجاي، علاقات الجيران، صحن الطعام الذي يُسكب للعجوز لألمانية، اللغة العاطفيّة المستخدمة فيما بينهم، والتي دفعت جاكومينا للبحث عن معنى كلمة “أبيه – الأخ ” مقارنة بالألمانية.
“..غالباً ما كان توماس الألماني، يجد نفسه مُضطراً لتمثيل المجتمع الألمانيّ، ويدافع عنه أمام ثلاثة أصوات أجنبية، من ثلاث قارات.. ويحدث أن تنقلب الأمور، لتدافع الأصوات الأجنبية عن المجتمع الألماني، وأحياناً أخرى يرى الجميع أنفسهم أغراباً..”
كلّ ذلك يُشعرك أنّ الوضع طبيعيّ، لولا وجود أمثال ماريون، ولكن ماريون ليستْ فرداً وإنّما تمثل فكراً وتياراً، ورغم قلته إلاّ أنّه يمثّل نموذجَ مَنْ يضع العصيّ في العجلات.
والكلّ يعيش هواجس ظهور وصعود “البديل”…وما رافق ذلك من تخوّفات وتكهّنات على مستقبل اللاجئين خاصةً وألمانيا عامة.
على صعيد المكان الخارجي: يُرجع الراوي الشخصيات إلى ظروفها في بلادها التي هاجرت منها باعتبار أنّ ذلك المكان صار طارداً.. الحرب في سوريا و في الشرق عموماً، مفتاح القادم من إفريقيا والتي سرقت المدنيّة وتجّار التنقيب هدوء قريته؛ القرية الوادعة التي كانت تدرّ على سكانها ما يشبع بطونهم، ويصون كرامتهم، وعلى رأي “جاكومينا “حتى مَن يعيش في القطب الشمالي لديه ما يكفيه من الخبز.. „
منهم من قدم من ألمانيا ذاتها من شرقيّها إلى غربيّها، بعد هُدم جدار برلين، كحال الألماني “مشيل” مدرس اللغة الروسيّة الذي دفع ثمن وحدة ألمانيا، فخسر عمله، الوحدة التي دمرّت حياته وأحالته إلى بائع كتب.
كلّ شخصية في الرواية لها أسبابها ومبرراتها للوصول إلى هذا الفردوس المزعوم.. ولتمسك بتلابيبه البيروقراطية من جهةٍ، وتذمّر ماريون من جهة أخرى.
الراوي يضعنا بين نموذجين لهما خصوصية في التمييز وعدم تقبّل الآخر، هما الجامعة، من جهة العمل الأكاديمي، والسجن.. السجن الذي عانى منه مفتاح حيثُ رفضه النزلاء بسبب لون بشرته.. ولك أن تتخيل ما بين هذين النموذجين.
لكنّ سؤالاً تطرحه الرواية عن كرامة الفرد في وطنه بين أبناء جِلدته؟ فما نعانيه نحن ” العرب” لا يخفى على أحد، إلا نُمارس العنصريّة على بعضنا بين “ريفٍ ومدينة، بدويّ وحضريّ وضجعيي” وغير ذلك الكثير، لماذا نتذّمر ممن دُسنا بِساطهِ! إذا اعترض على وجودنا في بيته؟! بينما نتغاضى عمّن يمزّق بساطنا كل يوم هناك؟!
السوريّ الايطاليّ والسوريّ اليونانيّ:
السوريون لا يشبهون بعضهم كثيراً! هل هؤلاء حقّاً عرب؟! الأشكال محيّرة ” الأنفُ الرومانيّ المَعقوف، القامة الطويلة، واللّحية الشقراء، البشرة الحنطيّة المتورّدة، والعيون الخُضر ” هكذا تصف جاكومينا الدكتور نور ادريس”..
يسعى الروائي إلى الاشتغال على المُشتركات الانسانيّة، دون التعويل على جنسية المرء، أو لون بشرته .. ومن خلال اهتمامات الكاتب المعرفية المُكتسبة أكاديمياً، فهو المُختص بالفلسفة وعلم الاجتماع ….
كانت جاكومينا تقول إن هؤلاء السوريين أشكالهم حقاً مُحيّرة! الأوّل خِلته يونانيّ! والثاني خِلته ايطالي.. لكنها أدركتْ أنّها شمس البحر المتوسط، وزيت الزيتون، والسفن الفينيقيّة التي تنقل حضارة هؤلاء البشر، وتحطّ بهم في أقاصي العالم، وتترك أحفادهم هناك.. هؤلاء القانعون بأنّ
“ساعة حريّة من العُمر تساوي، حياةً مديدةً من العبودية ” حسب رأي المفكّر رشيد بوطيب.
شخصيات “حي نيولندورف” تسعى إلى اثبات انسانيتها، ووجودها ودخولها على خطّ الحياة الجديدة، رغم قلقها، وعذاباتها، وانفصالها عن ماضيها، مكانياً، وزمانياً.
من جهة أخرى يتناول الراوي الألمان ونشأتهم وعلاقة الدين بالدم، والفلسفة، و مآلات الشخصيّة الألمانية وتكوينها وتأثير الحرب العالمية الثانية عليها، يرسم الراوي صورة للمرأة الألمانية، المرأة الجميلة ذات الجسم المتناسق، لكن بالمقابل هذه المرأة أنستها سلعيّة الحياة ما تحوزه من جمال، فغدت، كائناً مسكونا ً بهاجس العمل، لا يشغلها السعي وراء الرجل الذي بات عليه أن يتقبّلها كما هي، وقد أهملت أنوثتها أو نسيتها ورغم ذلك حسب رأي سيمون ” ما كان عليه أن يثق بامرأة ألمانية “.
بالمقابل هذا “الألماني الذي غدا روحاً وحيدةً، تعاني الاغتراب” تكشفُ الرواية من خلال علائق الشخصيات ببعضها ارتداد العاطفة داخل كلّ فردٍ، وانعكاس ذلك على المجتمع، فموت عمّة تونجاي يُشعل فيه الحنين، ويدفعه إلى السفر إلى تركيا، بينما سيمون يفطنُ متأخراً لموت أمّه التي تركها وحيدةً ليعود متأخراً يبكي على قبرها، في حين أنّ ماريون لم تهتم مُطلقاً لموت أمها، بل اعتبرت ذلك حدثاً عادياً، فبعد يومين راحت تنظّف غرفتها لتؤجّرها، شأن ذلك شأن علاقة الجيران بالعجوز الألمانية، زبيدة تسكب لها صحن الطعام ، سيمون يلوّح لها من بعيد، رالف الألماني لا يكترث لوجودها..
يتساءل الراوي كيف جفّت الرومانسية والعاطفة في نفوس بعض الألمان وهم أصحاب التيارات الرومانسية في الأدب والثقافة؟ ألا يبدو ذلك من أشعار كبار شعرائهم؟
هل يعكس ذلك علاقة الفرد بقوميته، بقيمه وتقاليده، وبانتكاسته إليها عند الشدّة، ربما يفسر ذلك ما حدث لتونجاي وسيمون وجاكومينا في ارتدادهم لقومياتهم ولجوئهم إليها بعد تتالي الخسارات.
بلغة تسجيلية رشيقة تعمد الرواية إلى نقد المظاهر السلبية في المجتمع الألماني، و سلوكيات بعض القادمين الجُدد، من خلال التغيير الذي طرأ على مظاهر لباسهم، وحياتهم، هكذا يُفسّر بعضهم اندماجه في المجتمع الجديد.
في بعض الأحيان كان الراوي يقع في مطبّ التعميم.. ومن هنا يمكن أن نطرح التساؤلات التالية: تُرى كم عدد أمثال ماريون بين الألمان؟ وهل كل من يريد الحصول على المواطنة يتعثّر بأمثال؟ إذن الأمر محبطّ بلا شكّ !
هل كلّ الذين وصلوا إلى ألمانيا من الاكاديميين تعطّلت بهم سُبل العمل والاندماج؟!
حسب معرفتي فقد تدارك الألمان بعض هذه الثغرات، وسعوا إلى دمج أكبر عددٍ ممكن من القادمين وخاصّة من جهة اللغة، وما نلاحظه الآن من توجّه القسم الأكبر من السوريين إلى العمل والدراسة يدفع للتفاؤل..
من جهة أخرى فإنّ زمن الرواية سار عبر (صيف، خريف، شتاء) ما يعني أنّ الرواية عالجت فترة زمنيّة قصيرة هي طَفرة اللجوء الحالي، لعلها كانت في البدايات..
تنتهي الرواية في اللحظة الأهمّ، والأجمل عند الألمان، في ليلة رأس السنة، مع سقوط الثلج، ففي الفصل الأخير يستدرك الراوي ما فاته ويفتح باب الأمل، ومفاجأة خروج ماريون من سياق الحياة، يحلّ أغلب المشاكل الجوهرية العالقة، والعربة تعود إلى السكّة.
.