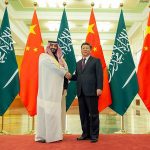في ذكرى ثورة 23 يوليو ..

د. حمد محمود السيد
سبعة وستون عاماً على ثورة 23 يوليو المجيدة في مصر، ورغم مرور هذا العدد الكبير من السنوات إلا أن آثار يوليو ما تزال باقية في وجدان الملايين، من أبناء الأمة العربية على امتدادها من المحيط إلى الخليج، والعديد من بقاع العالم، باعتبارها ثورة ملهمة، نجحت بما نادت به من أفكار ومبادئ، وما حققته من إنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي، في إحداث تغييرات جذرية وكبيرة، تجاوزت آثارها خريطة المنطقة العربية إلى العديد من بلدان العالم.
ربما تبدو قراءة منصفة بعد مرور هذا الوقت، ليدرك المدقق الحصيف بالفعل، أن آثار تلك الثورة الملهمة، التي قادها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لم تتوقف عند حدود إقليمها، وإنما امتدت لتشمل مناطق عدة في المعمورة، خاصة دول أمريكا اللاتينية في نضالها ضد الاستعمار، فضلاً عن نجاحها في إحداث تغييرات لافتة في السياسة الدولية، في زمن ما يعرف بالحرب الباردة والصراع المشتعل بين القطبين الكبيرين، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي سابقاً، لتشكل مصر مع حلفائها من دول التحرر الوطني أول منظومة سياسية دولية، تتميز بالاستقلال السياسي عن سياسة القطبين، وهو ما عرف بحركة «عدم الانحياز»، التي ضمت عند تأسيسها بقيادة مصر 25 دولة، قبل أن تصل عضويتها حالياً إلى 120 دولة، من بينها 53 دولة إفريقية و39 دولة آسيوية إلى جانب 27 دولة من أمريكا اللاتينية والكاريبي، فضلاً عن 17 دولة و10 منظمات حكومية تتمتع بصفة مراقب.
نجحت يوليو حسب كثير من الباحثين المنصفين، في صناعة قانون جديد للعالم كله، لم يخف انحيازه للشعوب الرافضة لصراع القطبين الكبيرين، مثلما نجحت محلياً بما أصدرته من قرارات في الانحياز للفقراء والبسطاء، لتمنحهم العديد من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي حرموا منها لقرون، ولعل أهم منجز لها في مصر في هذا المجال، هو قانون الإصلاح الزراعي، الذي أصدرته الثورة في سبتمبر من العام 1952، بعد أقل من أربعين يوماً على سيطرتها على الحكم في البلاد، والذي حددت فيه الثورة ملكية الأراضي الزراعية بما لا يزيد على مائتي فدان، لتمنح الفلاحين الإجراء الحق في الحياة، بعدما ظلوا لقرون من الزمان أشبه بالعبيد في الإقطاعيات الكبيرة التي كانت مملوكة للباشوات وكبار الملاك.
لم يكن قانون الإصلاح الزراعي الذي أقرته ثورة يوليو، يستهدف فحسب إنصاف الفلاحين في مصر، حسبما يرى كثير من الخبراء، وإنما أيضاً معالجة خلل اقتصادي فادح ضرب مصر، بسبب توزيع الأرض الزراعية ذات المساحات الشاسعة على كبار الملاك من الباشاوات، وهو ما لعب دوراً كبيراً في انخفاض متوسط الملكية لباقي المصريين بصورة تدريجية، حتى وصل عدد صغار الملاك حسب إحصائيات رسمية رصدت تلك الفترة لنحو 78 ألف مصري في العام 1910، قبل أن يقفز هذا الرقم بعد قانون الإصلاح الزراعي إلى نحو مليوني فلاح، بعد نزع ملكية ما يزيد على نصف مليون فدان، أي ما يقرب من 8.4 % من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر في ذلك الوقت، وتوزيعها على الفلاحين، وفقاً لنظام معين من الأولويات، بحيث أعطيت الأولوية عند التوزيع، لمن كان يزرع الأرض بالفعل.
لم تتوقف آثار يوليو الداخلية في مصر، عند حد إنصاف الفلاحين، وإنما امتدت إلى رد الاعتبار للعامل المصري عبر إطلاق حرية التنظيمات النقابية ضمن حركة تصنيع كبرى، بالتوازي مع سلسلة من المشروعات القومية العملاقة، ربما كان من أبرزها مشروع بناء السد العالي الذي جسدت فترة بنائه، ملحمة وطنية في الاستقلال والكرامة، ولم تتوقف آثاره عند حد حماية الأراضي المصرية من فيضان النيل المدمر، وإنما بلغت في السنوات الأخيرة، حماية مصر من العطش، ومن ملحمة بناء السد العالي، امتدت إنجازات ثورة يوليو، لتشمل تأميم قناة السويس، وهي الخطوة التي نجحت من خلالها مصر في استعادة هذا المرفق الملاحي الحيوي إلى حضن الإدارة المصرية، بعدما سيطرت عليه الشركة الفرنسية لعقود من الزمان، وقد دفعت الثورة ثمناً فادحاً لهذا القرار، عندما تحملت عدواناً ثلاثياً، من قبل إنجلترا وفرنسا وإسرائيل، لم يفلح في النيل من الإرادة المصرية التي حققت نصراً سياسياً كبيراً في هذا العدوان، عندما جرّت الدول الثلاث المعتدية أذيال الخيبة بعد انكسارها في مدينة بورسعيد.
على مدار نحو عقدين من الزمان، أرست يوليو في مصر العديد من المبادئ العظيمة التي انتصرت للسواد الأعظم من المصريين، فوفرت لهم سبل التعليم المجاني لتحقق مقولة أطلقها عميد الأدب العربي طه حسين قبل سنوات بعيدة من الثورة عندما قال «إن التعليم مثل الماء والهواء»، وبنت المستشفيات الكبرى والوحدات الصحية في الأرياف، ودشنت أولى مشاريع ما يعرف بالإسكان الاقتصادي، فضلاً عن أول منظومة للتأمينات الاجتماعية، في سلسلة متتالية من الإجراءات جنباً إلى جنب مع حركة تصنيع كبرى، جسدت على نحو حقيقي ومباشر وملموس، مبادئ العدالة الاجتماعية التي ظلت أصداؤها مستمرة، حتى رفع شعارها المصريون من جديد في ثورة يناير 2011، جنباً إلى جنب مع صور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بعدما بيعت المصانع التي شيدتها يوليو، وتردت الخدمات الصحية، وتحول التعليم المجاني إلى أثرٍ بعد عين.
كان الجيش هو كلمة السر في صناعة ثورة يوليو، وقد أولته الثورة اهتماماً لافتاً، فعملت على بناء جيش وطني قوي، وهو مبدأ لم تفلته حتى بعدما تعرضت مصر لنكسة 1967 المدوية، لتعيد يوليو بناء قوتها المسلحة على أحدث النظم العسكرية والتكنولوجية، لتتوج جهودها بانتصار عظيم في أكتوبر 1973، لا يزال يدرّس في العديد من الأكاديميات والمعاهد العسكرية العليا في العديد من دول العالم.
على مدار عقود تعرضت ثورة يوليو لانتقادات عنيفة، من قبل قوى سياسية بعضها كان يمثل امتداداً طبيعياً للقوى السياسية التي كانت موجودة في مصر قبل عام 1952، وقد استندت هذه القوى في هجومها على يوليو، بما وصفته ب«غياب الديمقراطية»، وهي قولة حق يراد بها باطل، فقد انتهجت يوليو مفهوم الديمقراطية الاجتماعية، في بلد تفشت فيه الأمية والفقر والجهل والمرض كأولوية قصوى، ومن ثم فإن حديث مثل هذه القوى عن الديمقراطية بمفهومها الليبرالي، كان يمثل ضرباً من الخيال، وما يزيد من غرابة هذه الانتقادات، أن نفس هذه القوى كانت أول من دعت الجيش ممثلاً في تنظيم الضباط الأحرار، لينقذها من استبداد الملك، ومن سلطة الاحتلال.
نجحت يوليو على مدار سنوات قليلة من عمر الزمن في إحداث حراك اجتماعي كبير في مصر، قضى على وضع شديد الطبقية، لم يكن يسمح لأبناء الميسورين الذين مثلوا تالياً النواة الأولى لأبناء الطبقة الوسطى، بتولي المناصب القيادية في البلاد، وقد تجسد هذا الحراك في حزمة من القرارات، ربما كان من أهمها حق أبناء المصريين في التعليم، وهو مطلب قديم طالما نادى به مفكرون ومثقفون مصريون، وقد كان أبناء تلك الطبقة الجديدة التي شكلتها قرارات يوليو، هم النواة الصلبة التي قادت في وقت لاحق مسيرة التنمية والتقدم في مصر، مثلما كانوا أول من حمل السلاح لاسترداد الأرض، بعد نكسة يونيو، التي ينظر إليها كثير من المؤرخين باعتبارها «المؤامرة الكبرى»، التي خططت لها القوى الاستعمارية، للقضاء على نظام يوليو، وجيشه الوطني الذي يواصل اليوم مهمته المقدسة في حماية مصر من خطر الإرهاب.
رغم مرور أكثر من ستة عقود على ثورة يوليو، إلا أنها لا تزال حاضرة ليس فحسب في وجدان الملايين من أبناء مصر والمنطقة العربية، وإنما أيضاً في العديد من المساجلات السياسية، كنقطة خلاف بين مؤيدين ومعارضين، وهي مساجلات تكتسب استمراريتها من معنى يوليو نفسه، تلك الثورة التي انحازت للبسطاء، وترجمت أفكار وأحلام مفكرين عظام في وحدة أمة تجمعها روابط الدين والدم، وناصبت العداء للتبعية والاستعمار الجديد، ومن ثم فإن هجوم بعض المنتسبين لتلك الشريحة على ثورة حررت الإرادة المصرية، وامتدت آثارها في النضال من أجل الاستقلال إلى مختلف ربوع العالم، يصبح طبيعياً، خصوصاً أن آثارها والمبادئ التي نادت بها، لا تزال حتى اليوم ماثلة أمام أعين الناظرين، في الحرية والاستقلال والتنمية والكرامة الوطنية.
مؤامرة «حريق القاهرة»
ينظر كثير من الباحثين إلى «حريق القاهرة»، يوم 26 يناير عام 1952، باعتباره الحدث الأكبر الذي مهد الطريق أمام اندلاع ثورة يوليو، إذ جسد هذا الحريق، حجم الفساد الذي كان قد استشرى في دوائر الحكم في البلاد، ومدى هيمنة قوات الاحتلال البريطانية على الملك فاروق وحاشيته، وفشل الأحزاب السياسية عن المواجهة.
وتقدر العديد من الدراسات حجم الخسائر التي ضربت العاصمة ، جراء التهام النيران العديد من المباني، وتدمير العديد من المحال ودور السينما والفنادق، بنحو 50 مليار فرنك، أي ما يوازي نحو 28 مليون جنيه بحسابات تلك الأيام، إذ استمرت الحرائق خلال الفترة ما بين الثانية عشرة والنصف ظهراً، حتى الحادية عشرة مساء، لتلتهم في طريقها كل ما تجده من ممتلكات ومبان، وتخلف وراءها 26 قتيلا و552 مصاباً.
ورغم أن هذا الحريق المروع لا يزال مدرجاً ضمن سلسلة الحوادث الغامضة في العالم، إلا أن كثيراً من الدراسات التي تعرضت لتلك الفترة، تذهب إلى أنه كان مدبراً بالتنسيق بين الملك وقوات الاحتلال البريطاني، للقضاء على حركة الكفاح المسلح في منطقة القناة، ومظاهرات الغضب التي اندلعت في القاهرة وفي الأوساط الطلابية.
وتشير التحقيقات التي باشرتها أجهزة الأمن المصرية عقب الحادث إلى جملة من الحقائق، مشيرة إلى أن إفادات كثير من المصريين الذين بادروا بتقديم شهاداتهم حول الحادث، كانت تؤكد تورط مجموعات مدربة في تنفيذ هذا الحريق المرعب، وأن هذه المجموعات كانت على درجة عالية من الدقة والسرعة في التنفيذ، وأنهم استخدموا في تنقلاتهم 30 سيارة لتنفيذ عملياتهم في وقت قياسي.
كان السبب الرئيسي وراء الحريق ، هو إخماد حركة المقاومة الوطنية التي اندلعت في مصر، ضد القاعدة البريطانية في منطقة القناة، وهي الحركة التي شهدت مشاركة لافتة من قوات البوليس المصري، إلى جانب قطاعات كبيرة من العمال المصريين الذين قرروا في وقت سابق الانسحاب من العمل في القاعدة البريطانية، والانخراط في صفوف المقاومة، التي ضربت مثالاً كبيراً في التضحية، عندما تصدت قوات الشرطة في قسم الإسماعيلية في اليوم السابق للحريق، للقوات البريطانية، ورفضت تسليم القسم لقائد القوة، الأمر الذي أسفر عن مذبحة مروعة، فجرت موجة من الغضب في الشارع المصري، ويشير كثير من المؤرخين إلى أن الحريق تم بواسطة الاستخبارات البريطانية، بتواطؤ مباشر مع الملك، الذي كان قد دعا في نفس اليوم، وعلى غير العادة، قادة الجيش والشرطة على مأدبة غداء احتفالا بعيد ميلاد نجله الأمير أحمد فؤاد، بينما كانت شوارع القاهرة تغرق في لهيب النيران!
أكاذيب إخوانية
دأبت جماعة الإخوان على مدار عقود على ترويج سلسلة من الأكاذيب حول ثورة يوليو، ربما كان من أبرزها أن الجماعة كانت تسيطر على تنظيم الضباط الأحرار، قبل أن تطلق كذبتها الأشهر، بأن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قائد ثورة يوليو، كان إخوانياً، وأنه أدلى بقسم الولاء على المصحف والسيف، قبل أن ينقلب على جماعته ويطيح بها بعد «حادث المنشية».
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، روى في خطاب رسمي في نوفمبر 1965 قصة علاقة الثورة بالإخوان في مصر، مشيراً إلى أنه كان على صلة بكل الحركات السياسية الموجودة قبل الثورة، ويعرف مؤسس الجماعة حسن البنا شخصيا، لكنه لم يكن عضوا في الإخوان، ويقول عبد الناصر: «كنت أعرف ناس في الوفد، وأعرف ناس من الشيوعيين، لأنني كنت أعمل بالسياسة منذ كنت في ثالثة ثانوي، واتحبست مرتين أول ما اشتركت في مصر الفتاة، وده يمكن اللي دخلني في السياسة، وبعدين حصلت خلافات وسبت مصر الفتاة، وانضميت للوفد، لكن الأفكار اللي كانت في راسي بدأت تتطور، وحصل نوع من خيبة الأمل، وبعدين حصل نفس الشيء بالنسبة للوفد، قبل أن التحق بالجيش».
ويروي سامي شرف مدير مكتب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قصة اللقاء الأول الذي جمع بين الزعيم الراحل والمرشد العام للجماعة يوم 29 يوليو1952 بناء على طلب الأخير في منزل صالح أبو رقيق، ويقول: طلب المرشد العام في هذا اللقاء أن تطبق الثورة أحكام القرآن الكريم، وأجابه الرئيس عبد الناصر بأن الثورة قامت حرباً على الظلم والاستبداد السياسي والاجتماعي والاستعمار البريطاني، وهي بذلك ليست إلا تطبيقا لأحكام القرآن الكريم، فطلب المرشد أن يصدر قرار بفرض الحجاب حتى لا تخرج النساء سافرات، وأن تغلق دور السينما والمسارح، فرد الرئيس عبد الناصر: أنت تطلب مني طلباً لا طاقة لي به، فأصر المرشد على طلبه، فقال الرئيس عبد الناصر: «اسمح لي نتكلم بصراحة وبوضوح، إنت لك بنت تدرس في كلية الطب، فهل بتذهب للكلية وهي لابسة حجاب؟! أنا أعرف بأنها بتروح الكلية بدون حجاب، فإذا كنت في بيتكم مش قادر تخللي بنتك تطلع في الشارع بالحجاب، ح تخلليني أنا أطالب الناس كلهم، وأقول لهم حطوا حجاب، وبعدين بنتك بتروح السينما.. إحنا علينا واجب أن نعمل رقابة عليها وعلى المسارح كمان حتى نحمي الأخلاق، ونحن سوف نمنع من يقل عمره عن 21 سنة من ارتياد الملاهي». لم يعجب المرشد هذا الكلام وطالب بمنع الناس كلها، فرد عليه الرئيس عبد الناصر قائلاً: «ولماذا لم تتكلم أيام فاروق؟».
.