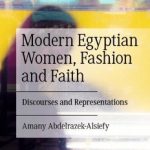إنجيل زهرة

للروائي والإعلامي نبيل الملحم
موسى الزعيم
إنجيل زهرة هي الرواية السابعة للروائي والصحفيّ السوري نبيل الملحم، الصادرة حديثاً عن دار الرّيس في بيروت..
في إنجيل زهرة يبدو يوسف مشغولاً بالبحث عن خلاصه من خلال البوح أو ” الحكي” فهو يقايضُ الكلام بالوقت” إذ يعتبر أنّه في هذه المُقايضة، تحرير لذاتهِ من ثِقل الزّمن الضّاغط على ذاكرته، يجعله أكثر نقاءً، وأكثر تصعيداً، أو يجعل موته سعيداً، وربّما تكفيراً عن الهموم التي أثقلت كاهله بعد أن وصل سنّ الثانية والستين، حسب قوله في متون السرد.
في الرواية يدّق الراوي أبواب المقدّس، يناغشه حيناً، ويسأله أحياناً، يتكئ على هاجس السؤال الخلاّق “أنا رجل السؤال الخلاّق” كيف لا؟! وفِطرة الانسان مجبولةٌ على اقتحام مجاهيل اللامعقول، وإقلاق عتمةِ النقاط السوداء في قضايا ربّما لاحت له منذُ الأزل على أنّها ثوابت، في حين عند محاكمتها، يجد أنّها تنحاز إلى اللاجدوى، يبدو عندها أنّ تبرير العجز في تفسير هذه القضايا أمرّ مسلّم به “فالسّاعة المُعطلّة صحيحةٌ مرتين في اليوم” أو ” كيفَ تضع قفلاً كبيراً لباب دارٍ جدرانها مهدّمة ” مثلاً
يوسف الرّاوي الذي يمسك بزمام السّرد، من أوّل جملة في الرّواية حتّى آخرها، يخاف أن تفلتَ منه ولو تفصيلةٌ صغيرةُ، كلّ ذلك بتحريضٍ من سلمى جليسته، والتي دفعته للتكفيرعن جريمة، يعتقد أنّه ارتكبها بحقّ أجمل شيء، وأحبّ شيء بالنسبة له “زهرة” التي استنفزت كلّ مشاعره، والتي ماتت حسب مروياته، في حين يعتقد أنّه هو من قتلها، ربما لتصبح أنقى ولا تتدنس، يخال أنّه المخلّص لها، وهو الذي تعرّف إلى نساء كثيرات قبلها، تزوّج، وطلّق وهجر مثل ” رشيدة التونسيّة، وأم كلثوم ، وبندر، ومي عبد النبي، وجميلة حرب، ونعيمة وغيرهنّ ” هؤلاء كنّ عابراتٍ لفحولته، ونرجسيته منهن من انتحرن، لكن زهرة كانت محطّ أحمال عواطفه، ومدار فَلكه في الحياة، وفي إنجيلها الذي كتبه بعد موتها.
ثمّة تشابه في مصائرهؤلاء النسوة وبين نساء مصطفى السّعيد المُنتحرات في رواية “موسم الهجرة إلى الشمال” للروائي الطيب صالح، ونساء إنجيل زهرة المُنتحرات أيضاً، الفارق أنّ مصطفى السعيد ينتقم من الغرب بفحولته، بينما يوسف يؤكد على نرجسيته..!وكان كلاهما ينشد الخلاص.
يوسف الذي تنقّل بين أمكنة مُتعددة، فمن دمشق، إلى القاهرة، فبغداد، وبيروت، ودمشق مرّة أخرى، في هذه الأمكنة خَبر التحولات الكبيرة التي حدثت، في مصر والسودان والعراق، ودور التنظيمات السياسية في تلك المرحلة وخاصّة الأخوان المسلمون، وحزب البعث، والثورات، والإخفاقات، التي شهدها على الصعيد العربي، والشخصيّ.
يوسف الذي يدرس النقد، والسينما والمسرح، في سردياته تعامل مع ما يرويه بلعبة الايهام البصريّ زمانياً ومكانياً، مارس على المتلقي تلك الخِبرة التي اكتسبها في عالم الفنّ و التمثيل وهو الذي يعشق أن يُصفّق له .
في حين أن ّسلمى تطلب منه أن يكون خلاصه بالكتابة، أن يخبرها بالوقائع كماهي، فيدور في حلقة مفرغة من الهذيان والعزلة، هذه العزلة يعتبرها نفاذاً لطاقة الأسئلة.
يعود يوسف إلى بيته القديم “ذاكرته”،حيث تحاول سلمى ترتيبها، تجهد في إفراغها بالكامل، لعلّها تغدو أكثرَ نظافة وراحة، بعد أن حَبلتْ بمواجع زهرة، كيف لا وليوسف ذاكرةٌ مُقلقة “ذاكرة رجلٍ غارقٍ في أحلامه وكوابيسه، الكوابيس التي تهرسهُ كما تهرسُ صرصاراً”
“..على المهزوم أن يُميتَ ذاكرته” هكذا يقول لسلمى، لكن التذكّر،أحياناً شجاعة عليه أن يفتح باب ال “هو” لتداعياتهِ ولهذيانهِ لعلّه الخلاص ..
“الهذيان إنّه التّوبيخُ اللامحدود للصّحو،هو راحة من يباسِ العقلِ، كان يخوضني بصرامةِ إزميل يضربُ الصخر، يأتيني بجرعاتٍ تباركني، وتودّعني كلّما دخلت في ملكوت الذاكرة والخيانة، وقد تلاهما القتل، لقد بات الهذيان خلاصي “
إنّها الحرب والوساوس، تفتح باب العزلة، لتلقي بيوسف على سرير بوحهِ، حتّى يخال نفسه في لحظة ما روبوتاً وصل إلى حدّ نفاذِ الطّاقة، بينما دويّ صوت ” التّكسير” يرافقه منذ بداية شبابهِ حيثَ كسرَ الصحون في مطعم فريد الأطرش في بيروت بداية شبابه، ثم في بيت جاره سليم، وعلى يده ويد سلمى، إلى صوت تكسير الجدار في بيته في نهاية الرواية، إنّه دويّ نجح الكاتب في مدّه، من أوّل الرواية إلى آخرها.
ليلُ دمشقَ يشعلُ نارَ الكلام
دمشق الجريحة تظهر في إنجيل زهرة في الصفحة 38 تبدو مُتعبة أنهكتها الحرب، ليل دمشق المُشتعل بالقذائف، الغارق في العتمة والترقّب، ووصول فصائل المعارضة إلى أطرافها، وحالة الخوف التي يتعبّأ بها الشارع الدمشقيّ، ينحاز يوسف زين الدين رافع إلى القاع، هو معني برصد ما آلت إليه أحوال الناس، يغوص في أعماقهم، يلمس بؤرالوجع في ذواتهم، ويصوغ منها هالات الأسئلة المُرّة عن أسباب ذلك، وعن المستقبل الذي يُختزل برصاصةٍ، أو صوت قذيفة، أحياناً ينظر إلى القضايا بروح من اللامبالاة، يرصدُ كيف يُعالج النظام بعض الأمور بروح من السّخرية المرّة، كأن يُعيد النظام مثلا ً” تأهيل برادات الموتى”.
يروي يوسف بعض أوجاع الناس هواجسهم، والأمكنة، فجاره سليم لم يعد بوسعه الحصول على عاهرة من شارع بغداد، الذي بدا متخماً بالنازحين..حارس مقبرة نجها وتآلفه مع الموت، وابن بندر الذي يسكن في نهر عيشة الغارق في تهويماتِ جمجمتهِ المُغلقة، وابراهيم الشاعربائع الدّجاج، الباحث عن فرصةٍ للاعترافِ بموهبتهِ الشعريّة الحزبيّة، وبأيّ ثمن كان..
يوسف الذي لم يكن مع أي طرف من المُقتتلين، ولا يتقنُ دورالقاتل، وهو على يقين أنّ ” ما من دافعٍ للحرب سوى انتهاكِ الجسد” “فالذئب يقتلُ من أجل الطّعام، بينما الانسان يقتلُ من أجلِ ألفِ سببٍ وسبب”!. فهو لا يتقن القتل سوى على المسرح.
ينحاز يوسف لرصد الحالة النفسية للعمال الذين يفترشون ساحة برج الرّوس، يصف حركاتهم، وبدائية تعبيرهم عن الاحتجاج ، في حين أنّ النازحين يخافون من مجّرد الإجابة عن أسئلةٍ تقذفُ بها – ببراءة – شفاه الغريب، أسئلة رغم عفويتها مؤلمة، تجعل المرء يخلّى عن رصيفٍ يأوي إليه ” كما حدث معه حين سأل أباً لأسرةٍ نازحةٍ تفترشُ الرصيف ” هل أنت قاتل ؟! كان ذلك كافياً لأن تحمل الأسرة أمتعتها، تدقّ باب المجهول، ولا يفلحُ في استضافتهم ” بيتي بثمانِ غرف وثلاث شرفات” تعالوا… لكن ما انكسر في ذات الفرد السوريّ لا يمكن ترميمه، في حين أن طبقةً مُترفةً لازالت ترتاد المَطاعم الفخمة، وتسهرعلى أغاني مطربٍ ريفيّ هابطٍ، يتغنّى بانتصارات قائد الوطن، بينما جوعى الجيش، وخوف المسيحين من التهجير في حيّ التجارة الدمشقي، وقلق سماء دمشق الذي أضحت بلا نجمةً واحدةٍ.
وكذلك لم يعد مكانهُ المألوف “بيانو بار” كما كان بل أصبح غارقاً في الخوف والوحشة، فالبلاد انقسمت إلى خنادقَ صراع، وحلّ النحاس محلّ القلوب، والجثث ملأت العاصي، وغرغرات الموت للمعذبين إغراقاً في المُعتقلات، تنتابُ يوسف كلما لامسَ الماءُ رأسَه، بينما القناص يُسدد على الدوام، يريد أن يفجّر أي جمجمةٍ، يحلو له أن يفجّرها، ليرتفع منسوب، الدم على أرصفة المقتتلين …”
دمشق التي عبثت بها فئة من العَوالق، تبحث في حواريها عن ضحايا تنفث فيها سمومها، و”بلسم” أو “مفطومة” كما يحلو له أن ينعتها، تمثل ذلك النموذج، فهي تستدرجُ الشباب وتسقطهم في مستنقع رذيلتها، من خلال الجنس، والتّجنيد المخابراتي، بين دمشق وبيروت، وهي أي “مفطومة” تلبس رداء المثقفين، فقد أصدرت كتاباً يُعني بتحريرالمرأة، بينما تمارس دعارتها، ومثليتها على مرأى ومسمع من “حيدر” زوجها، والذي يدّعي أنّه إعلامي، باحث في الحركات الراديكالية، والمُدمن على سرقة أفكار “حنيف” المأجور، الذي يُغرقُ أيضاً في مُستنقع مفطومة القادمة من “السّاحل” وهي أيضاً من أوصل زهرة إلى الحالة التي آلت إليها، مما جعل يوسف يُخطط لقتل زهرة، لذلك ينعت مفطومة” بالخنزيرة ” على مساحة لابأس بها من صفحات الرواية، مما يكشف حجم الألم، الذي سبّبته له تلك المرأة له.
سلمى المرأة الإسفنجة
سلمى التي رافقت يوسف منذ بدايات الكلام في إنجيل زهرة، حتى آخر رسالة أرسلتها له بعد سفرها، لا تتوانى بين اللحظة والأخرى عن إشعال ثيمة البوح في يوسف، داعية إياه إلى تخليص نفسه من أوجاعه وآلامه عبر الحكي، تهديه كتاباً ذا غلاف مُذهّب مكتوب عليه “الإنجيل المقدس” لكن صفحاته بيضاء فارغة، تحضّه على كتابة أحداثه مع “زهرة” تدعوه أن يفتح مغاليق الذاكرة، ويصبّ فيضان روحه على متون الورق.
سلمى لم تُمارس دور المستمع فقط! لكنها مارست دور يشبهُ دور شهريار، حين كانت تصغي إلى هذيانات يوسف، وقلما كنّا نسمع صوتها، كانت مشغولة بترتيب حياته، بترتيب بيته الخارجي ” وتنظيفه على المستويين، الداخلي الروحي والخارجي، تنفض غبار ذاكرته وتكنس العناكب عنها، ليتضّح فيما بعد أنّها تعمل في حقل الجيولوجيا، وترسم البورتريهات، مما يمنحها الخِبرة في التنقيب، والبحث عن مكنون الأشياء، وإخراجها، وإعادة تشكيلها بطريقة أقرب إلى الحِرفية وهذا ما فعلته بيوسف.
سلمى كما يسميها المرأة الإسفنجة ” قالت لي: “إنني اسفنجتك، أنا المرأة التي تمتصّ وجَعَك” كانت سلمى تمتص خطاياه، وتسعى إلى تخليصه، فهي مفطورة على الإصغاء ” كنت أحكي وهي تصغي، يالموهبة الإصغاء المولودة في سلمى، فمع كلّ رواية أحكيها عنّي، كانت توحي لي وكأنها تلامس شيئاً منّي “
وقد سبقتها إلى ذلك جميلة حرب التي كانت تسمي نفسها الممحاة، كلّ ذلك يمنح يوسف الثقة والراحة والسلام الداخلي، في أن امرأة ما تمدّ يدها إلى ما بين ضلوعه، تحاول ترتيب روحه التائهة في مدارات الأمكنة والأزمنة، هي تحاول تجميعه، ولكنّه “رجلٌ لايمكن تجميعهُ إلاّ في زهرة..”
“كان علينا أن نحثّ خطانا هرباً من بشرأعطوا أنفسهم صلاحيات، تعلوعلى صلاحيات الله في إماتة الناس أو إحيائهم ” وكان الهروب في إنجيل زهرة إلى تخليص الذاكرة من وطأة زمن ثلاثي الأبعاد على حدّ قوله.
يوسف الذي أراد أن يصفّي حساباته مع الماضي، مع الأشخاص الذين لوّثوا ذاكرته، وسبّبوا له الألم في الماضي، والحاضر، يحاول أن يتعافى مما آلت إليه حالته، وكان الهذيان والتذكر والحكي والغوص في ذاته، وسائلهِ للشفاء، وهذا ما أوصله إلى هدم الجدار القابع في منزله في نهاية الرواية، الجدار الذي تعلّقت عليه صور الماضي، وحشراته وعناكبه، وعقاربه، وبذلك فتح ممرا ًللنور، وأدّى مُهمته على أكمل وجه، وكتبَ إنجيل زهرة كما وعد سلمى .
في انجيل زهرة تشعر أن اللغة تنبع من بين أصابعك، دفّاقة خالية من التشذيب والمعجمية، فيها تمرّدَ الكاتب على الخطوط الحمراء، وعلى سلطة الرقيب، واجتاز عتبة الممنوع، كانت اللغة أقرب لما يختزنه الانسان مفردات بدائية، تخرج في عفويتها، دفاّقة دون تكلّف أو تزويق، لم تكن سوى روائز تُشعركَ بأنّ ما يقوله الراوي هوعين الحقيقة، هذا السرد الغزير الفيّاض الخالي من هندسة الكلام، والانتقائية، جاء بحرفيّة الفنان الروائي المبدع، الذي استفاد من خِبرته الطويلة في عالم الإعلام والصحافة، ومن هنا تمارس الرواية على القارئ الفعل الايهامي، بين أن تكونَ سيرةً ذاتيّةً شخصيّة، سيرةُ اخفاقات وانكسارات ” الراوي ” أم أنّها فِعلٌ روائي، يأخذ بنا إلى عالم الخيال، إلى شاهقٍ، ثم يغوص بنا في أعماق المجهول، تخال أنّك تعرف مَن يتحرّك في الرواية، بشرٌ من لحمٍ ودم، لكنك في النهاية تجد أنّ ما قاله الراوي فِعل فنّي جماليّ يحدث في شروط وظروف فيزيقية معينة، كما في إنجيل زهرة.
يتركنا الروائي بينما ضجيج أسئلة كُبرى لم يُملأ فراغها…هل قتلَ يوسف زهرة ؟
هل كانت سلمى بطرس الخولي أمّها ؟ هل تمثّل زهرة (بكلّ تجلياتها، وتقلباتها الدراميّة) سوريا؟
بالتّأكيد ليس مهمة الروائي الإجابة عن الأسئلة، ولاحلّ أحجيات فِعله الإبداعي، بقدرما هو معنيّ بإثارتها وقد نجح في ذلك إنّه “اللعب العاري” على حدّ قوله، على مدى ثلاثمئة وست وستين صفحة “.
يُذكر أنه صدر للروائي نبيل الملحم قبل ذلك روايات ” خمّارة جبرا” “بانسيون مريم” و”سرير بقلاوة الحزين” و “موت رحيم” و”حانوت قمر”.
.